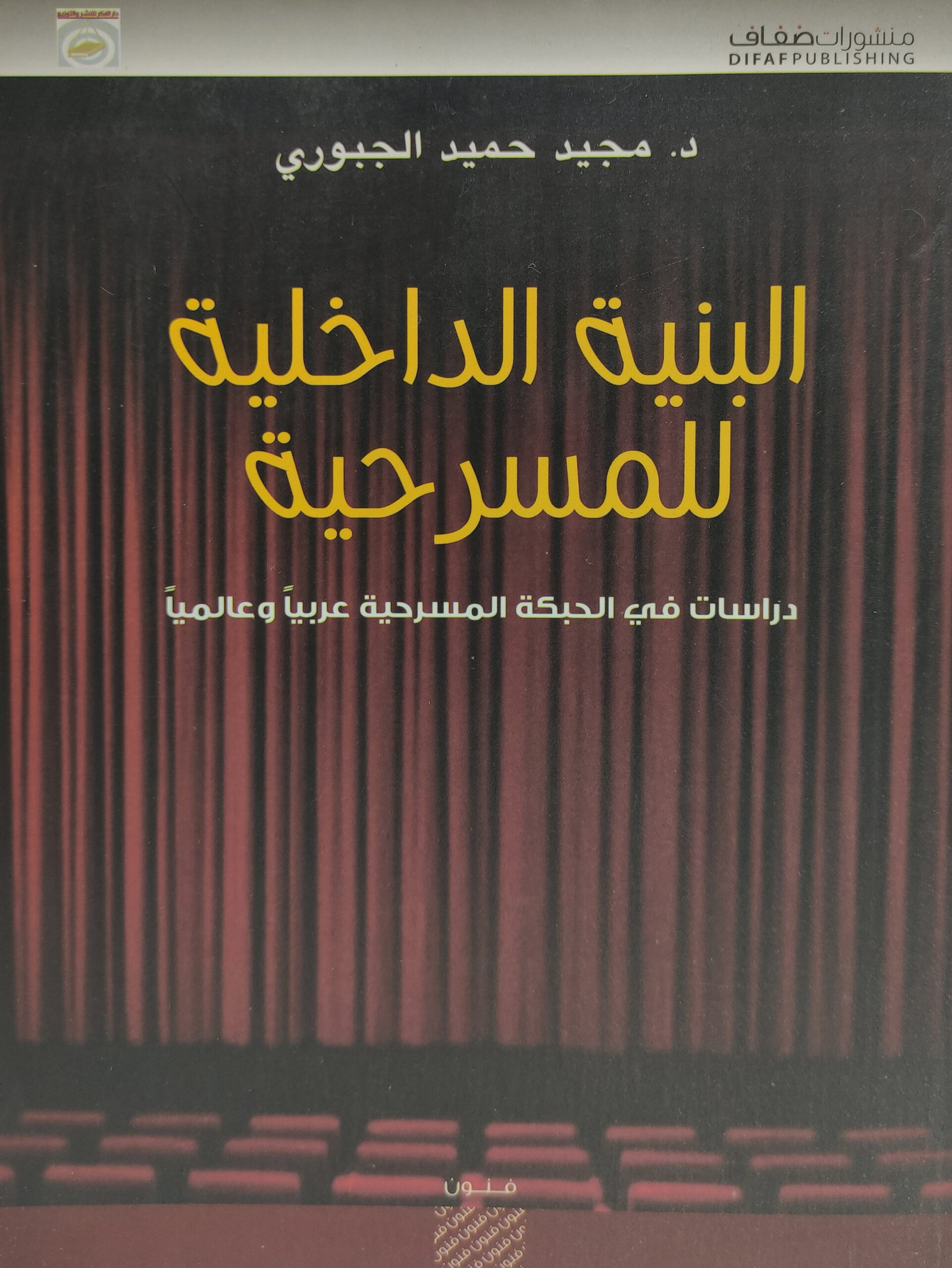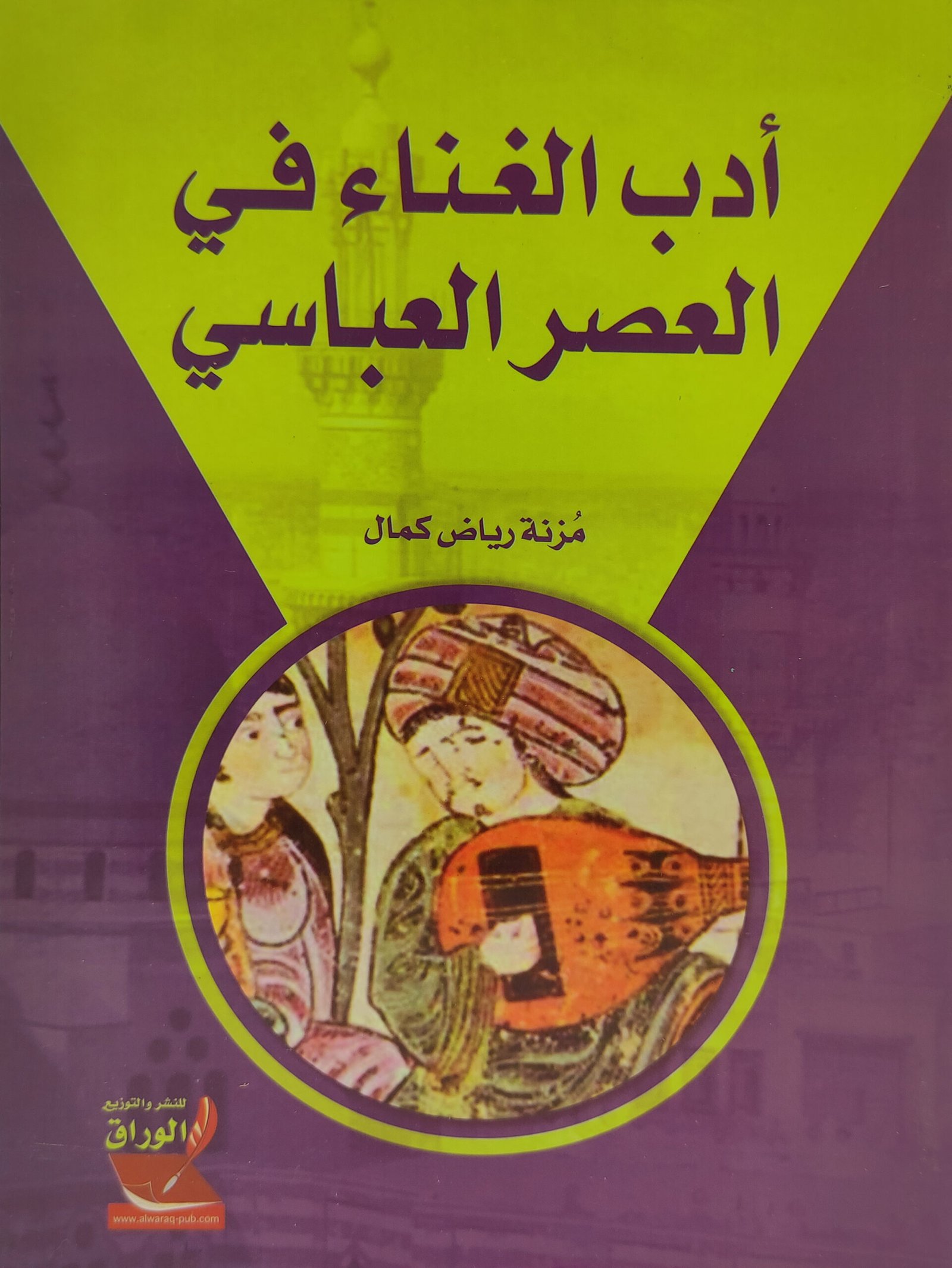
أدب الغناء في العصر العباسي
عدد الصفحات : 218 صفحة
يسعى الإنسان منذ خُلق لتحقيق استمراره في الحياة بالبحث عن مقومات وجوده. وفي غمرة سعيه نحو الأمثل، شاقته صور الجمال في الوجود، وأعجبه ما رأى وما سمع من أشكال الكون وألوانه وأصواته، فكان الجمال محرضاً معرفياً دفع الإنسان إلى البحث عنه، والسعي إلى معرفته، ومن ثم التعبير عن مواقفه منه في سُبُلٍ شتى تطورت عنها أنواع الفنون، فكان الفن انعكاساً للشعور الإنساني بالجمال، وتعبيراً عن رغبته في أن يحيط نفسه به في حال غيابه، ووسيلة من وسائل التواصل بينه وبين أبناء جنسه. وتفاوتت مراتب الفن بحسب ترقي الإنسان من المادي المحسوس إلى المجرَّد المُدرَك، وكانت الموسيقى أرقى الفنون، وأعلاها شأناً، لتجردها التام عن التشكل والتحيّز، فهي تمثل سعي الإنسان إلى عالم المطلق الذي يشتاقه ويحن إليه، لأنه عالم روحه الخالدة التي لا تحدها حدود، ولا تقيد حريتها قيود.
ولما اشتركت الموسيقى بالنص المغنَّى أصبح الغناء أكثر الفنون قدرة على الانتشار، وأشدها أثراً في المتلقّي.
إن الإنسان هو نفسه في كل زمان ومكان، والحاجات الروحية التي ولدت معه، والتي هي المحرك الأول للإبداع الفني عامة والغنائيّ خاصة، ستظل قائمةً في نفسه تبحث عما يروي ظمأها. واليوم، أضحت هذه الحاجات أكثر إلحاحاً من ذي قبل، بسبب طغيان المظاهر المادية على الوجود الإنساني، وتغييبها للبعد الميتافيزيقي فيه، والناظر إلى واقع الموسيقى والغناء عند العرب اليوم لن يحتاج إلى جهد كبير ليرى أن الذوق الجمالي وبخاصة في فن الغناء قد أصابه الكثير من التشويه في هذا المجال. وقد نجانب الصواب إن ألقينا باللائمة في ذلك على المتلقي وحدِه وفسادِ ذوقِه، وإنما أصل المسألة أعمق من ذلك بكثير، إنها تعود إلى جوهر وجود الإنسان، وإلى مجمل العوامل التي تساعد على توفير الجو الملائم له سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً ودينياً. فالعالم العربي يتعرض إلى غزو ثقافي ساهم بشكل أساسي في غياب الإبداع في ميادين الحياة المختلفة عامة، والفنية منها خاصة. ومن أجل تصحيح مسار الثقافة العربية اليوم، لا بد للمثقفين من استلهام التراث لتصحيح الواقع، بجعله مقياساً ومعياراً نقيس عليه واقعَ النص الغنائي إبداعاً وتلقياً، ومن هنا كانت فكرة هذه الدراسة التي تأمل أن تساهم في صياغة فلسفة جمالية للغناء والموسيقى، وتأصيل ذلك بالاعتماد على التراث الحضاري للعرب المسلمين.

أسلوب التركيب في شعر الشريف المرتضى
عدد الصفحات : 220 صفحة
أتي الشريف الرضي، وأخوه الشريف المرتضي الشاعران النقيبان البارزان في القرن الرابع الهجري بما يمثلان من قامة أدبية وفكرية، ورياسة مذهبية علوية جمعت حولهما قلوب المريدين، ومن رسم هذه المواقع الروحية الأصلية كانت لوحات القصائد الشعرية الصافية التي أثارت في المتلقين عبر العصور تساؤلات وانطباعات عديدة، دفعت الدكتور سمير عوض الله رفاعي إلى الكشف عما تتميز به لغة الشعر عند الشريف المرتضي، فاتجه إلى الدرس الأسلوبي المعاصر مستعينًا به على تحليل هذه اللغة، متوقفًا عند إحدى رقائقه أعني مبحث التراكيب ليوضح أمارات التفرد والتميز على مستوى الجملة، وما يطرأ عليها من حذف أو توكيد أو تقديم أو تأخير أو على مستوى الروابط والأساليب.
والدراسة التي بين أيدينا دراسة علمية جادة اتخذت من المنهج العلمي المعاصر سبيلًا للوصول إلى غاياتها المحددة خلال ما طرحته من أسئلة، وما توصلت إليه من إجابات.

أنطولوجيا الأدب السعودي الجديد معطى حداثي عالي الصوت في فضاء منسي
عدد الصفحات : 640 صفحة
فوجئت في بداية الإعداد لهذه النصوص والشهادات والحوارات، بصعوبة المهمة وشبه استحالتها، خصوصاً وأنني أحاول النجاح في مسعاي خدمة لقضية أؤمن بها وأرى أن وقتها قد حان، على أرض مترامية الأطراف لا أزعم أنني ألم بكامل جغرافيتها الإبداعية تماماً، ولعل في ذلك عذراً لي في حال تقصيري من حيث لا أدري. وقد واجهتني أولى المصاعب في مسالة اختيار جيل بعينه لأبدا منه مسيرتي في تجميع المواد. وقد استقر رأيي على جمع أكبر قدر من النصوص لأسماء متعددة (نسائية) و(رجالية) عرفت بجديتها الكتابية وتميزها الفني، ومن أجيال مختلفة. ذلك أن جميع الأجيال متواجدة وممثلة بأبرز أسمائها، بداية من خمسينيات القرن الماضي وحتى آخر ما أنتجه جيل التسعينيات، الذي يبدو واثقاً من قدراته على مواصلة المشوار. كذلك قمت بتجميع شهادات للمبدعين أو لبعضهم من أجيال مختلفة حتى تبدو الصورة واضحة أمام القارئ عن آمال المبدع السعودي وطموحاته، وكشف فضاءاتهم الإبداعية أو الاقتراب منها كيف بدأوا وغلى أين انتهوا وما يريدون من كتابة إذا جازت التسمية.
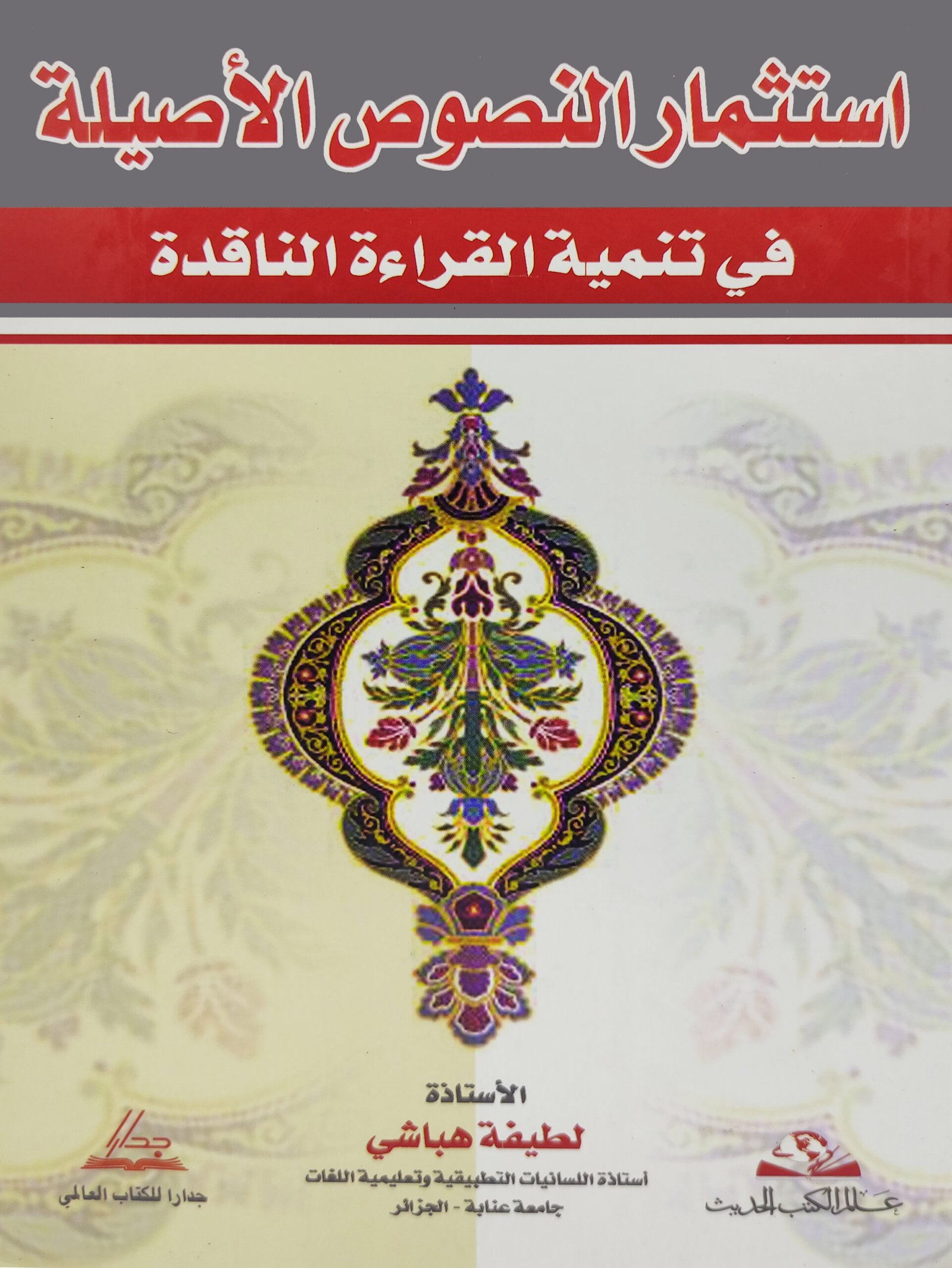
إستثمار النصوص الأصلية في تنمية القراءة الناقدة
عدد الصفحات : 210 صفحة
يتناول هذا الكتاب موضوعاً من الموضوعات الجديدة في مجال اللسانيات التطبيقية وتعليمية اللغات والخاصة في اللغة العربية ومناهج تعليمها التي لم تعرف إنجازاً من هذا النوع إلا نادراً.
وقد وسمته صاحبه بــ: “إستثمار النصوص الأصيلة في تنمية مهارة القراءة الناقدة”، وهو كما يبدو عنوان طريف معبر دال على محتواه بدقة، محدد لهدفه بوعي منهجي عميق، يظهر من خلاله مدى الرؤيا وبعد الإستبصار لعاملين مترابطين منسجمين بعضهما ببعض هما: عالم النص وعالم القراءة.
النص بإعتباره الحامل الناقل لمفاتيح الوعي في الإنسان والأمة، وبإعتباره أيضاً وحدة تعليمية تجمع بين معارف عديدة لغوية وتربوية ونفسية وإجتماعية لتعشش في رحم النص والأنسجة اللغوية أصواتاً وكلمات وتراكيب، وتفرخ فيصير بذلك النص وحدة معرفية تتفاعل فيها معارف لسانية وغير لسانية، مما يجعله يتجاوز كونه مجرد ظاهرة لسانية إلى مرونة إجتماعية ثقافية أوسع نطاقاً، إنه وسيلة لنقل المعرفة والثقافة له ديمومة عبر الزمان والمكان.
وبالنظر إلى كوننا نواجه ثورة معرفية إجتماعية وسياسية وعملقة تكنولوجية صارت تعم العالم في وقتنا هذا، فإن دور الإتصال العالمي قد تعاظم هو أيضاً، وأصبح كل مجتمع يعيد النظر في حاجياته وأنماط حياته الإقتصادية والسياسية والتنموية في مجالاتها المتعددة، وكل ذلك مرتبط بالقدر الذي يلقونه من المعرفة ونوعها وكيفية إستثمارها في مجالاتها وميادينها المحددة من أجل تأمين مستقبلهم، فلكي تعرف لا بد أن تبلغ الآخر وتتلقى عنه فيحدث التواصل بينكما.
ربما لهدا وسعت الكاتبة من نطاق النص فلم تكتف بدراسة النص الأدبي وحدة، وإنما تجاوزت ذلك لتناول النصوص الأصيلة التي حدثت أو أنتجت في لحظتها لتؤدي وظيفة التعبير عن مقتضى حال من أحوال الحياة المختلفة، فتحدثت عن أنواع عديدة من النصوص، من المقال الصحفي إلى الإعلان الإشهاري إلى الطلب الوظيفي إلى الوصف العلمي…

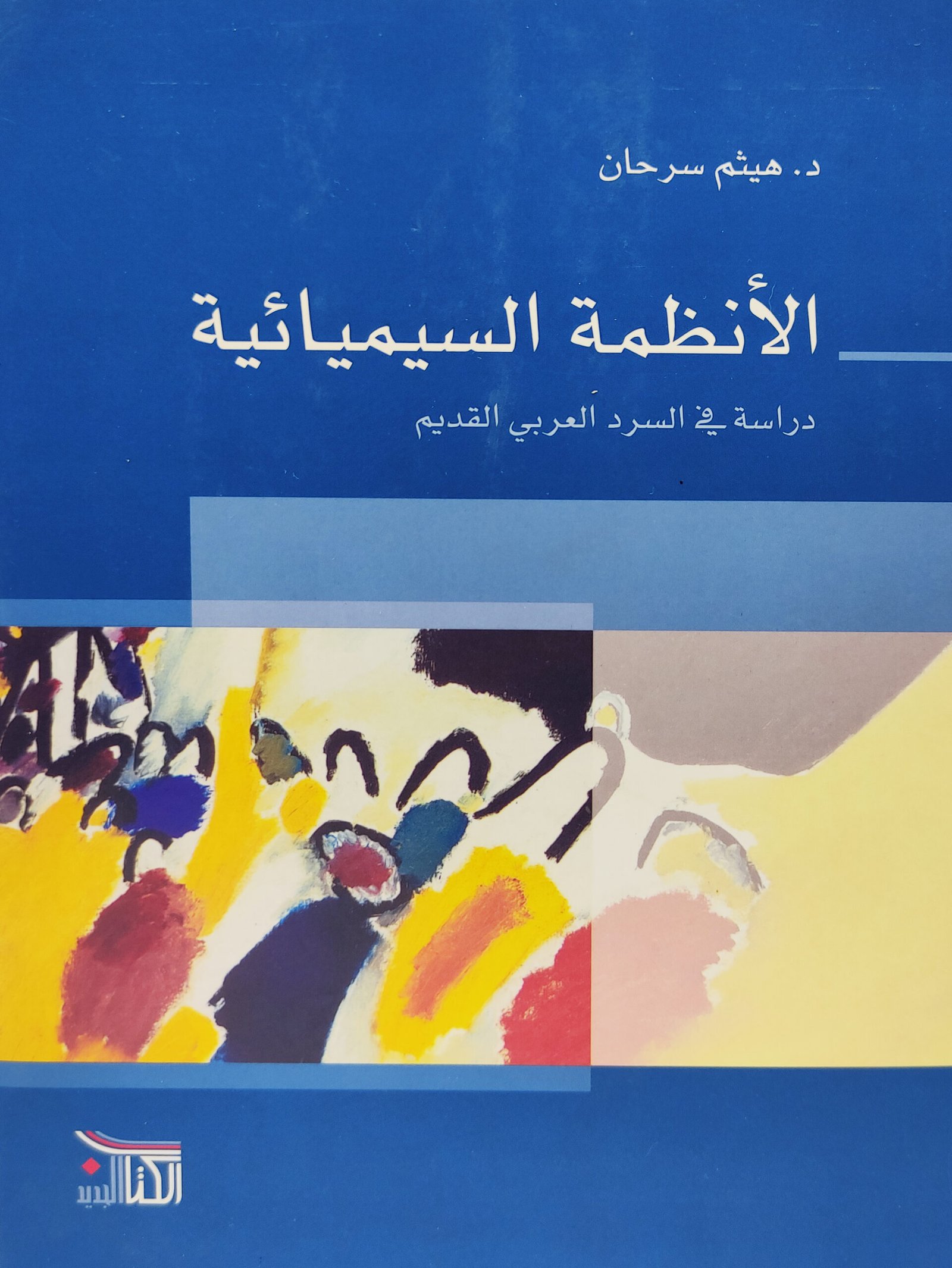

البنى الثابتة والمتغيرة لشعر الغزل في صدر الإسلام والعصر الأموي
عدد الصفحات : 400 صفحة
لقد خضع موضوع الغزل لدراسات عدة، غير أن ما يلاحظ على هذه الدراسات أنها عنيت بالجانب التاريخي أو بنمط محدد من النصوص الشعرية، على حين كانت دراسة ما يتصل بقصيدة الغزل من جهة الباعث والمرجعيات، والبنية قاصرة أو معلّقة بجانب ضيق من جوانبها الفسيحة.
لذلك قام المؤلف بالبحث عن هذا الموضوع وجمع مادته وقسّمها إلى المقدمة والتمهيد وثلاثة أبواب واتبع ذلك بخاتمة، ففي التمهيد تحدث بشيء من الإيجاز عن المقدمة الغزلية والوحدة الموضوعية ومدى توافرها في قصيدة الغزل الجاهلية، والوزن والقافية.
ففي الباب الأول: خصص لدراسة بواعث الغزل، وكان على فصلين؛ فالفصل الأول: عنوانه “بواعث الغزل الموضوعية بين الثبات والتغير”، وفيه تعرفنا على أهم البواعث التي أدت إلى نشوء الغزل في العصرين الإسلامي والأموي، والفصل الثاني: جعل عنوانه “البواعث الفنية في الثبات والتغير”.
وجاء الباب الثاني ليدرس قصيدة الغزل وما أصابها من ثبات وتغير، ويضم هذا الباب أربعة فصول: كان الفصل الأول يتحدث عن “البنية الثابتة والمتغيرة للمقدمة الغزلية”، والفصل الثاني عنوانه “بنية قصيدة الغزل الحسي بين جذورها الجاهلية وروح العصر”، الفصل الثالث: “وكان تحت عنوان “الغزل العذري بين ثبات الجذور والبنى المتغيرة”، الفصل الرابع: وعنوانه “الغزل الكيدي بين ثبات البنية وتغير الموضوع”.
أما الباب الثالث: خصصه للدراسة الفنية، وقد اشتمل على أربعة فصول، كان الفصل الأول يتحدث عن “مرجعية قصيدة الغزل”، أما الفصل الثاني، فقد درس فيه لغة الشعراء الغزلين، وفي الفصل الثالث: تناول الصورة الشعرية، أما الفصل الرابع: فقد أنصبّ على دراسة الإيقاع بنوعيه الخارجي والداخلي؛ وأخيراً كانت الخاتمة وقد أشير فيها إلى أهم النتائج التي توصل إليها البحث.
خضع موضوع الغزل لدراسات عدة,غير إن مايلاحظ على هذه الدراسات أنها عنيت بالجانب التاريخي أو بنمط محدد من النصوص الشعرية.على حين كانت دراسة مايتصل بقصيدة الغزل من جهة الباعث والمرجعيات، والبنية قاصرة أو معلقة بجانب ضيق من جوانبها الفسيحة، ومن ثم لقي موضوع البحث هوىً في نفسي رسخه ما قرأت، بعده في هذا الموضوع.وبعد إن انتهيت من جمع مادته وجدتها تملي علي أن اقسمها على هذه المقدمة واللتمهيد وثلاثة أبواب واتبعت ذلك بخاتمة.