
الوجيز في مبادئ القانون الدولي العام
عدد الصفحات : 414 صفحة
الحمد لله حمدا كثيرا، والصلاة والسلام على النبي المنزل عليه بالحق قول الحق تبارك وتعالى:(اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الأنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الأنسان ما لم يعلم). اما بعد: فقد اتيح لي ان اشارك في تدريس القانون الدولي العام في كلية الحقوق بجامعة وهران/الجزائر خلال الاعوام الدراسية 1977-1980، ولعد ذلك توجهت الى دولة قطر، حيث عملت خبيرا قانونيا بوزارة خارجيتها حتى نهاية عام 1990، فأضفت الى خبرتي الأكاديمية خبرة تطبيقية عملية تلائم طبيعة القانون الدولي وتواجه مقتضياته ومتطلباته. واذ اضع هذا الكتاب الوجيز في مبادئ القانون الدولي العام بين ايدي طلابي في جامعة فيلادفيا بوجه خاص، وطلاب الجامعات الاردنية والعربية بوجه عام، فإني ارجو ان يكون عونا لهم على التوسع في الدراسة، والتعمق في مختلف مواضيعه، فهذا دليل بحث ليس غير، ولا يجوز بأي حال ان يقتصر جهدهم على دراسته وحده، فالمصادر المكتوبة باللغات الفرنسية والانجليزية والعربية جد غنية. وقد كان هدفي وانا اقدم الوجيز ان ابرز كيف اخذت المدرسة العربية للقانون الدولي تثبت وجودها في هذا الجانب من الدراسة الى جانب الموضوعات الاخرى للقانون الدولي العام وفروعه التي لها فيها باع طويل. اسأل الله ان يوفقنا في النفع بأعمال من سبقونا ويرشدنا الى نقل الرسالة لمن تبعونا وفوق كل ذي علم عليم.

الوسائل المشروعة والممنوعة للمطالبة بالحقوق والحريات دراسة تطبيقية على الواقع المعاصر
عدد الصفحات : 568 صفحة


براءات الإختراع في الصناعات الدوائية التنظيم القانوني للتراخيص الإتفاقية في ضوء منظمة التجارة العالمية
عدد الصفحات : 368 صفحة

تفسير المعاهدات الدولية دراسة في قانون المعاهدات الدولية
عدد الصفحات : 400 صفحة
1. التفسير والتأويل: التفسير لغة يعني: “الشرح والبيان. وتفسير القرآن: من العلوم الإسلامية، يُقصد منه توضيح معاني القرآن الكريم وما انطوت عليه آياتُه من عقائدَ وأسرارٍ وحِكَم، وأحكام.” وعند ابن منظور: الفَسْرُ يعني: البيان و”فَسَر الشيءَ يفسِرهُ، بالكَسر، ويَفْسُرُه، بالضم، فَسْراً وفَسَّرَهُ: أبانه..؛ الفَسْرُ: كشف المُغَطّى، والتَّفْسير كَشف المُراد عن اللفظ المُشْكل.. واسْتَفْسَرْتُه كذا أََي سأَلته أَن يُفَسِّره لي.”. وعن “ثعلب: التَّفسيرُ والتأويل واحد”. “والتفسير: جمعه تفاسير ويعني التأويل، 2. التفسير في الفقه القانوني: في الفقه القانوني الخاص (المدني): فإن “تطبيق” القاعدة القانونية على الواقع يحتاج إلى “تفسير” مضمونها أي “الوقوف على معنى ما تتضمنه من حكم والبحث عن الحكم الواجب إعطاؤه لما قد يعرض في العمل من فروض لم تواجهها القاعدة القانونية”. والتفسير هو”الاستدلال على الحكم القانوني وعلى الحالة النموذجية التي وضع لها هذا الحكم من واقع الألفاظ التي عبّر بها المشرع عن ذلك”. أو هو”التعرف من ألفاظ النص أو فحواه على حقيقة الحكم الذي تتضمنه القاعدة القانونية بحيث تتضح منه حدود الحالة الواقعية التي وضعت القاعدة من أجلها”. وفي فقه القانون العام (الدولي): فإن القيام بتفسير نصوص المعاهدات الدولية هو”عملية منطقية يوجبها ويتحكم فيها الإدراك القانوني السليم بقصد التعرف على النية المشتركة للأطراف المتعاقدين وقت الاتفاق”. وقد يتم الخلط بين”المقصود” من عملية التفسير وبين”الهدف” منها، حيث تهدف العملية المذكورة إلى”الوقوف على المعنى الحقيقي للنص وإنزال حكمه على واقعة معينة..وفيه يتم النزول من ظاهر النصوص إلى مكنوناتها، بغية التعرف على مراميها أو فحواها الحقيقي.”. وبعد الاستفادة مما قيل في معنى التفسير وبعده في معنى التأويل يمكن القول بأن التفسير: هو عملية نقل النص أو اللفظ من حالة الغموض في معناه إلى حالة الوضوح، أو من حالة الشك في مدلوله إلى حالة اليقين. ولا فرق في أن يرد النص أو اللفظ محل التفسير في قانون وطني أو معاهدة دولية. 3. قانون المعاهدات الدولية: المعاهدة الدولية؛ هي “اتفاق مكتوب يعقد بين دولتين أو أكثر ويخضع للقانون الدولي، سواء تم في وثيقة واحدة أم أكثر وأياً كانت التسمية التي تطلق عليه” وهي الوسيلة الأوسع انتشاراً اليوم والأكثر تحضراً في تنظيم العلاقات الدولية؛ حيث تشعبت هذه العلاقات وتعددت أشكالها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية. وإذا ما أخذنا بنظر الاعتبار تزايد الطبيعة (الفنية) لجوانب كثيرة من هذه العلاقات وما قد يحتاج تنظيمها من أدوات فنية أيضاً كالرسوم الهندسية والخرائط الجغرافية أو من حسابات رياضية كما في تعيين الحدود البرية وفي رسم الحدود البحرية والنهرية أو تعيين الخطوط الملاحية الجوية وغير ذلك، فإن كلاً من مصادر القانون الدولي العام أخذ يتنازل عن بعض أهميته ومكانته بين المصادر الأخرى لصالح المعاهدات الدولية؛ والجماعية منها خصوصاً؛ باعتبار أن النصوص المدوّنة من القانون الدولي وليس المفاهيم العائمة على صعيد العرف الدولي مثلاً؛ هي الأقدر على التحرك وفرض معانيها الواضحة والفنية ربما على الواقع الذي يُراد تنظيمه. إن من المراحل المهمة في طريق التقدم بعملية تدوين القانون الدولي للمعاهدات ما أنتجه مؤتمر هارفرد (1929) والسنوات اللاحقة من مشاريع لاتفاقيات دولية. ففي (1935) كانت الخطوة المهمة في هذا المجال هي وضع مشروع اتفاقية هارفرد حول قانون المعاهدات، الذي كان يفوق في أهميته عمل عصبة الأمم وعمل اتحاد الدول الأمريكية وكذلك معهد القانون الدولي في مجال قانون المعاهدات. إذ إنه بالرغم من وجود لجنة من الخبراء لتدوين القانون الدولي في عصبة الأمم إلاّ أن اهتمام هذه اللجنة حول تدوين إجراءات “إعداد” المعاهدات كان يفوق اهتمامها بإجراءات تنفيذها أو تطبيقها وبالتالي “تفسيرها”. مثلما كان نجاح الدول الأمريكية في وضع اتفاقية هافانا لقانون المعاهدات محدوداً بسبب أن عدد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية كان قليلاً ومعالجتها لموضوع التفسير كانت مقصورة على المادة الثالثة منها فقط وفي حدود اقتضاء “الكتابة” في التفسير الرسمي للمعاهدة، كما هي شرط لإبرامها بموجب المادة الثانية من الاتفاقية. بينما يُشير مشروع هارفرد إلى بعض القواعد التي يجب اعتمادها عند تفسير النصوص الغامضة في المعاهدات الدولية( ). وعلى الرغم من أهمية هذا العمل التشريعي الخاص بمشروع اتفاقية هارفرد لقانون المعاهدات وما صاحبه من ملاحظات أو تعليقات وإشارات إلى العمل الدولي السابق إلاّ أن قيمته فيما يخص موضوع “تفسير المعاهدات” في الوقت الحاضر لا تتجاوز الفائدة البحثية التأصيلية لهذا الموضوع. إن العمل على وضع قانونٍ للمعاهدات بما يتضمنه من قواعد إجرائية تتصل بتوحيد آليات إبرام المعاهدة، أو قواعد موضوعية تعيّن وسائل قبولها وتفسير النصوص الغامضة فيها قد انتهى بإقرار اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات بين الدول (1969). وبالمقابل، فمع كثرة المعاهدات الدولية؛ ووجود القانون الذي يحكم جوانب متعددة منها، فإن سؤالاً كبيراً يبقى قائماً؛ وهو إلى أي مدى وتحت أية شروط يجب تطبيق تلك المعاهدات؟ إن الإجابة عن هذا السؤال لابد أن تتضمن توضيحاً لكيفية تفسير النصوص المطلوب تطبيقها، سواءً من حيث الآليات المطلوبة لعملية التفسير أم من حيث القواعد المُطبقة في ذلك.
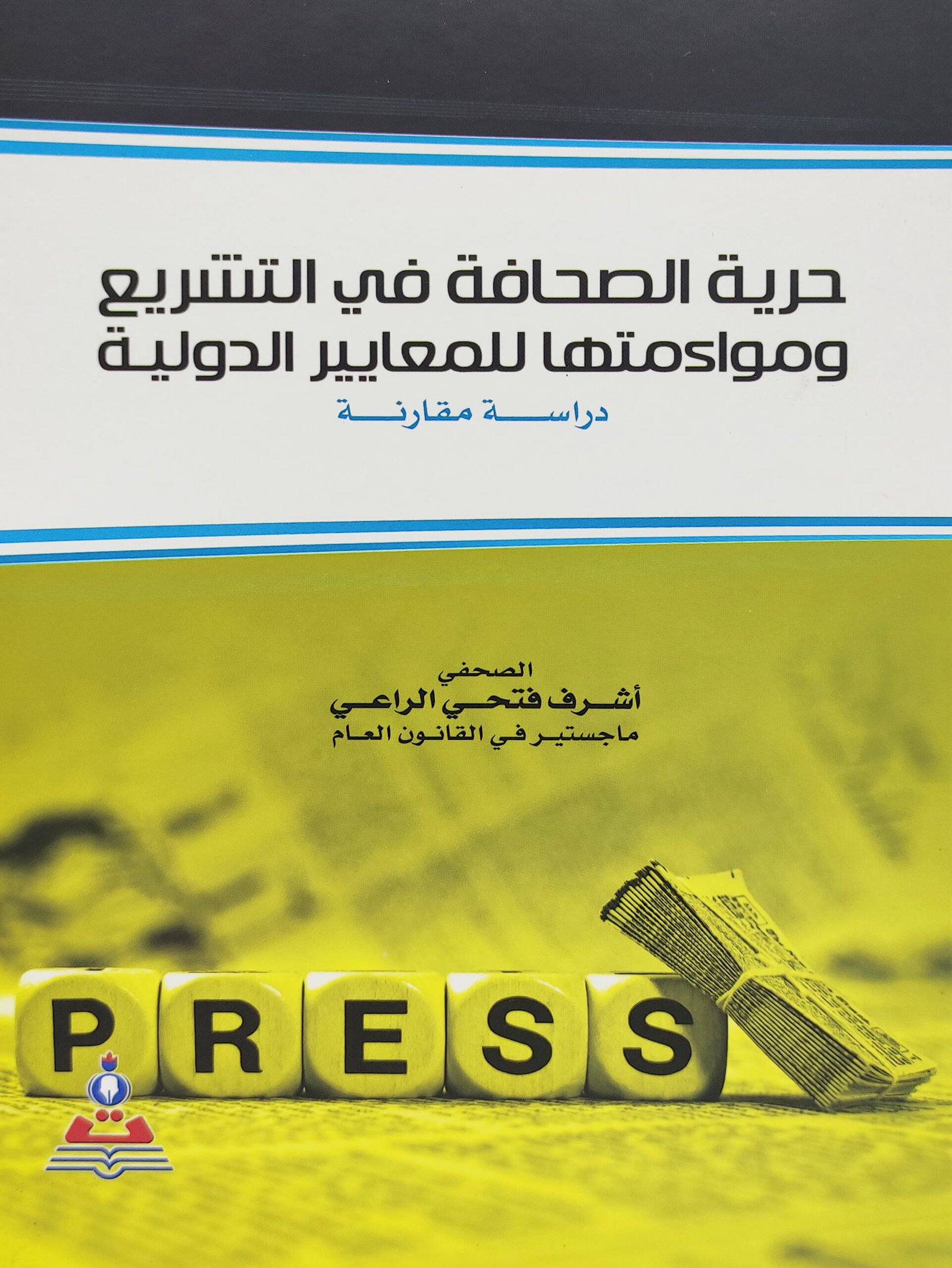
حرية الصحافة في التشريع ومواءمتها للمعايير الدولية
عدد الصفحات : 144 صفحة
تصدر هذه الدراسة، ضمن سلسلة دراسات آليت على نفسي وبجهد فردي إصدارها، علها تجد من يستمع لها أو يلتفت إليها، في ظل أصوات صحافية علت وعلت كثيراً لبيان القيود التي تكتنف هذه المهنة دون أن تنظر إليها الحكومات العربية بعين الرضى. بعد سبعة أعوام من العمل في المجال الصحافي، شعرت شخصياً بالكثير من القيود والمعوقات التي تواجه طبيعية عملنا؛ فمهنة المتاعب تُعاقب من الحكومة كما هو الحال من البرلمان، وتبقى رازحة تحت نير التشريعات الإعلامية التي تكبلها وتحد من قدرتها على الانطلاق والبحث. ومع مرور الوقت باتت المطالبات الصحافية، كما ترى الحكومات العربية عموماً، نوعاً من الترف حتى باتت لا تلتفت لها أو تسعى لتعديلها رغم الدعوات الدولية إلى الالتزام بالمعايير الدولية الواردة في العهود والاتفاقيات والتفاهمات بين الدول والمنظمات الدولية. وفي الأردن، لا يبدو الوضع أفضل بكثير رغم ما تروج له الحكومة من أن “سقف الحرية حده السماء”، عقب تعديل قانون المطبوعات والنشر رقم 27 لسنة 2007 الذي ينص صراحة على “عدم جواز توقيف الصحافيين في قضايا حرية الرأي والتعبير”، وصدور قانون ضمان حق الحصول للمعلومات رقم 47 لسنة 2007 الذي يضمن للمواطن الحق في المعرفة. إن المتتبع لهذه التشريعات، يرى أنها “لم تأت بجديد”؛ فقانون المطبوعات والنشر حظر توقيف الصحافيين، لكنه بالمقابل غلظ من حجم العقوبات المالية عليه، كما أن الصحافي يمكن أن يحبس وفقاً للقوانين الأخرى المتعلقة بالعمل الصحافي وأبرزها قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته من جانب، ومن جانب آخر فإن قانون ضمان حق الحصول على المعلومات أعطى شرعية واضحة لقانون أرى بأنه “غير دستوري” بالمطلق وهو قانون حماية وثائق وأسرار الدولة رقم 50 لسنة 1971 والمؤقت منذ 40 عاماً عندما حظر المعلومات التي يصنفها هذا القانون ضمن “سرية” و “سرية للغاية”. لذا جاءت هذه الدراسة، وهي تحمل بين طياتها أملاً في تغيير الواقع السلبي الذي تتعرض له الصحافة في الدول العربية عموماً وفي الأردن خصوصاً، لا سيما وأنها تعاني من قيود “خانقة” تضعها ضمن الأنظمة الصحافية السلطوية، لا الليبرالية المتحررة التي تجعل من حق الصحافي الحصول على المعلومات ونشرها وتداولها ودونما تقيد بحدود الدولة. استطاعت هذه الدراسة أن تركز على قضايا، كنت أشرت إليها في كتابين صدرا لي سابقاً حول “جرائم الصحافة والنشر ــ الذم والقدح” و”حق الحصول على المعلومات” لأهميتهما من جانب، ولعدم إمكانية صدورها دون التطرق لهما من جانب آخر، وأبرزها حرية الرأي والتعبير ومفهومها على النطاق الدولي، والصعيد الدستوري فضلاً عن تعريف الصحافيين وحقوقهم وواجباتهم المحددة بنصوص القانون ومدى اتفاقها واختلافها مع المعايير الدولية. في التمهيد لهذه الدراسة، عرضنا لأهمية الصحافة في الحياة المعاصرة التي أصبح العالم فيها “قرية صغيرة” معولماً بحكم الوقت والظروف حتى بات بالإمكان تداول المعلومات بسرعة فائقة بفضل التطورات التكنولوجية الهائلة التي شهدها العصر الحديث، فضلاً الخصائص السلبية التي يتسم بها النظام الصحافي السلطوي والمميزات التي يتسم بها النظام الليبرالي. وتناول الفصل الأول من هذه الدراسة مفهوم حرية الرأي والتعبير بصورة عامة، وعلى النطاقين الدولي والدستوري، فضلاً عن أشكال هذه الحرية وأبرزها الصحافة ومفهومها وأهميتها، وتعريف الصحافيين وحقوقهم وواجباتهم، كما أسلفنا. وعمدنا في الفصل الثاني من هذه الدراسة إلى مقارنة الوضع التشريعي في الأردن بالدول العربية من جهة، وبالدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية من جانب آخر، قبل أن نختم في فصل ثالث حول مواءمة حرية الصحافة في التشريع الأردني للمعايير الدولية، ومدى اتفاق التشريعات القانونية التي تتعلق بالعمل الصحافي مع هذه المعايير، فضلاً عن الواجبات الملقاة على الدولة حال عدم اتفاقها. وبذلك، تكون هذه الدراسة جهداً جديداً نتمنى أن يضيف شيئاً جديداً للمكتبة الصحافية والقانونية العربية التي نأمل أن تزخر بدراسات من هذا النوع حتى يعرف الصحافيون وهم يخوضون صراعاتهم من أجل الحرية في بلدانهم ما لهم وما عليهم. ولأن الكمال لله تعالى، نأمل من كل من يطلع على هذه الدراسة أن يلفت انتباهنا إلى أي خلل اكتنفها، إعمالاً للحق في إبداء الآراء ومناقشتها، والله نسأل التوفيق.
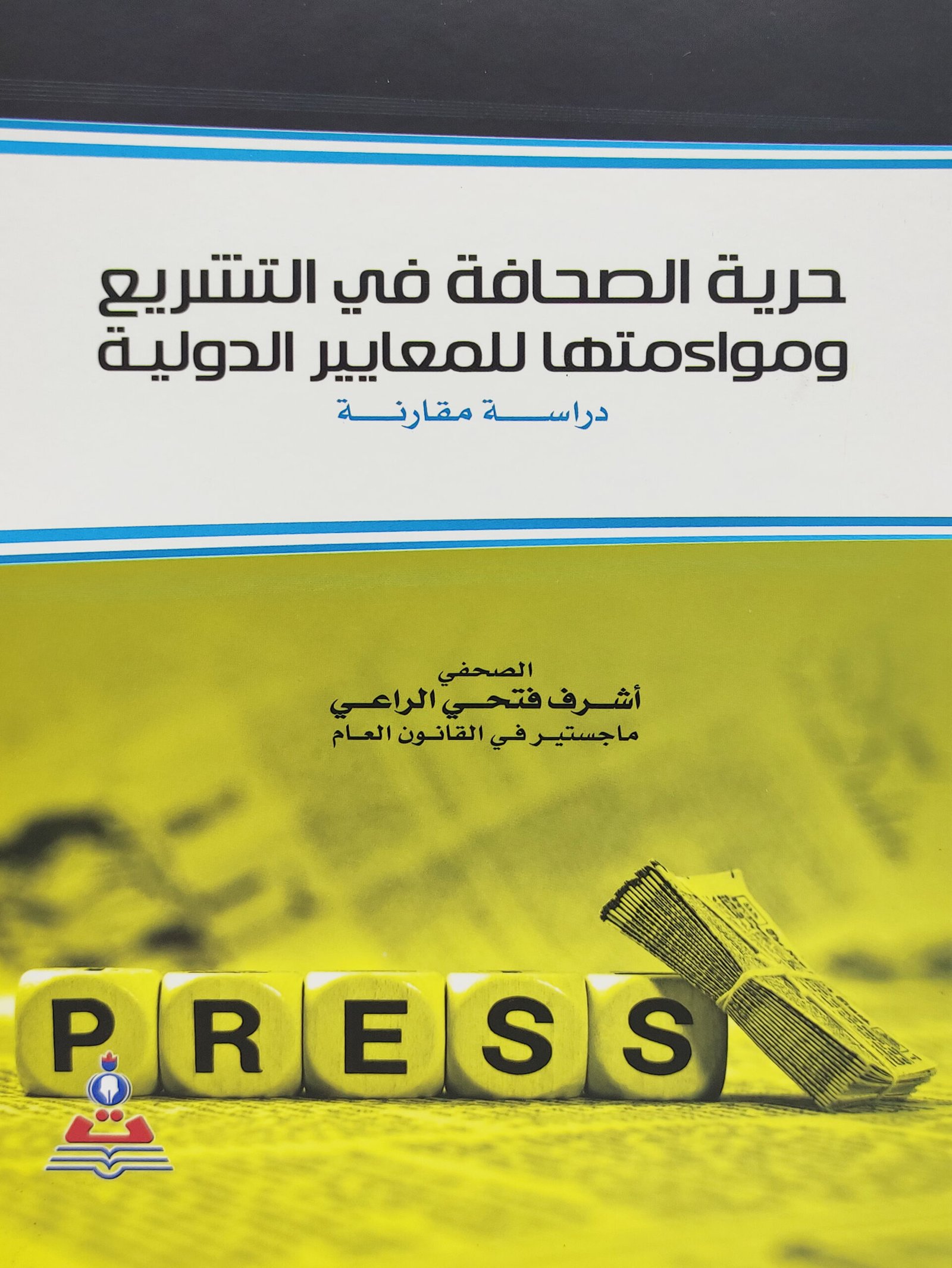
حرية الصحافة في التشريع ومواءمتها للمعايير الدولية دراسة مقارنة
عدد الصفحات : 144 صفحة
تصدر هذه الدراسة، ضمن سلسلة دراسات آليت على نفسي وبجهد فردي إصدارها، علها تجد من يستمع لها أو يلتفت إليها، في ظل أصوات صحافية علت وعلت كثيراً لبيان القيود التي تكتنف هذه المهنة دون أن تنظر إليها الحكومات العربية بعين الرضى. بعد سبعة أعوام من العمل في المجال الصحافي، شعرت شخصياً بالكثير من القيود والمعوقات التي تواجه طبيعية عملنا؛ فمهنة المتاعب تُعاقب من الحكومة كما هو الحال من البرلمان، وتبقى رازحة تحت نير التشريعات الإعلامية التي تكبلها وتحد من قدرتها على الانطلاق والبحث. ومع مرور الوقت باتت المطالبات الصحافية، كما ترى الحكومات العربية عموماً، نوعاً من الترف حتى باتت لا تلتفت لها أو تسعى لتعديلها رغم الدعوات الدولية إلى الالتزام بالمعايير الدولية الواردة في العهود والاتفاقيات والتفاهمات بين الدول والمنظمات الدولية. وفي الأردن، لا يبدو الوضع أفضل بكثير رغم ما تروج له الحكومة من أن “سقف الحرية حده السماء”، عقب تعديل قانون المطبوعات والنشر رقم 27 لسنة 2007 الذي ينص صراحة على “عدم جواز توقيف الصحافيين في قضايا حرية الرأي والتعبير”، وصدور قانون ضمان حق الحصول للمعلومات رقم 47 لسنة 2007 الذي يضمن للمواطن الحق في المعرفة. إن المتتبع لهذه التشريعات، يرى أنها “لم تأت بجديد”؛ فقانون المطبوعات والنشر حظر توقيف الصحافيين، لكنه بالمقابل غلظ من حجم العقوبات المالية عليه، كما أن الصحافي يمكن أن يحبس وفقاً للقوانين الأخرى المتعلقة بالعمل الصحافي وأبرزها قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته من جانب، ومن جانب آخر فإن قانون ضمان حق الحصول على المعلومات أعطى شرعية واضحة لقانون أرى بأنه “غير دستوري” بالمطلق وهو قانون حماية وثائق وأسرار الدولة رقم 50 لسنة 1971 والمؤقت منذ 40 عاماً عندما حظر المعلومات التي يصنفها هذا القانون ضمن “سرية” و “سرية للغاية”. لذا جاءت هذه الدراسة، وهي تحمل بين طياتها أملاً في تغيير الواقع السلبي الذي تتعرض له الصحافة في الدول العربية عموماً وفي الأردن خصوصاً، لا سيما وأنها تعاني من قيود “خانقة” تضعها ضمن الأنظمة الصحافية السلطوية، لا الليبرالية المتحررة التي تجعل من حق الصحافي الحصول على المعلومات ونشرها وتداولها ودونما تقيد بحدود الدولة. استطاعت هذه الدراسة أن تركز على قضايا، كنت أشرت إليها في كتابين صدرا لي سابقاً حول “جرائم الصحافة والنشر ــ الذم والقدح” و”حق الحصول على المعلومات” لأهميتهما من جانب، ولعدم إمكانية صدورها دون التطرق لهما من جانب آخر، وأبرزها حرية الرأي والتعبير ومفهومها على النطاق الدولي، والصعيد الدستوري فضلاً عن تعريف الصحافيين وحقوقهم وواجباتهم المحددة بنصوص القانون ومدى اتفاقها واختلافها مع المعايير الدولية. في التمهيد لهذه الدراسة، عرضنا لأهمية الصحافة في الحياة المعاصرة التي أصبح العالم فيها “قرية صغيرة” معولماً بحكم الوقت والظروف حتى بات بالإمكان تداول المعلومات بسرعة فائقة بفضل التطورات التكنولوجية الهائلة التي شهدها العصر الحديث، فضلاً الخصائص السلبية التي يتسم بها النظام الصحافي السلطوي والمميزات التي يتسم بها النظام الليبرالي. وتناول الفصل الأول من هذه الدراسة مفهوم حرية الرأي والتعبير بصورة عامة، وعلى النطاقين الدولي والدستوري، فضلاً عن أشكال هذه الحرية وأبرزها الصحافة ومفهومها وأهميتها، وتعريف الصحافيين وحقوقهم وواجباتهم، كما أسلفنا. وعمدنا في الفصل الثاني من هذه الدراسة إلى مقارنة الوضع التشريعي في الأردن بالدول العربية من جهة، وبالدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية من جانب آخر، قبل أن نختم في فصل ثالث حول مواءمة حرية الصحافة في التشريع الأردني للمعايير الدولية، ومدى اتفاق التشريعات القانونية التي تتعلق بالعمل الصحافي مع هذه المعايير، فضلاً عن الواجبات الملقاة على الدولة حال عدم اتفاقها. وبذلك، تكون هذه الدراسة جهداً جديداً نتمنى أن يضيف شيئاً جديداً للمكتبة الصحافية والقانونية العربية التي نأمل أن تزخر بدراسات من هذا النوع حتى يعرف الصحافيون وهم يخوضون صراعاتهم من أجل الحرية في بلدانهم ما لهم وما عليهم. ولأن الكمال لله تعالى، نأمل من كل من يطلع على هذه الدراسة أن يلفت انتباهنا إلى أي خلل اكتنفها، إعمالاً للحق في إبداء الآراء ومناقشتها، والله نسأل التوفيق.

حقوق الإنسان ضماناتها ومبررات قيودها
عدد الصفحات : 240 صفحة
إن البحث في مجال حقوق الإنسان أمر له أهميته وانعكاساته على مفاهيم الحريات وتعزيزها لما تشكله هذه الحقوق والحريات من أثر على تفعيل العمل الديمقراطي وحماية حقوق المواطنين. وإذا كانت حقوق الإنسان قد بدأت منذ بدء الخليقة باعتبارها حقوقاً طبيعية لصيقة بالإنسان، بحيث نشأت مع نشأه البشرية فإن الاهتمام بها بدأ يتطور مع تطور المجتمعات على مدى العصور. وإذا نظرنا إلى هذا التطور نجده أصبح معياراً أساسياً في الارتقاء بمفهوم الدولة الحديثة. وعليه وإيماناً منا بدور الأردن الفاعل في تعزيز هذه الحقوق والضمانات وإفساح المجال أمام مؤسسات المجتمع المدني حكومية وغير حكومية وكذلك المركز الوطني لحقوق الإنسان وغيرها من المؤسسات، فقد آثرت تقديم هذه الدراسة القانونية والدستورية لبيان هذه المفاهيم المتعلقة بحقوق الإنسان وضمانها والقيود الواردة عليها ومبرراتها. آملين أن نضع هذه الدراسة بين أيادي الباحثين والقراء في هذا الجانب الدستوري، لذلك رأينا أن نعمل في هذه الدراسة بتسليط الضوء على مفاهيم حقوق الإنسان في الدستور الأردني، وموقفه من الحقوق الدستورية والحريات وكيفية حمايتها وإقرار الضمانات الدستورية لهذه الحقوق، وموقف التشريعات المقارنة من ذلك. كما سنبين كيفية تناول الدستور الأردني، وكذلك القوانين والتشريعات المقارنة للقيود الواردة التي تعمل على إيجاد مبررات للحد من هذه الحقوق لضماناتها في أحوال تحتاج من خلالها الدولة النزول إلى الحد الأدنى للحفاظ على هذه الحقوق والضمانات، سائلين المولى أن يوفقنا في ذلك.
