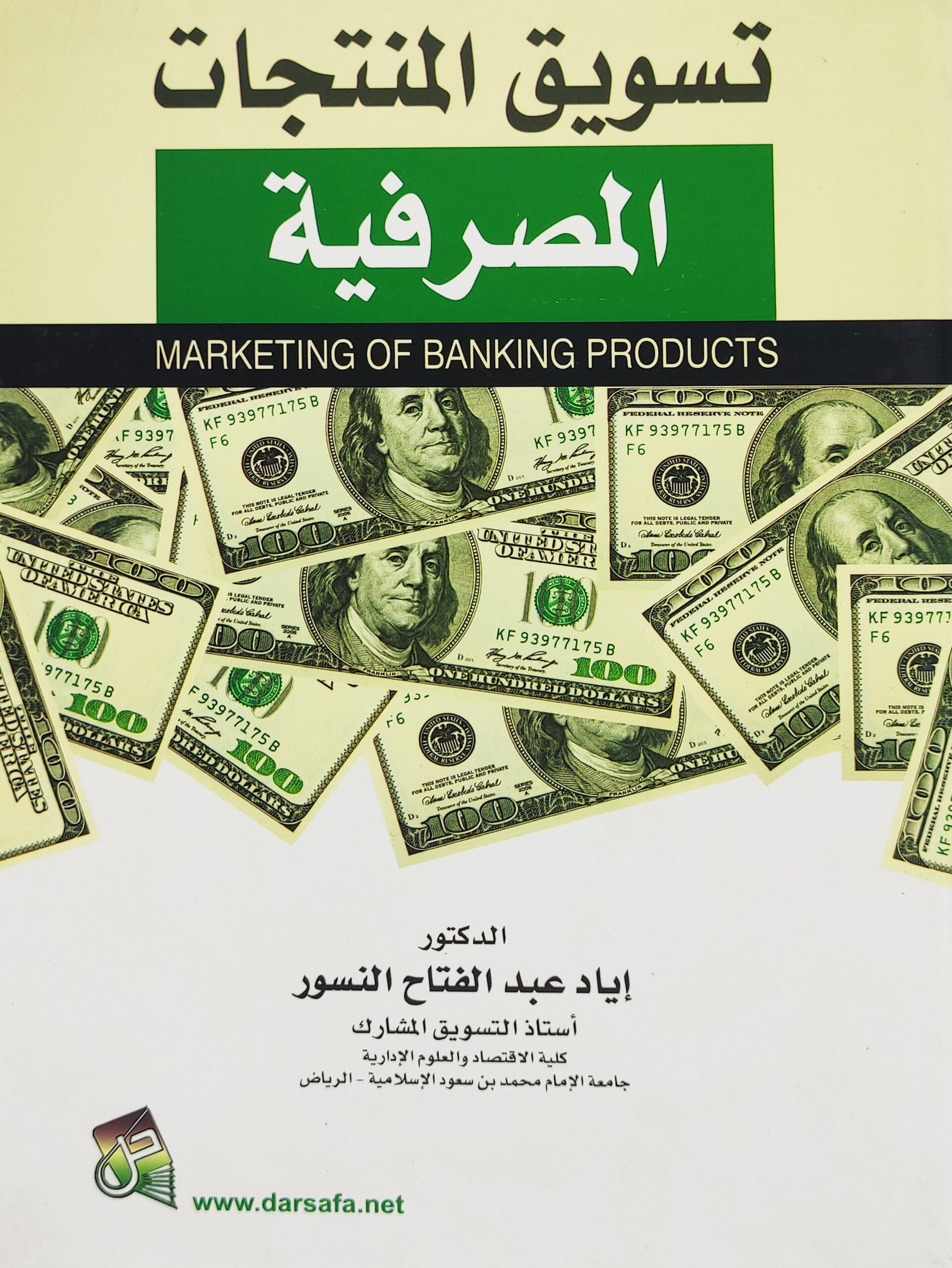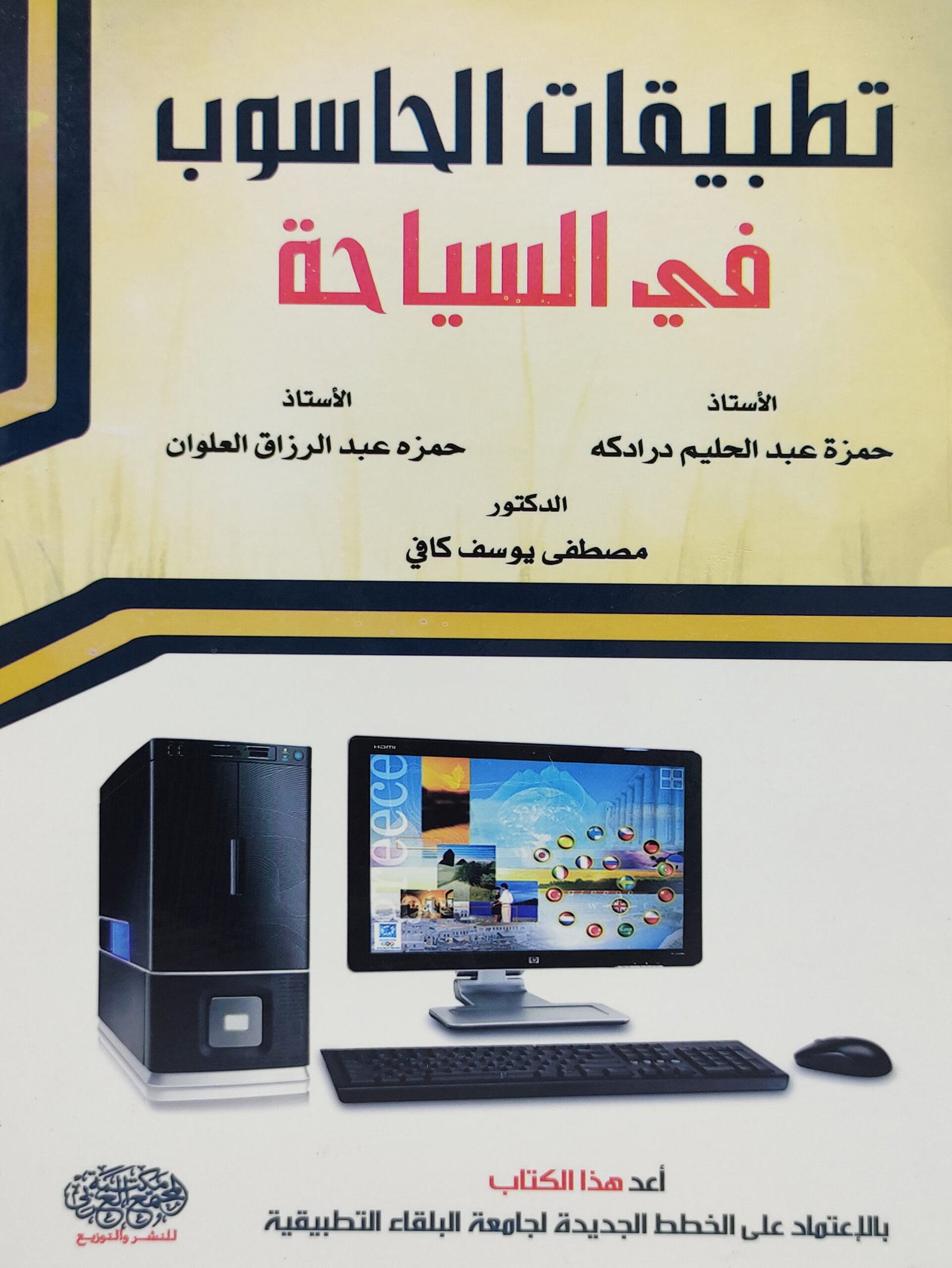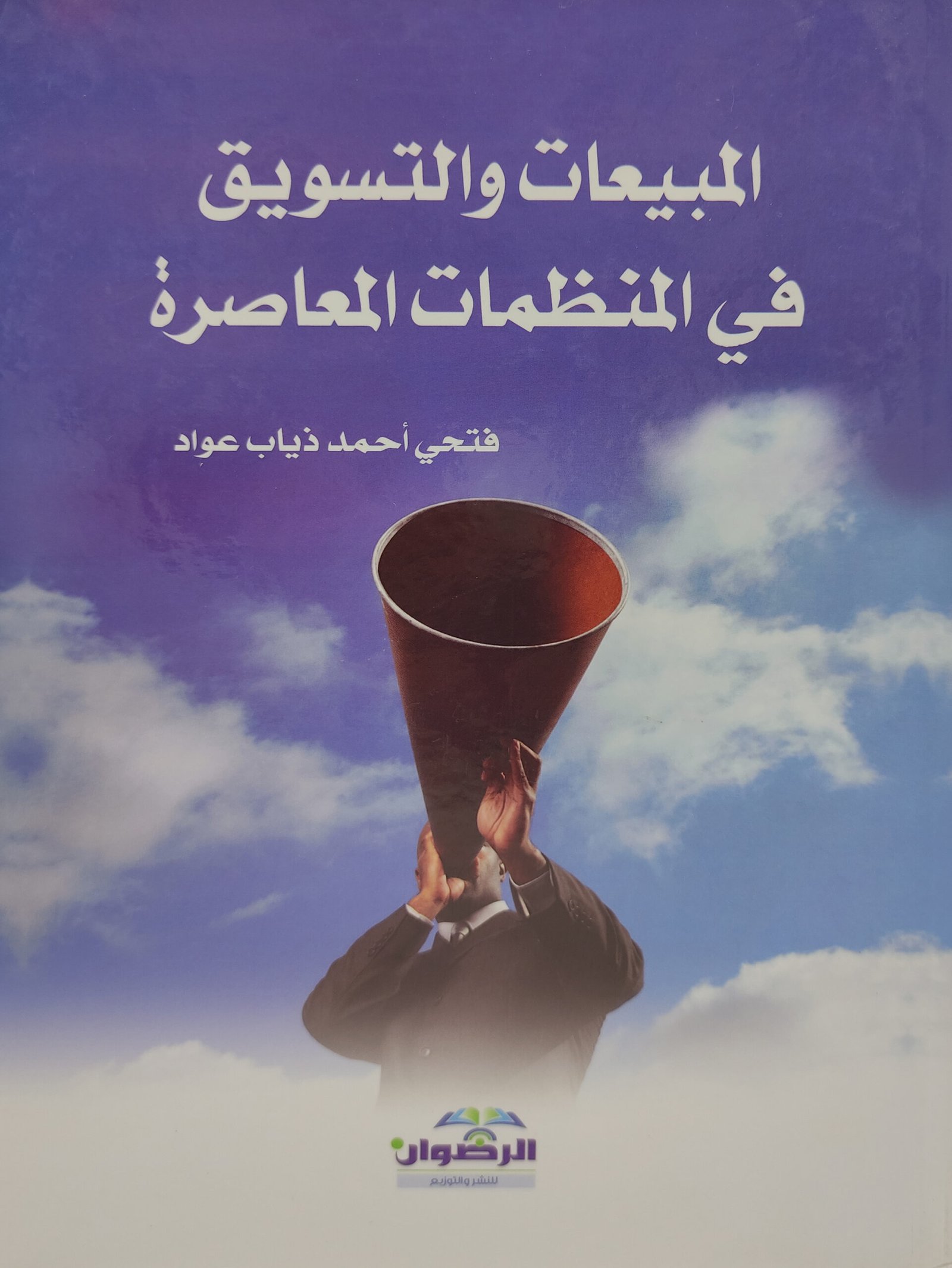
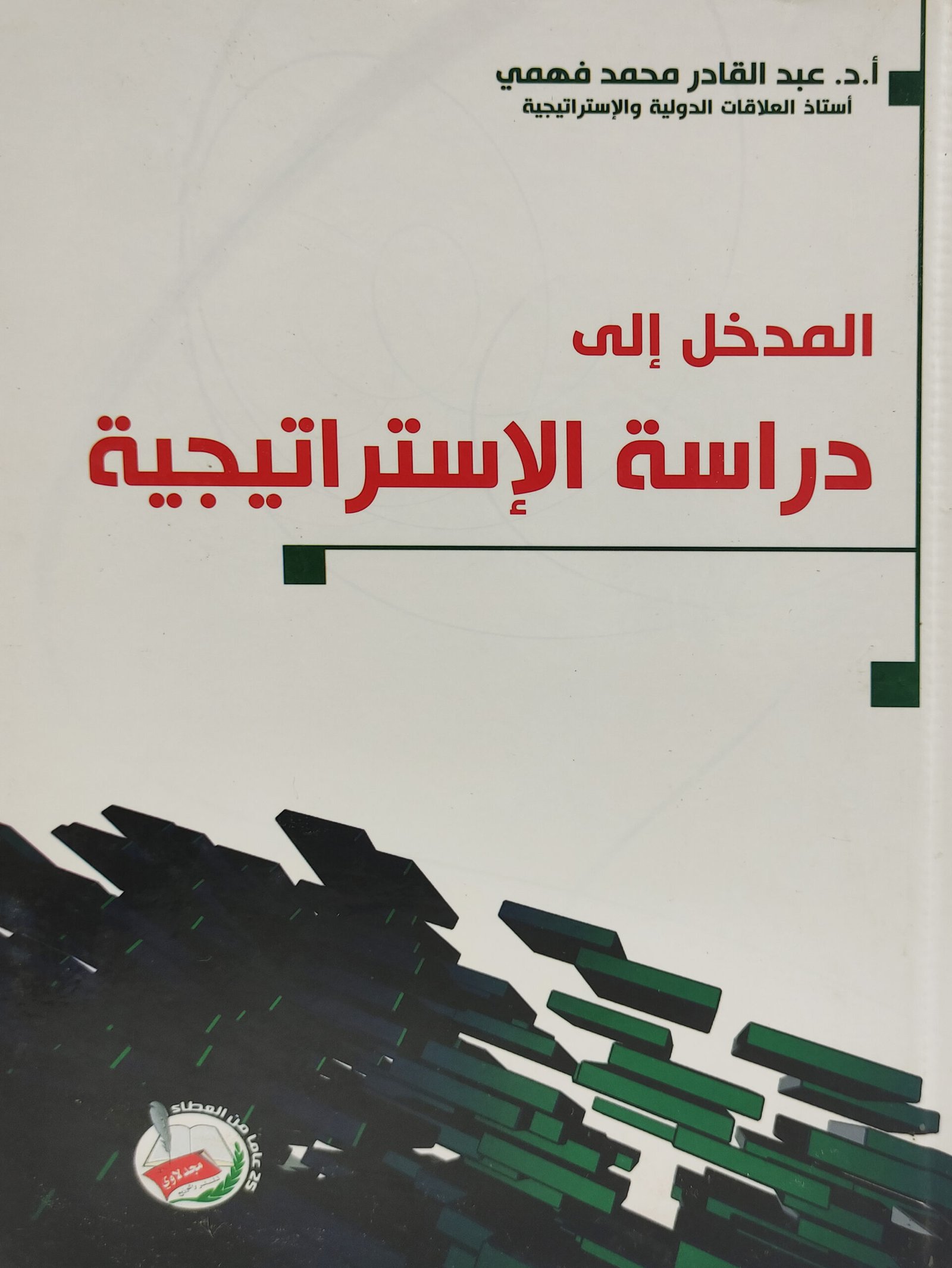
المدخل إلى دراسة الإستراتيجية
عدد الصفحات : 344 صفحة
تحظى الاستراتيجية ، كموضوع باهتمام متزايد وواسع النطاق من قبل المفكرين والمثقفين والأكاديميين ، فضلاً عن اهتمام النخب القيادية والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية لما لها من تماس شديد وعلاقة وثيقة بالعديد من مجريات السياسة الدولية ، وهذه الجاذبية التي تتحلى بها الإستراتيجية جعلت منها مفردة مقترنة بجملة أفعال لا حصر لها وإن لم تكن ذات طبيعة سياسية . فكلمة إستراتيجية تستخدم اليوم في مختلف ميادين الحياة ، وفي أنشطة وفعاليات عديدة حتى أصبح من الصعوبة بمكان تحديد ما المقصود بها على وجه الخصوص ، ولا شك أن هذه السيولة في استخدام المصطلح إن دلت على شيء إنما تدل على أهمية الاستراتيجية كموضوع تفرض علينا موجبات الضرورة العلمية والموضوعية دراستها وتحديد ما هميتها ، وخاصة بالنسبة لطلبة العلوم السياسة حيث تلامس هذه المادة العديد من الموضوعات التي ينشغلون بدراستها . وقد حرصنا في هذا الكتاب على معالجة الجوانب النظرية والتطبيقية التي يتشكل منها علم الاستراتيجية وبإبعادها السياسية والعسكرية في إطار وحدة فكرية تأخذ بنظر الاعتبار ما تفوضه الضرورات العلمية – الأكاديمية لتغطية القسط الأكبر من موضوعاته .

المرجع في التفكير الإستراتيجي والإدارة الإستراتيجية
عدد الصفحات : 518 صفحة
مع تزايد درجة التعقيد في بيئة الأعمال، نتيجة تعدد مكونات البيئة وتداخلها فضلًا عن سرعة تغيرها وعدم ثباتها أو استقرارها، يصبح منهج التفكير الإستراتيجي وممارسة الإدارة الإستراتيجية أكثر ضرورة وأهمية لتحقيق رسالة المنظمة وأهدافها.
ويقدم المؤلف هذا المرجع لمعاونة طلاب العلم والباحثين والممارسين من المديرين ورجال الأعمال والمستثمرين للإسترشاد به في تعلم وممارسة الإدارة الإستراتيجية وإنشاء نظام للتخطيط الإستراتيجي وإعداد الخطط الإستراتيجية.
وقد روعى في إعداد هذا المرجع أن يتحقق التوازن والدمج بين الأسس والقواعد العلمية من جانب ومتطلبات الممارسة العلمية لإكتساب مهارات منهج التفكير الإستراتيجي وتطبيق الإدارة الإستراتيجية من جانب آخر، وتقديم ذلك في صورة تساعد القارئ أن يكون منها منهج ودليل عمل للتخطيط الإستراتيجي وإعداد الخطة الإستراتيجية.

تأثير الذكاء التنافسي في تحديد الخيار الإستراتيجي على مستوى وحدة الأعمال
عدد الصفحات : 204 صفحة
تعيش المنظمات ذلك التغيير المتسارع الذي تعد عولمة الأسواق, والتسارع العلمي والتطور التقني أبرز معطياته نجد أن القادة الاستراتيجيين في المنظمات بحاجة الى أنظمة مراقبة وانذار مبكر يمكنها توفير المعلومات المطلوبة عن بيئة الاعمال في الوقت المناسب, فيما يتعلق بدقائق الفرص والتهديدات والمخاطر التنافسية وهنا يشير الكثيرون الى ان اكتشاف معطيات منظومة الذكاء التنافسي ومدخلاتها بالتحديد.
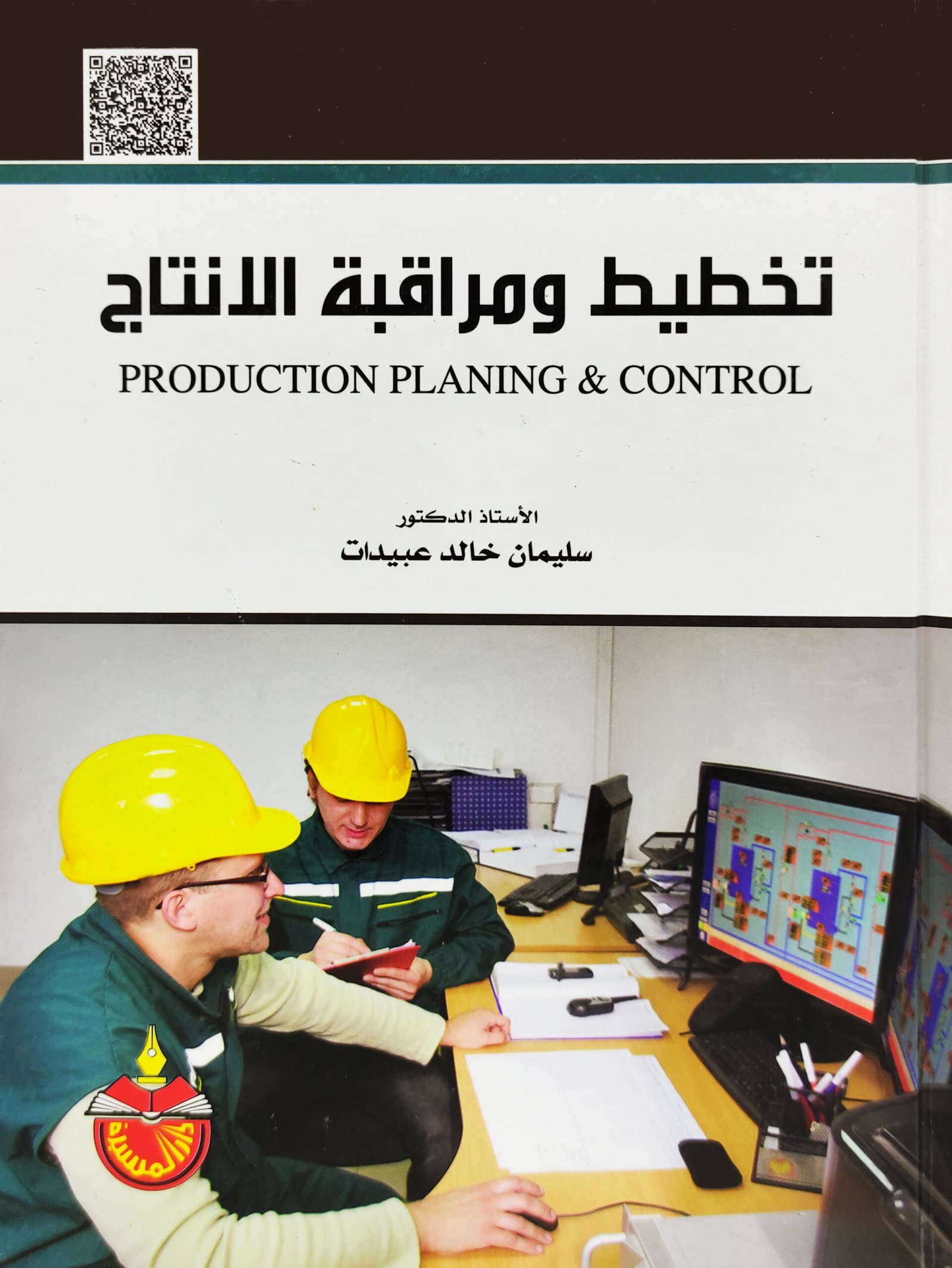
تخطيط ومراقبة الإنتاج
عدد الصفحات : 352 صفحة
مع عولمة الأعمال في السنوات الأخيرة أصبحت المنظمات مهتمة في إيجاد وتوزيع الأجزاء والمواد والسلع وللعالم ككل. والجدير بالذكر أن العملاء يرغبون في الحصول على سلعهم بأسرع ما يمكن وباعتمادية عالية، وأن هؤلاء العملاء قد يتطلعون إلى موردين آخرين إذا كان هناك تأخير في إشباع طلباتهم. وكنتيجة لذلك فقد أصبحت العمليات المتعلقة بتخطيط ومراقبة الإنتاج حيوية وهامة وأساسية للنجاح التنافسي أكثر من أي وقت مضى.
تضمن هذا الكتاب استعراضاً معمقاً لمواضيع أساسية في مجال تخطيط ومراقبة الإنتاج وبذلك الشكل الذي يمكن الدارسين والمديرين على حد سواء من فهم ومتابعة المفاهيم والقضايا الأساسية لتخطيط ومراقبة الإنتاج وبالتالي زيادة قدرة المديرين على اتخاذ القرارات الجيدة والتي من شأنها أن تضع المنظمة في موقع تنافسي جيد.
لقد أصبح واضحاً أن المنظمات التي تستطيع أن تعمل وبمخزون منخفض قد حققت مزايا تنافسية. وقد تبنت العديد من المنظمات الاستراتيجيات المتعلقة بالمقارنة المرجعية والتحسين المستمر والتي تدعو إلى تخفيض المخزون. حيث إن هذه الاستراتيجيات تتضمن عددا قليلا من الموردين، وأحجاما صغيرة، وفترة انتظار قصيرة، وبرامج صيانة وقائية، وتدريب العاملين، والتركيز على رضا العملاء. وإذا ما تم تنفيذ كل ما تقدم بشكل جيد فإن ذلك سيؤدي إلى تخفيض المخزون وبالتالي التخلص من كلفة تتراوح بين 5 و50 بالمائة من كلفة المواد المخزونة.
إن تهيئة الطلبة ورجال الأعمال للتعامل مع الظروف البيئية المتغيرة تستلزم تزويدهم بالمعرفة اللازمة وبالفهم الجيد لطبيعة العمليات المتعلقة بتخطيط ومراقبة الإنتاج وبذلك الشكل الذي يؤدي إلى تحسين أداء المنظمات وبالتالي موقعها التنافسي.
وقد تضمن هذا الكتاب عشرة فصول حاولنا من خلالها تقديم الإطار النظري وتقليل الفجوة بين هذا الإطار والمشاكل في الحياة العملية وذلك من خلال تقديم الأنظمة والنماذج التي تمكن الإدارة من البناء على الخبرات الجيدة للأكاديميين والممارسين.
أما تنظيم هذا الكتاب فقد بدأ باستعراض لأهمية تخطيط ومراقبة الإنتاج، في حين أهتم الفصل الثاني بأنظمة الجدولة والتخطيط الإجمالي، أما الفصل الثالث فقد استعرض الجدولة المتقطعة، كما استعرض الفصل الرابع موضوع تخطيط وجدولة المشاريع، كذلك استعرض الفصلين الخامس والسادس أساسيات في الرقابة على المخزون وتطبيقات الرقابة على المخزون. وقد تم استعراض تخطيط احتياجات المواد في الفصل السابع في حين تم استعراض إدارة الصيانة في الفصل الثامن. وأخيراً تم استعراض إدارة الجودة الشاملة والرقابة على الجودة في الفصلين التاسع والعاشر.

تسويق الخدمات الصحية
عدد الصفحات : 312 صفحة
جاء هذا الكتاب ليكون ضمن مواضيع جديدة وبفصول ومباحث شاملة تنقل الواقع الأكاديمي لتسويق الخدمات الصحية، حيث يقع في عشرة فصول، جاءت بشكل متسلسل وبلغة مدققة مدعوما بقائمة مراجع عربية وأجنبية ومواقع إلكترونية، حيث جاءت هذه الفصول على النحو التالي:
تناول الفصل الأول مقدمة في التسويق وتسويق الخدمات، وأهمية التسويق وأهدافه لمنظمات الأعمال، والعناصر المكونة للمفهوم الحديث للتسويق، ومفاهيم التسويق الأساسية، والمنافع الاقتصادية التي تؤديها التسويق، والخدمات التسويقية، ومفهوم الخدمة، وأهمية الخدمات في الاقتصاد الوطني للدول، وخصائص الخدمات التسويقية، وتصنيف الخدمات، وأنواع تسويق الخدمات.
ويتضمن الفصل الثاني تسويق الخدمات الصحية، ومفهومها، والتطور الفكري والتاريخي للتسويق الصحي، مرحلة المفهوم البيعي، المفهوم التسويقي، المفهوم الأخلاقي للتسويق، وأثر التطور التكنولوجي على تسويق الخدمات الصحية، والعوامل التي ساهمت في تطوير الخدمات الصحية في الأردن، وحاجة المستشفيات للتسويق، وأهمية وأهداف تسويق الخدمات، وخصائص التسويق الصحي، وأنواع الخدمات الصحية، ومزيج الخدمات، واقتراحات لحلول بعض المشكلات التي تواجه المستشفيات.
أما الفصل الثالث فقد ساهم في إظهار المزيج التسويقي الصحي، والمنتج الصحي، ومزيج المنتج الصحي، وتخطيط وتطوير المنتجات الصحية، والتسعير الصحي، وتوزيع الخدمات الصحية، والترويج، ونظام الاتصالات في المستشفى، وأهمية وأهداف الترويج الصحي، وأهمية الترويج في المجال الصحي، والمزيج الترويجي للخدمات الصحية.
ونتعرف في الفصل الرابع على تجزئة السوق الصحي واختيار السوق المستهدف، ومزايا تجزئة السوق الصحي، وشروط تجزئة السوق، وأساليب تجزئة السوق الصحي، وتجزئة السوق الصحي حسب الحالة المرضية.
في حين يتضمن الفصل الخامس جودة الخدمات الصحية، وتعريف الجودة في الخدمات الصحية، والعوامل المؤثرة على الخدمات الصحية، وفوائد تطبيق الجودة، وخصائص الجودة، وتوقعات المرضى، وأبعاد الجودة في قطاع المستشفيات، وتقييم جودة الخدمات الصحية، والجودة الشاملة ومواصفات الأيزو في المستشفيات الأردنية.
الفصل السادس وإشتمل على نظم المعلومات الصحية وأهميتها، والعوامل التي ساعدت على تطبيق نظم المعلومات في المستشفيات، وخصائص نظام المعلومات الصحية، وجودة المعلومات، وعناصر نظام المعلومات الصحية، ومكونات نظام المعلومات التسويقي الصحية، ومعيار نظام الاستخبارات التسويقية، وأنواع بحوث التسويق، ومجالات بحوث التسويق، وخطوات إجراء البحث التسويقي، ومعوقات نظم المعلومات الصحية.
ويبدأ الفصل السابع في سلوك المستهلك الشرائي الصحي، ومفهوم سلوك المستهلك والسلوك الشرائي، وأنواع السلوك الشرائي، والعوامل المؤثرة للسلوك الشرائي للمستهلك، وخصائص المشتري (المكونات النفسية) وأثرها على القرار الشرائي، والعلاقة بين الحاجة والدافع، ومراحل وإجراءات اتخاذ القرار الشرائي للخدمات الصحية، والأدوار المحتملة في عملية الشراء.
أما الفصل الثامن فقد تضمن المسؤولية الاجتماعية في الخدمات الصحية، وتاريخ نشأة المسؤولية الاجتماعية، ومفهوم المسؤولية الاجتماعية، وأبعاد المسؤولية الاجتماعية للمستشفيات، واتجاهات المسؤولية الاجتماعية، والمسؤولية الاجتماعية ما بين مؤيد ومعارض، واستراتيجيات التعامل مع المسؤولية الاجتماعية.
والفصل التاسع اشتمل على التخطيط الإستراتيجي في المستشفيات، ومفهوم التخطيط الاستراتيجي، وخصائص التخطيط الاستراتيجي، ومزايا وأهداف التخطيط الاستراتيجي في المنظمات الصحية، ومبررات التخطيط الاستراتيجي، ومبادئ التخطيط الاستراتيجي، والأبعاد الزمنية للتخطيط الصحي، ومراحل التخطيط الاستراتيجي، وتحديد البدائل الاستراتيجية، وتنفيذ الخطة الاستراتيجية، والرقابة والتغذية الراجعة، ومعوقات التخطيط الاستراتيجي، ومنهجية إعداد الخطة الإستراتيجية. وأخيرا كانت الحالات الدراسية في الفصل العاشر.