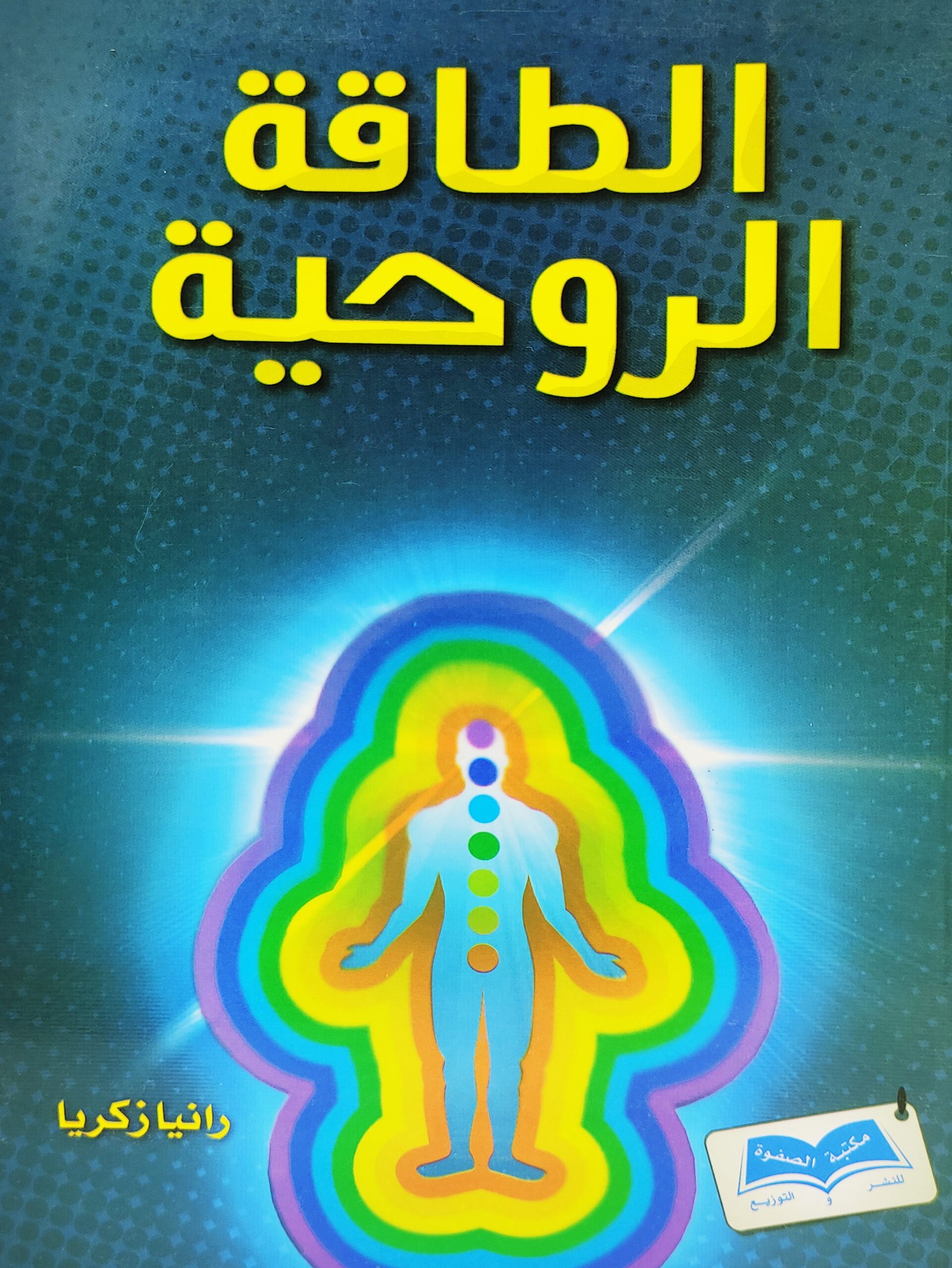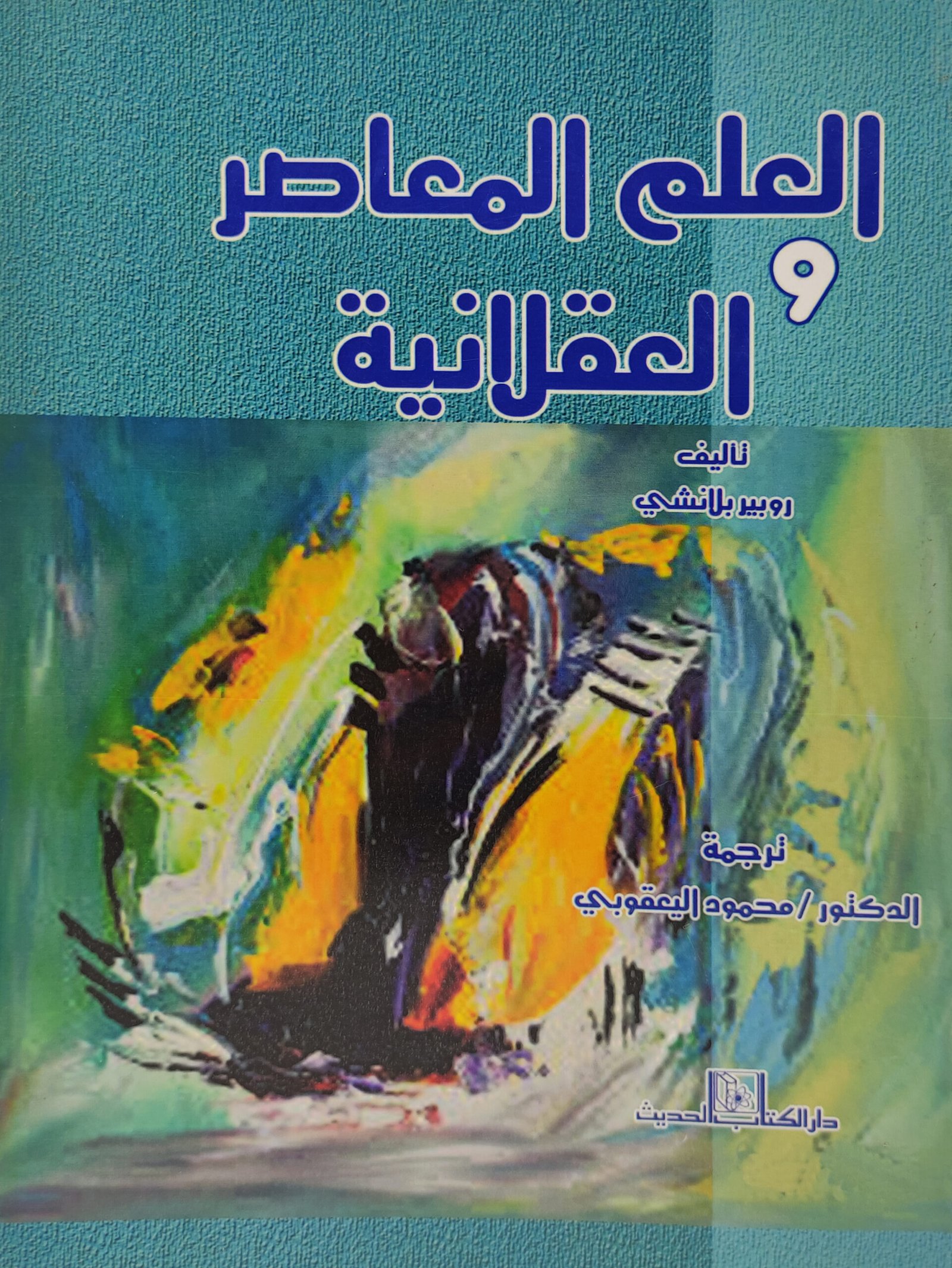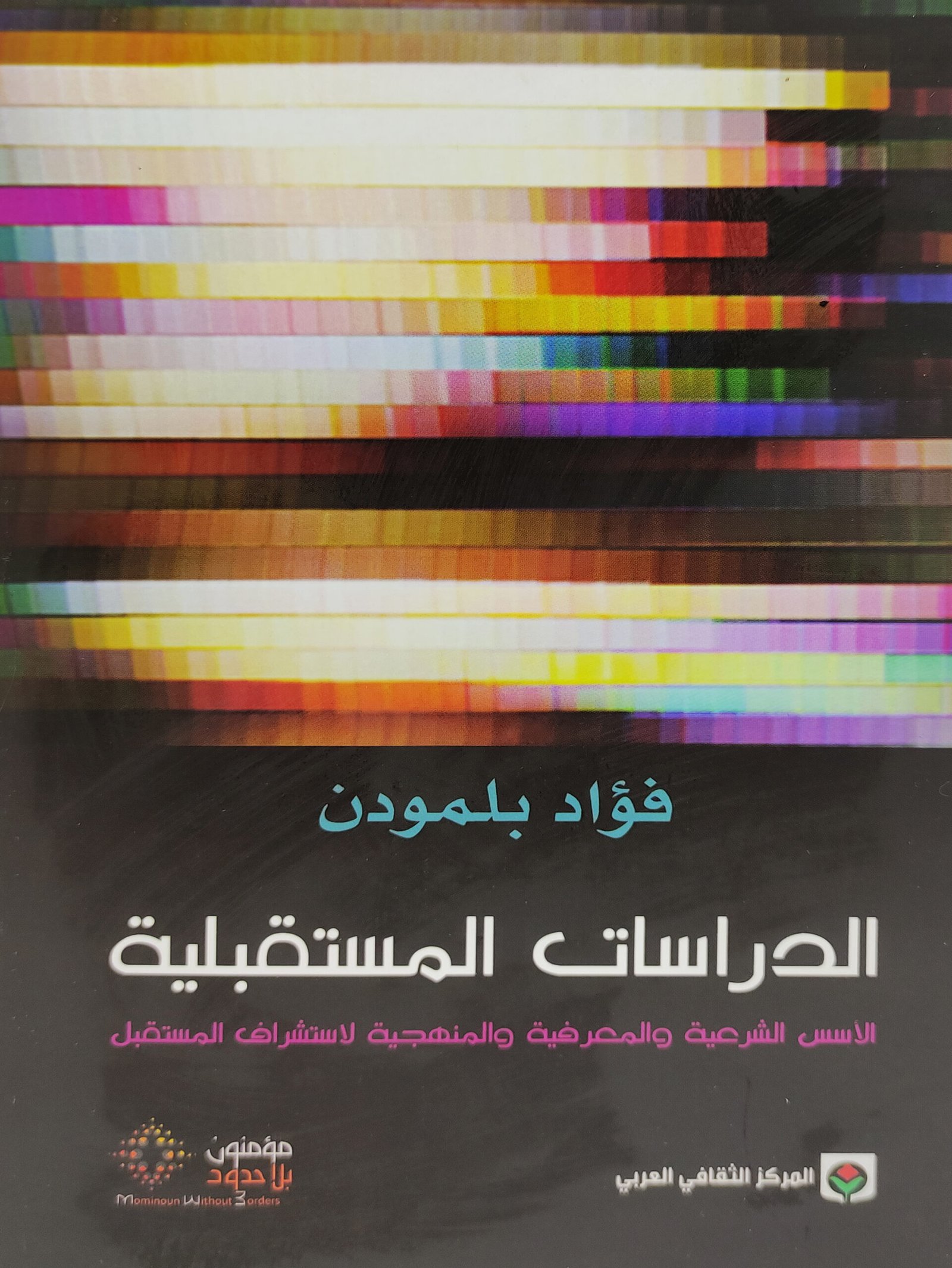
الدراسات المستقبلية الأسس الشرعية والمعرفية والمنهجية لإستشراق المستقبل
عدد الصفحات : 240 صفحة
إذا كانت الدراسات المستقبلية بالغرب-سواء نظر إليها كعلم أو كفنّ أو كمنهجية علمية-قد شقت طريقها وحققت لنفسها موطئ قدم داخل الجامعات ومراكز الأبحاث والمؤسسات العسكرية والمدنية، بحيث أصبحت أساس صناعة القرار السياسي والاقتصادي والاستراتيجي داخل البلدان المتقدمة، فإن النظر إلى المستقبل داخل العالم العربي والإسلامي عموماً يكتنفه الكثير من الاضطراب والتوجس وعدم الاكتراث، وحتى الإسهامات التي أدلى بها في هذا المجال تطغى عليها المعيارية ولا تعدو حدود التبشير والتوجيه لأهمية هذا المسعى العلمي، بينما نجد نوعاً من التعامل الانتهازي مع الدراسات المستقبلية من قبل بعض مراكز صنع القرار العاجزة عن مواجهة مشكلاة الحاضر وتداعياته.
ويأتي هذا الكتاب ليسهم في الجهود التعريفية والتنظيرية للدراسات المستقبلية في العالم العربي والإسلامي وتحقيق نوع من التراكم العلمي، وهو ما يتطلبه أي علم يسعى لتحقيق الريادة والازدهار.

الرؤى الفلسفية في الشعر العرافي الحر
عدد الصفحات : 534 صفحة
إن الشعر بوصفه موقفاً وخطاباً جماليين ينطوي على خطاب فلسفي ما ومن ذلك فإنه يحدد لغوياً وذاتياً، غير أن تحديده فلسفياً لا يؤدي به أن يتحول إلى فلسفة، وإذا ما حصل ذلك؛ فإن إنتفاء الشعري عن النص الذي من المفترض أن يكون شعرياً، يغدو أمراً محتوماً أو شبه محتوم.
وبسبب التباين الحاصل من هيمنة أحد المفهومين على الآخر، وبسبب عدم تحديد العلاقة الفكرية “الفلسفية” بالأدب، أو تلمس جذورها إلا بجهد نظري جهيد ودأب معرفي مع ضرورة الإنتباه على ما قد يثير هذا من توهم لجوانب العلاقة فيتحول الأدب إلى معادلات عقلية محضة تلامس أسباب تلك العلاقة؟…
إذ ينبغي توخي الحذر من ربط الفلسفة بالأدب خوفاً من إحتمال الوقوع في الخطأ إذا ما اختير مصطلح بعينه؛ لأن ثقافتنا تضم تعارضاً خطيراً بين الفكر والشعر؛ إذ يسعى كل منهما إلى الإستحواذ على روح الإنسان الذي تسكنه كما يقول أرباب النقد، وبسبب ذلك كثرت الشواهد النقدية التي تؤكد ذلك الخوف، فقد تردد كبار الباحثين العرب في إطلاق مصطلحات بعينها تجمع تلك العلاقة، أو تفرق بينها، ثم أدى هذا الحظر إلى تجنب تسمية تلك العلاقة إلى إختلاف في التسميات ثم حذر شديد في إطلاقها.
فقد أطلق عليها الدكتور إحسان عباس “المؤثرات الفلسفية في الشعر”، وأطلق عليها أدونيس “المؤثرات الفكرية” وسماها محمد شفيق شيا “البعد الفلسفي في الشعر”، وقد تناولوا تلك العلاقة عن طريق ربط الإتجاه الواقعي بالجماهير، أو عن طريق الإتجاه الذاتي أو الحدس أو الرؤيا الشاملة.
في هذا السياق تأتي هذه الدراسة والتي تمحورت حول موضوع الرؤى الفلسفية في الشعر الحرّ، وتحديداً؛ الرؤى الفلسفية في الشعر العراقي الحر، وهي تعني فيما تعني الأفكار التي تطرح في الشعر بوصفها تساؤلات فلسفية ليست من مهمة الشعر تحليلها أو عرضها أو شرحها؛ لأن شرحها من مهمة الفيلسوف، أما الشاعر فلا غنى له عنها.
وقد تناول الباحث تلك العلاقة بوصفها توظيفاً شعرياً يتصف بالمجازية والصورية اللتين بهما يعيد الشعر إنتاج الموضوعات الحسية والإنفعالية الجمالية، بحيث تبدو شكلاً تخيلياً مجازياً مختلفاً بهذه الدرجة أو تلك عن كينونته الواقعية.
هذا وقد قامت الدراسة على أربعة فصول اكتنفتها مقدمة وخاتمة، جاءت الدراسة في الفصل الأول حول الرؤى والفلسفة والشعر، رابطاً فيما بينها عن طريق الرؤى التي هي قوام الفلسفة كما هي قوام الشعر، وفيه أيضاً تعريف بعلاقة الفن بالفلسفة، وعلاقة الشعر بالفلسفة مناط الدراسة، ومن ثم كيف نظر الفلاسفة والنقاد “عرباً وأجانب” إلى الشعر وكيف عالجوا موضوعاته معالجة فلسفية وما النتائج التي توصلت إليها مدارس النقد الغربي في ظل التنافر الشديد بين الفلسفة والشعر؛ فضلاً عن الآراء التي تبناها النقد العربي التي جاءت متشابهة مع مثيلاتها من الآراء التي تبناها النقد الغربي، وليُخْتم الفصل الأول بعلاقة الرؤى الفلسفية بواقع حركة الشعر الحرّ في العراق.
أما الفصل الثاني والذي جاء تحت عنوان “الرؤى الفلسفية العابرة”، فقد عني بالرؤى الفلسفية التي هي عبارة عن تصورات لحالات تمرّ في حياة الإنسان غالباً ما يحيد عنها ويستعيض عنها بغيرها لأنها ليست مما يدخل في صميم حياته الوجدانية، أو أنها تنشأ بسبب حالات معينة يمكن للإنسان أن يتعافى منها كما في الغربة والإنتماء الفكري والسياسي.
أما الفصل الثالث وعنوانه “الرؤى الفلسفية ووسائل الأداء الشعري” فقد انصرف إلى الإضاءة الوجيزة لبعض وسائل الشعرية التي تأتي في سياق تنمية ممكنات النص الشعري في تقديم رؤاه الفلسفية.
وأخيراً فإن هذه الدراسة اتضح في ثناياها أن ثقافة الشاعر الحديث أسفرت عن وعي شعري معقد، فلم يعد الموضوع الشعري نمطاً مقنناً في الذاتية المفرطة، ولا إحساساً فردياً طافحاً بالعاطفة، بل أصبح العالم بأسره ميداناً للشعر، وأصبح الشاعر والوجود والإنسان موضوعات هيمنت على الفعل الكتابي الشعري؛ إذ أصبحت لغة القصيدة الجديدة هي الواقع نفسه بعدما كانت تعبيراً عن واقع شعري، فبرز نوع من الخيال يعتمد الرؤى الفلسفية وسيلة موضوعية تزاحم وسائل شعرية النص وتثبت حضوراً طيباً.
وبدا ملحّاً اللجوء من حين إلى آخر، إلى وسائل نقدية تأخذ على عاتقها مهمة الكشف عن تداخل الوسائل الشعرية والفكرية “الفلسفية”.
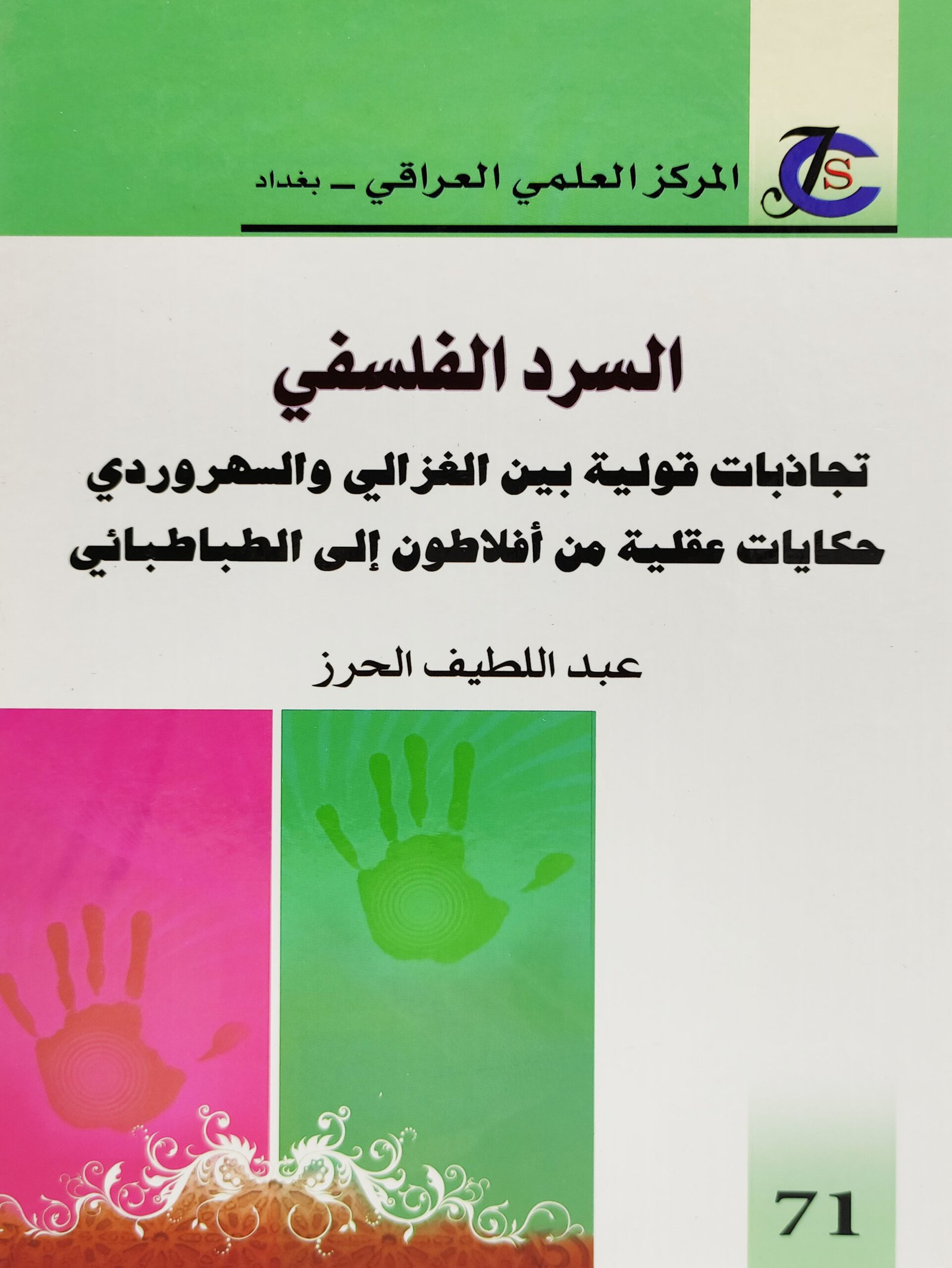
السرد الفلسفي
عدد الصفحات : 124 صفحة
في كتابه “السرد الفلسفي” يكشف “عبد اللطيف الحرز” عن وجه آخر للفلسفة غير البحث الاستدلالي؛ ألَا وهو (حكواتي سردي) وهو ما يشير إليه بقوله أن الفلسفة هي مجموعة تصوراتنا نحن عن الوجود، وهي تصورات لكائن حادث زماني، وقد توصل إلى هذه المعرفة المتكلمون من خلال تطور زماني في سنوات التعليم والتعلَم. إذن كل المفاهيم الفلسفية من هذه الناحية هي مفاهيم زمانية، وبالتالي فهي جزء من تاريخ شخصي لمجموعة من الناس.
وبناءً على ما تقدم يوضح كتاب “السرد الفلسفي” استخدام تقنية القصة والحكاية في الفلسفة ويقدم حكايات فريدة تناقلت بين كتب الفلاسفة منذ حضارة البابليين والمصريين وحتى ما بعد ظهور المسيحية والاسلام. حكايات ومناقشات تتجاوز المعقول والمنقول حيث يمتزج التاريخ بالعقل، والبرهان بالحكاية.
يضم الكتاب مقدمة وفصلين: في المقدمة ثلاثة مباحث هي “ارتباكات الكتابة بين الاستدلال والتخيل”، “من حدوث العالم إلى زمانية الفلسفة”، “جارية الرومي وحورية الطباطبائي”. أما الفصل الأول فجاء بعنوان: [ أبو حامد الغزالي، فلسفة الحجَام وعسل الاستعارة) ويضم سبعة مباحث نذكر منها: “بين الغوالي وابن طفيل، السرد جامع الفلاسفة”، “التواصل السردي من ابن الطفيل والسهروردي إلى العطار وابن سينا”… الخ. وأما الفصل الثاني فحمل عنوان: [ ملا صدرا”، “الإمام الخميني”، التصوف استراحة المحارب”، “معنويات تخييلية بين الطباطبائي والجيلاني”.
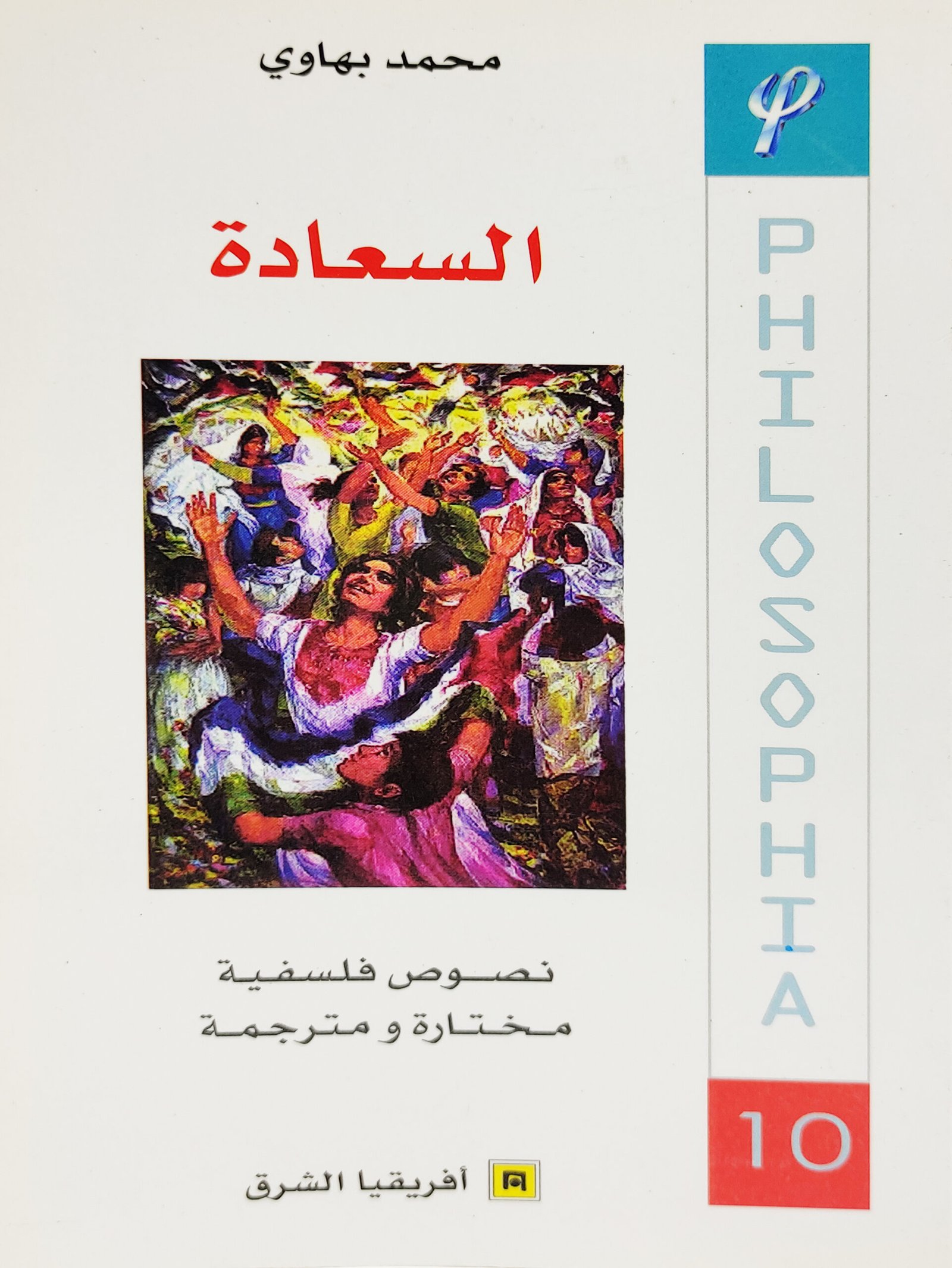

الطبيعة والثقافة دفاتر فلسفية نصوص مختارة 2
عدد الصفحات : 102 صفحة
الثقافة هي التجسيدُ الفعليّ لميل النوع البشري نحْو التمييز عن الطبيعة، وبالتالي عن الحيوان، وبما أن هذا الميلَ يسكن ثقافة النوع البشري، فإن الثقافة تتجه نحو ترويض الطبيعة تحقيقاً لذلك، سواء تعلق بالأمر بالطبيعةِ الخارجية أو بالطبيعة الداخلية.
لكن الثقافة كثيراً ما تصطدم بالطبيعة – وبخاصة الطبيعة البشرية – وتُصَادِمُها حيث تصبح تحكَماً تعسَفياً في طاقة الحياة (فرُويد) وحرماناً للإنسان من المتعة واللذة باسم قيم عُلْيَا (نِيتْشَه) أو تسخيراً للجسم والجنس خدمة لأهداف الحضارة (ماركُوز).
وقد ارتأينا الإنفتاح على نقاش تقليدي في تاريخ الفكر، وهو الصراعُ بين الفطري، أي ما ينتمي إلى الطبيعة، وبين ما هو مُكتسَب أي ما ينتمي إلى المجتمع والثقافة وما يتوصل إليه بالتعلَم وليس ما هو مُعطَى قبلياً.
وإذا كانت النصوص المقدمة هنا توسع إلى حدٍّ ما إشكالية العلاقة بين الطبيعة والثقافة وتخرجُ بها عن إطارها التقليدي، إطار الإشكالية الأنتربولوجية، فإن هذا التوسيع من شأنِهِ أن يسلّط أضواء أخرى على الإشكالية ويخرج بها من الدائرة البدائية، دائرة إنفصالِ الثقافة عن الطبيعة لتكشف عن الآليات المستمرّة للصراع بين الطبيعة والثقافة، سواء في تكييف الثقافة للطبيعة أو في ردُود فعلِ الطبيعة ذاتها على الثقافة.

الغير دفاتر فلسفية نصوص مختارة 10
عدد الصفحات : 88 صفحة
يتناول هذا الكتاب مفهوم الغير كمفهوم فلسفي من خلال مجموعة من النصوص المختارة التي تمت ترجمتها لمعرفة دلالات المفهوم وسياقه والمواقف الفلسفية منه.