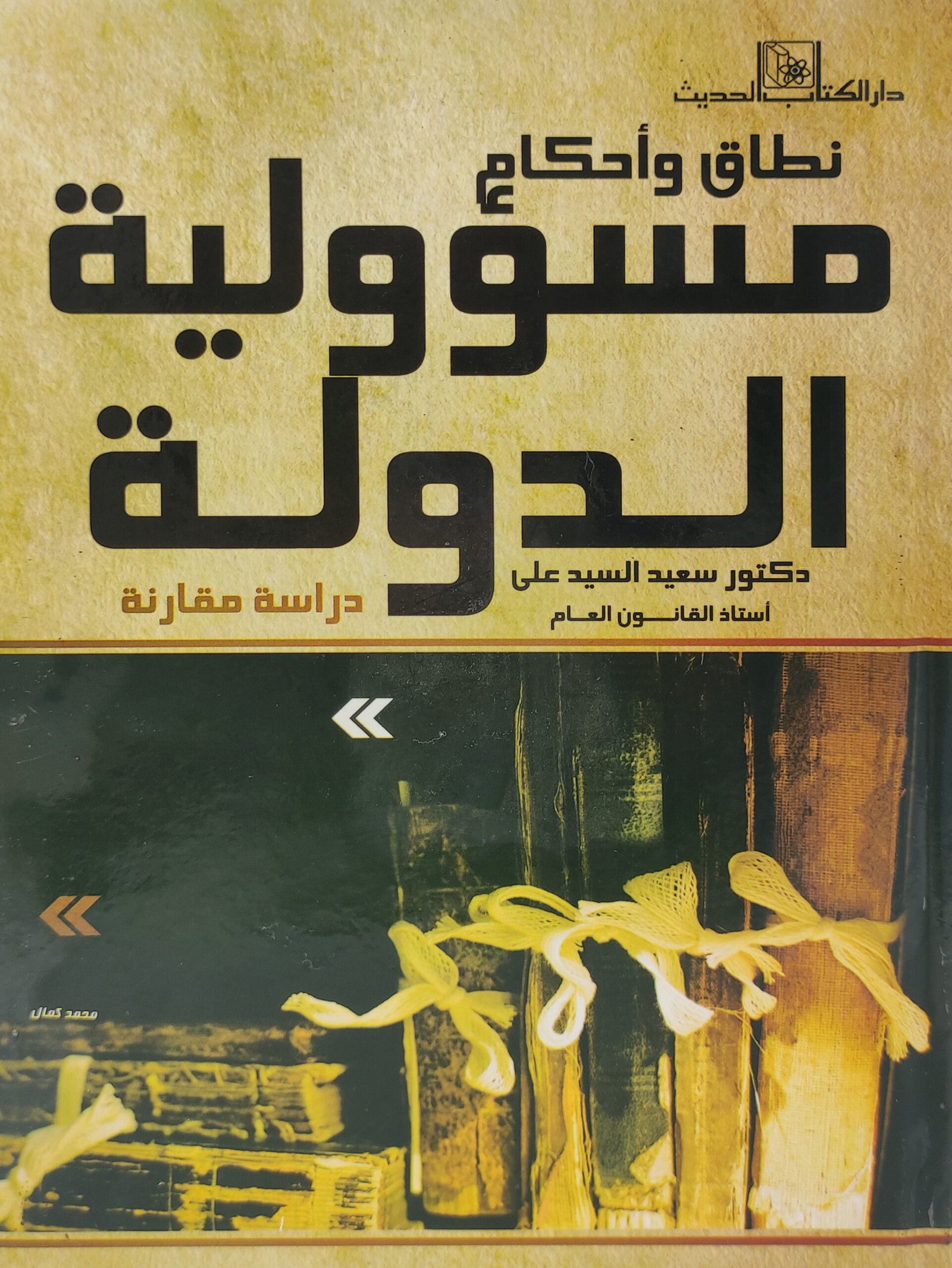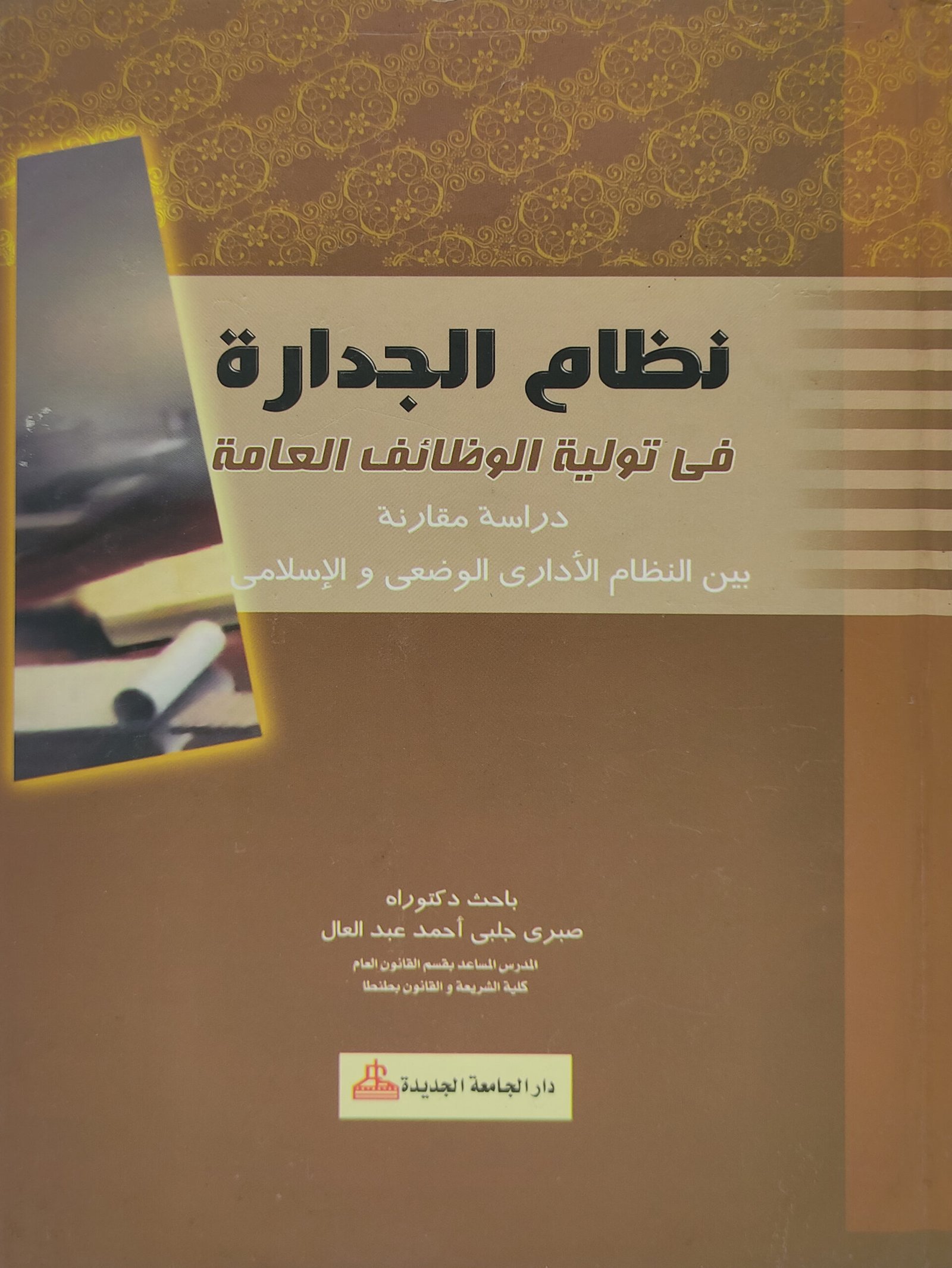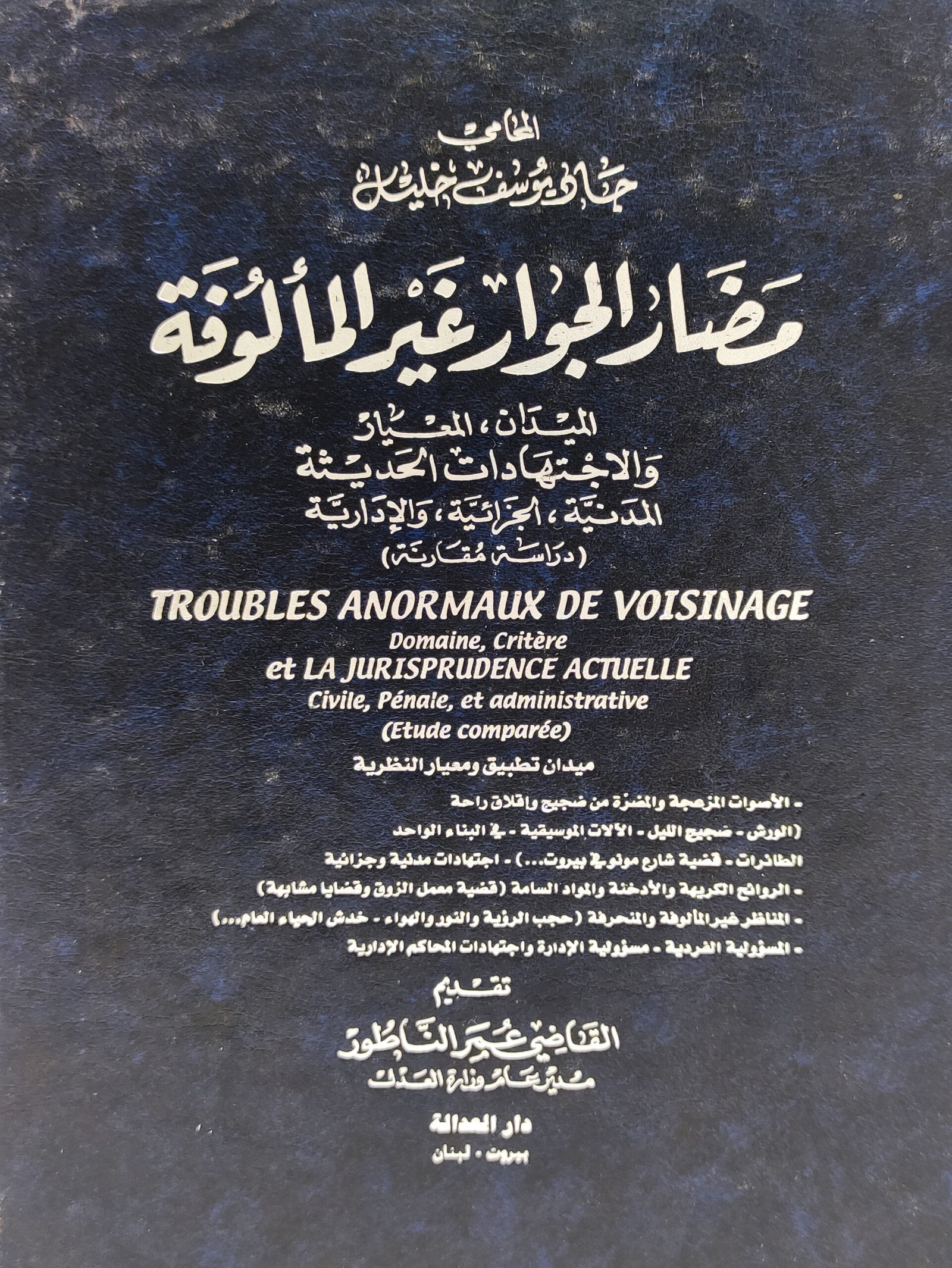
مضار الجوار غير المألوفة
عدد الصفحات : 512 صفحة
“مضار الجوار غير المألوفة، الميدان، المعيار، والإجتهادات اللبنانية والفرنسية الحديثة، المدنية، الجزائية، والإدارية”، هذا هو عنوان البحث والتأليف الذي نقدم، والذي تناول فيه المؤلف الكاتب والمحامي جاد يوسف خليل كافة المواضيع المتعلقة بجميع أصعدها، عارضاً إياها بشكل مسهب، مفصّل ودقيق، بالرغم من إفتقارها على صعيد الفقه اللبناني.
وأكثر ما يلفت القارئ في هذا المجال، السلاسة والسهولة التي ينساب بهما المؤلف في عرض بحثه الذي يعتبر من الأبحاث الدقيقة والصعبة والحديثة، وإن الفهرس المفصّل والكبير هو خير دليل على التقنية العلمية التي اعتمدها في طرحه للموضوع من الوجهة ليست فقط القانونية وحسب، لا بل من الوجهة الإنسانية والإجتماعية والصحية.
في بادئ الأمر، يتعجب القارئ عن عنوان البحث الراهن ويستغرب رجل القانون من عدم ورود هذه التسمية في الأحكام والقوانين المرعية الإجراء.
ولكنه وبعد قراءة هذا البحث، يستدرك أنّ أضرار الجوار غير المألوفة يعيشها ويعاني منها بصورة يومية ومستديمة في أي زمان وأي مكان، ابتداء من جاره شاغل الشقة المقابلة لشقته في نفس الطابق في بناء واحد، مروراً بالأضرار المنبعثة من جاره صاحب الميني ماركت أو الفرن أو النجار في الحي الواحد… إلخ وصولاً إلى مجال أوسع أحياناً بين منطقة سكنية مجاورة لمطار دولي.
فيحملنا المؤلف إلى أعماق المشكلة التي يعاني منها كل فرد من أفراد المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم ألا وهي علاقة الجار بجاره والجار بجواره، ومدى وجوب الإحترام المتبادل بين الجيران وعدم مجاوزة ما يعرف بموجبات الجوار، بدءاً في البناء الواحد وصولاً إلى أقصى الحدود جغرافياً بين الأرض والفضاء حيث نشأت النزاعات القضائية وترسخت الفكرة في ذهن المحاكم منذ القرن التاسع عشر في فرنسا بالإجتهاد الشهير المعروف: Arrêt Clément/ Bayard” “sur la mongolfière et les piquets حول المنطاد والعواميد، وصولاً إلى الإجتهادات الحديثة التي استحصل عليها المؤلف من اجتهادات محاكم غير منشورة، ونادرة المنال، والتي تناولت مضار الجوار غير المألوفة البيئية والتجميلية Dommage” “esthétique et environnemental
من الصعب أن نوجز أهم ما جاء في هذا التأليف، وأن نختصر مضمونه في بضعة أسطر نظراً لحجم المواضيع التي تناولها بمعلومات مفيدة وشروحات وتحاليل وافية مع مجسمات مقارنة Tableaux Comparatifs بين جميع أنواع الأضرار.
وقد تناول المؤلف من أهم النقاط القانونية، ذلك في البابين الأول والثاني ألا وهي “إستقلالية مضار الجوار غير المألوفة” بحد ذاتها “L’autonomie des troubles anormaux de voisinage ” من حيث ميدان التطبيق، والمعايير المتبعة وقد اعتمد بموجبه على المقارنة بين قوانين البلاد العربية والأجنبية بهذا الصدد، والإستخلاص من كل بلد على جزء من أحكامه بغية ترسيخها جميعاً في مشروع قانون لبناني يمكن تسميته “قانون الجوار اللبناني” Code Libanais de voisinage حيث آن الأوان على أن يُعرض على السلطة التشريعية لإقراره.
وبعد البحث في النظريات والميادين والمعايير، عرض المؤلف ابتداء من الباب الثالث على إجتهادات المحاكم التطبيقية – ومعظمها غير منشورة – وقد شملت على أوسع ما يمكن جمعه في هذا المجال من إجتهادات لبنانية من قصور العدل في معظم المناطق اللبنانية وبشتى درجاتها، وأيضاً الفرنسية منها ومن أحدثها ولم تقتصر فقط على المدنية منها بل الجزائية الصادرة عن المحاكم الجزائية على إختلاف أنواعها، كما عن المحاكم الإدارية العادية والصادرة عن مجلس شورى الدولة حيث ألقى المؤلف أيضاً الضوء على مسؤولية الدولة تجاه مضار الجوار غير المألوفة.
وتناولت تلك الإجتهادات الواسعة والمتنوعة والشاملة الأصوات المزعجة والمضرة من ضجيج وإقلاق الراحة الناتجة عن الورش والضجيج في الليل والآلات الموسيقية، في البناء الواحد، الطائرات، وأيضاً قرارات المحاكم اللبنانية التي أقفلت بعض المطاعم والملاهي الليلية في شارع مونو السياحي في مدينة بيروت وختمها بالشمع الأحمر.
وأورد المؤلف أيضاً الإجتهادات العديدة المتعلقة بالأضرار غير المألوفة الناتجة عن الروائح الكريهة والأدخنة والمواد السامة وتحدث عن المعمل الحراري في منطقة الزوق في كسروان ومدى تحريك مسؤولية الجوار بشكل عام وسبل المعالجة. كما تطرق إلى الإجتهادات المرتبطة بالمناظر غير المألوفة والمنحرفة من حجب الرؤية والنور والهواء، وخدش الحياء العالم.
بعد ذلك، تناول المؤلف في الباب الرابع من بحثه المسؤولية الفردية ومقدار التعويضات الناجمة عن مضار الجوار غير المألوفة وكيفية تقديم دعوى التعويض وشروطها.
وفي الباب الخامس ألقى الضوء على أمر مهم أيضاً وهي مسؤولية الإدارة في القانون اللبناني والفرنسي واجتهادات المحاكم الإدارية اللبنانية والفرنسية.

مظاهر سلطات الإدارة في عقد البناء والتشغيل والتحويل (B.O.T) دراسة مقارنة
عدد الصفحات : 464 صفحة

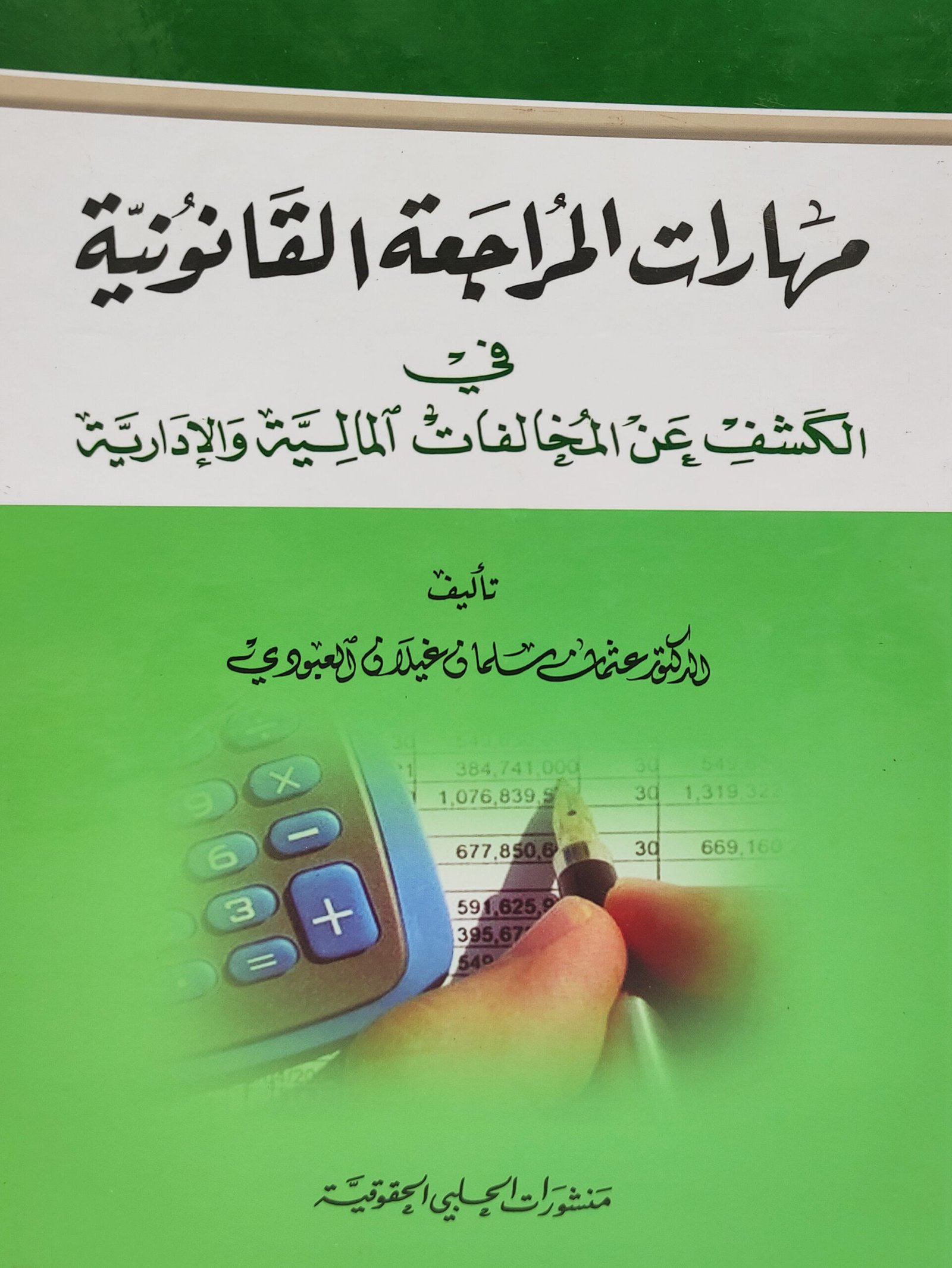
مهارات المراجعة القانونية “في الكشف عن المخالفات المالية والإدارية”
عدد الصفحات : 272 صفحة
يهدف هذا الكتاب إلى تسليط الضوء على خصوصية المراجعة القانونية وتأصيلها وتوضيح أجراءاتها ومهارات تنفيذها وتقويم نتائجها ووضع إجراءات محددة للمراجعة القانونية بما يسهم في الكشف عن الأخطاء القانونية والمخالفات والغش والأحتيال الذي قد يرافق الأعمال التي تنفذها دوائر الدولة ومؤسساتها العامة، كما تفترض هذه الدراسة إستقلالية المراجعة القانونية وخصوصيتها من حيث الوسائل والأفكار وتمييَزها عن صور المراجعة الأخرى مما يتطلب تفصيل مبادئها وأصولها من خلال الجهات الرقابية بغية الكشف عن المخالفات والغش والإحتيال الذي قد يرافق الأعمال التي ينجزها موظفو الإدارة لا سيما تلك المتعلقة بالجوانب المالية والإدارية، كما تسلم هذه الدراسة بحتمية مسؤولية جهات المراجعة عن فحص الأعمال القانونية عن طريق مراجعة تفاصيلها من سجلات ووثائق تمهيداً لتحديد الموظف المسؤول عن الأخطاء، أو الغش المرافق لها، وبالمثل أيضاً، تؤكد مسؤولية جهات المراجعة القانونية وواجباتها في بذل العناية المهنية المعتادة والواجية لإنجاز عملية المراجعة بطريقة سليمة ضمن أصول واعراف وسياقات تؤكدها المعايير الدولية ضمن برامج مصممة لهذا الغرض.
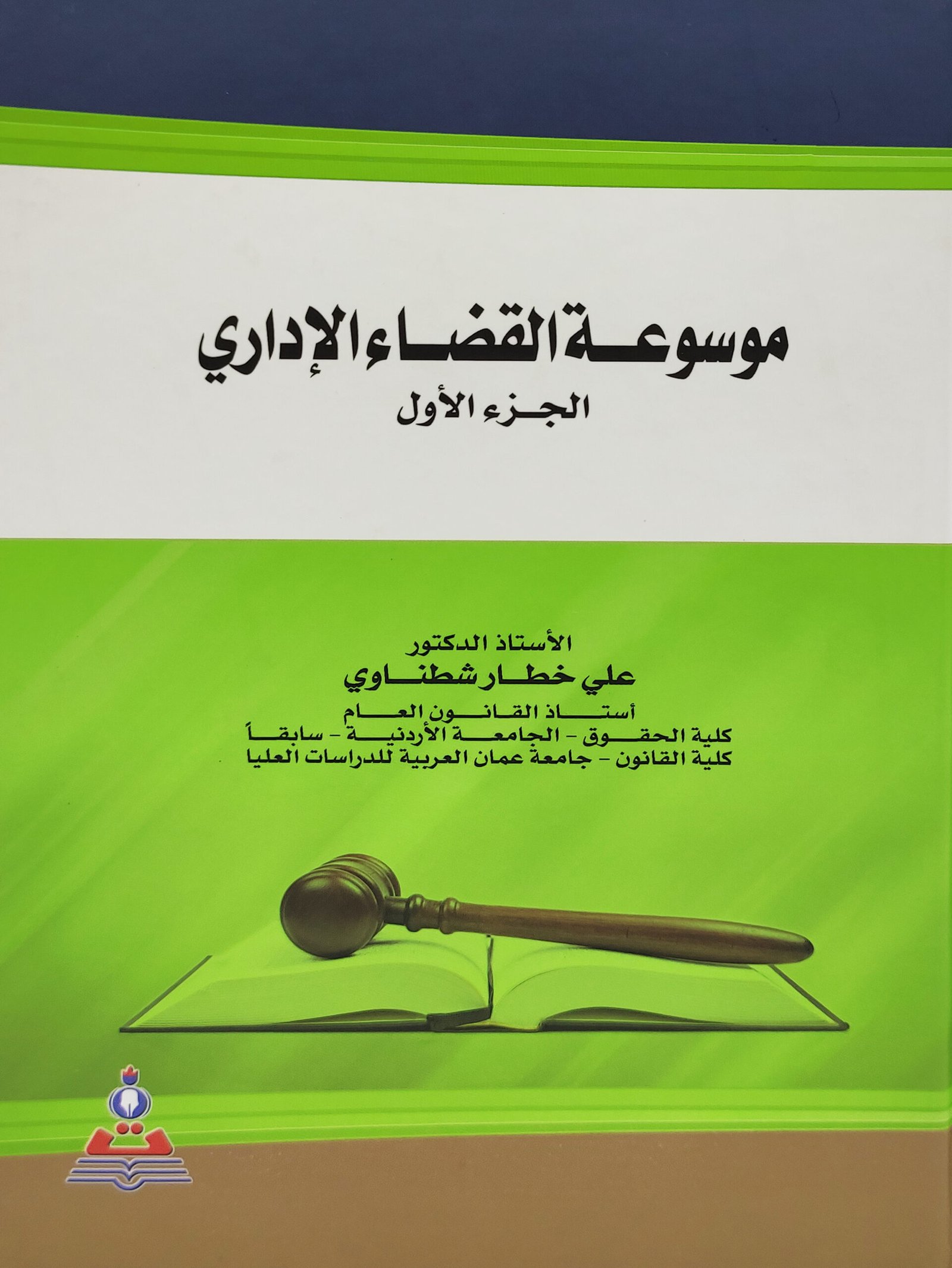
موسوعة القضاء الإداري الجزء الأول
عدد الصفحات : 512 صفحة
تبين من عنوان الكتاب انه يبحث في امور القضاء وتحديدا في القضاء الاداري، حيث يبدأ بيان مبدأ الفصل بين السلطات، مع التنويه الى مصادر مبدأ المشروعية ومنها المصادر المكتوبة والمصادر غير المكتوبة، كما يبحث في اركان العرف الاداري، ثم يتناول النظريات الموازاية لمبدأ المشروعية، ويتطرق إلى الأسس العامة،لراقابة أعمال الادارة العامة،مبينا جزاء الإخلال ومخالفة مبدأ المشروعية معرجا على الرقابة السياسية والرقابة الادارية، والرقابة القضائية، فيبحث في نظام القضاء الموحد ونظام القضاء المزدوج، كما يدرس نشأة القضاء الاداري في فرنسا وتنظيمه وكذلك نشأة القضاء الاداري الاردني وتنظيمه، كما يعطي جانبا من الاهمية لموضوع الحكم في دعوى الالغاء، حيث يوضح إجراءات التقاضي الادارية مبرزا خصائصها، وكيفية سير إجراءات الخصومة، ثم يشير إلى انقضاء الخصومة بغير حكم ومتى تعد الدعوى منتهيه، بعد ذلك ينتقل لبيان إجراءات سحب القرار المطعون به، وطرق إسقاط الدعوى، والتنازل عنها موضحا المصود بذلك ومنوها الى شروط التنازل وانواعه ثم آثاره، إضافة لذلك فهو يبحث في كيفية إثبات عدم مشروعية القرار المطعون به، حيث يبين صعوبة هذا الاثبات ودور القضاء في ذلك مع الاشارة الى أسباب تلك الصعوبة .
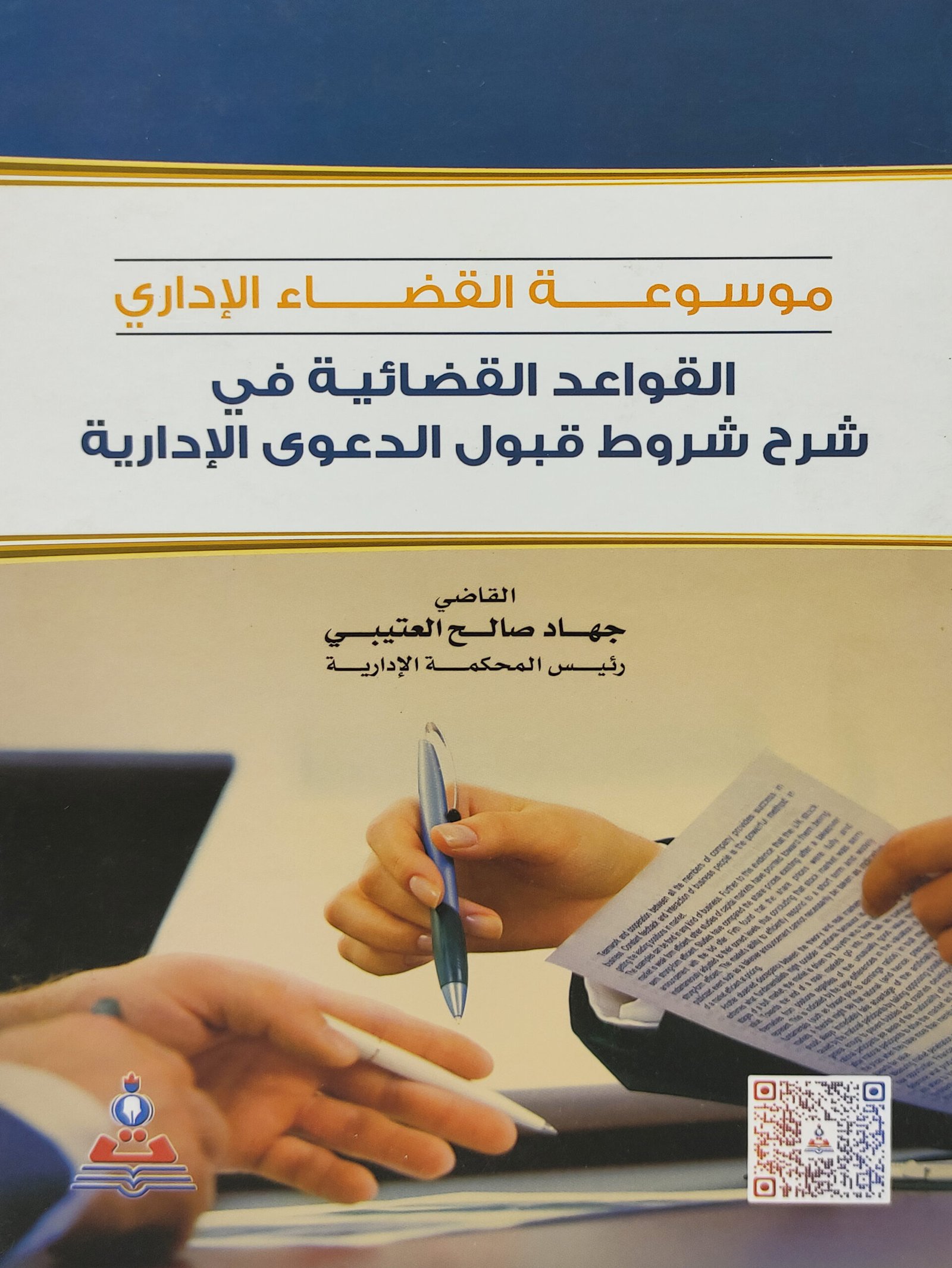
موسوعة القضاء الإداري القواعد القضائية في شرح قبول الدعوى الإدارية
عدد الصفحات : 648 صفحة
الحمد لله حمداً كثيراً طيباً فيه، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثتيت على نفسك، خلقت فأبدعت، وأعطيت فأفضت، فلا حصر لنعمك، ولا حدود لفضلك، ونصلي ونسلم على أشرف عبادك، وأكمل خلقك، خاتم المرسلين، ومعلم المعلمين، نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله الأمين، خير من علم، وأفضل من نصح. وبعد،،، جاءت فكرة هذه الموسوعة أثناء عملي في محكمة العدل العليا، وخلال هذه الفترة وسير الدعوى الإدارية أمامها، وجدت الكثيرين يخلطون في الإجراءات والأصول القانونية بين المحاكم المدنية، والمحاكم الإدارية مما يكون في كثير من الأوقات سبباً في عدم قبول الدعوى شكلاً، وبدلاً من البحث عن أوجه القصور التي أدت للرد الشكلي، للاستفادة منها مستقبلاً، وجدت البعض يصرف وقته للتندر على محكمة العدل العليا بإطلاق اسم محكمة الرد العليا عليها، وسرت هذه التسمية بين المحامين لدرجة أن كل من يخسر قضية أصبح يردد هذا الاسم لإلقاء اللوم على المحكمة وقضاتها، ومع أنني لا أتفق مع الكثيرين في هذه التسمية الظالمة للمحكمة وقضاتها، رأيت أن أساهم وأدلي بدلوي في هذا المعترك المحفوف بالمخاطر التي ذكرتها، بأن أضع هذه الموسوعة التي تبين القواعد القضائية التي نهجتها محكمة العدل العليا خلال مسيرتها منذ دستور 1952 وحتى هذا العام 2014 الذي شهد إصدار قانون القضاء الإداري رقم (27) لعام 2014 والذي أهم ما جاء فيه إلغاء قانون محكمة العدل العليا لعام 1992 واستحداث قضاء إداري على درجتين بعد أن كان على درجة واحدة. وأضفت إلى هذه القواعد، قواعد القضاء الإداري المصري، لتكون جميعها مرشداً ودليلاً لكل من يريد البحث والدراسة ومتابعة القضايا الإدارية. ومع أنني وجدت أن أحكام القضاء الإداري المشار إليها هي الوسيلة العملية للشرح، أبين القواعد العامة الإدارية بأن القرار الإداري يعتبر صحيحاً إلى أن يتم إثبات العكس، بمعنى أن عبء اثبات عيب القرار الإداري يقع على الطاعن، ومن ناحية أخرى أن القضاء الإداري هو قضاء منشئ للقواعد الإدارية، وقواعده مستقاة مما استقرت عليه المحاكم الإدارية، بالإضافة إلى أن القاضي الإداري هو المهيمن على الإجراءات بما ينسجم وواقع القضاء الإداري. وقد اعتبر الفقه الإداري أن الدعوى الإدارية هي التي تكون الإدارة العامة أو الهيئات العامة الأخرى التي تضطلع بمهام تسيير مرفق عام طرفاً في النزاع وفقاً للمعيار الموضوعي. وتعرف الدعوى الإدارية على أنها: وسيلة صاحب المصلحة باللجوء إلى السلطة القضائية لحماية حقه . وكباقي أنواع الدعاوي القضائية تتشكل الدعوى الإدارية من شقين: شق شكلي وآخر موضوعي، ولكي يتسنى للقاضي الإداري التطرق للدعوى الإدارية في جانبها الموضوعي والتأكد من مدى وقوع اعتداء من عدمه على الحق الموضوعي، والنظر في إمكانية منح الحماية القضائية لهذا الحق الذي وقع اعتداء عليه من جهة إدارية، يجب عليه البت في شقها الشكلي أولاً. وينقسم الشق الشكلي إلى شروط إجرائية والتي يترتب على مخالفتها القضاء ببطلان الإجراءات، وشروط القبول والتي يترتب على مخالفتها القضاء بعدم قبول الدعوى، وهذا ما يهمنا في دراستنا الحالية. وما يزيد أهمية هذا الموضوع هو صدور قانون القضاء الإداري رقم (27) لسنة 2014 الذي أورد أحكاماً خاصة بالدعوى الإدارية ولا سيما شروط قبولها، رغم أنها ليست بجديدة كون قانون محكمة العدل العليا رقم (12) لسنة 1992 وتعديلاته كان قد نص عليها، لكن تظهر أهمية هذا الموضوع باعتبار القانون الجديد يتناول أحكاماً جديدة تخص الدعوى الإدارية، وهذا ما يجبرنا كقضاة ومحامين التطرق لهذه الأحكام وذلك فيما يخص شروط قبول الدعوى الإدارية في ظل هذا القانون. وعلى ذلك فهذه الدراسة تثير إشكالية أساسية تتعلق بشروط قبول الدعوى الإدارية في ظل القانون؟ وجزاء مخالفة هذه الشروط؟ ومدى تعلق هذه الشروط بالنظام العام من عدمها؟ وعندما تعرض الدعوى الإدارية فإن على القاضي أن يسأل نفسه الأسئلة التقليدية الثلاثة التالية على التوالي: 1- هل هو مختص بنظرها؟ 2- هل تتوافر شروط القبول فيها؟ 3- هل المدعي محق في ادعائه؟ وما يهمنا في هذا الكتاب هو الإجابة على السؤال الثاني المتعلق بشروط قبول الدعوى، وهي الشروط التي يجب توافرها ابتداء في الدعوى حتى يتمكن القاضي من الفصل في موضوعها، فإذا لم تتوافر هذه الشروط وجب أن يقضي بعدم قبول الدعوى، أي ردها شكلاً دون مناقشة موضوعها.