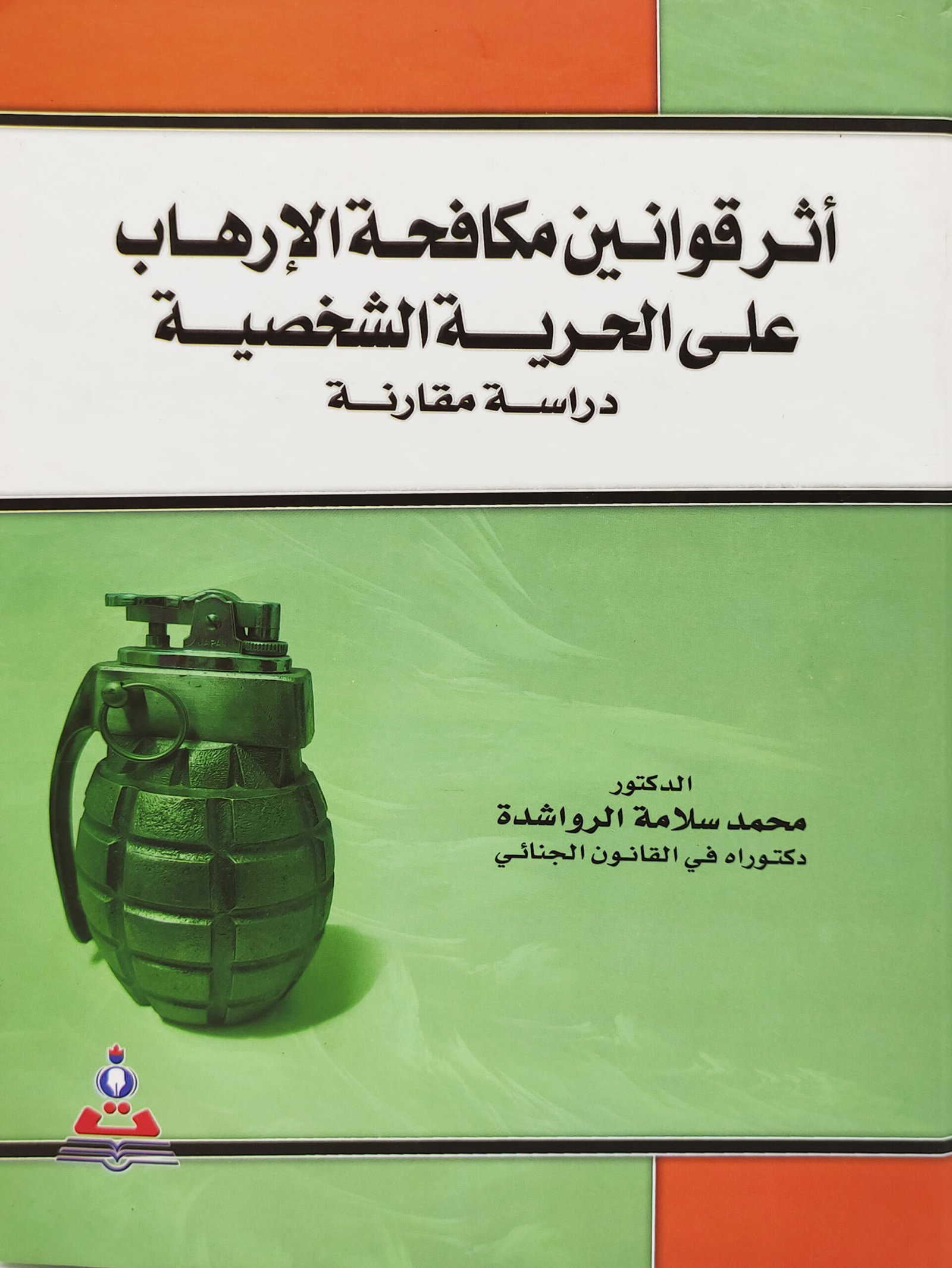
أثر قوانين مكافحة الإرهاب على الحرية الشخصية
عدد الصفحات : 256 صفحة
لقد هدفت هذه الدراسة إلى إبراز أثر القوانين الجزائية لمكافحة الإرهاب على الحرية الشخصية، في كل من التشريعات الجزائية محل المقارنة (الأردن ومصر وبريطانيا). وظهر هذا الأثر، جلياً، في تشريعات تلك الدول، نتيجة تشدد سياستها التشريعية، وخاصة الإجرائية في مكافحة الجرائم الإرهابية، واتفقت تلك الدول في جوهر سياسة التشدد، إلا أنها اختلفت في الإجراءات المتبعة. وقد قسم الباحث هذا الموضوع إلى الآتي: الفصل الأول: احتوى على المقدمة، ومشكلة الدراسة، وعناصرها، وأهمية الدراسة ومحدداتها، ومنهجية البحث المستخدم. الفصل الثاني: تحدث فيه الباحث عن تطور مفهوم جرائم الإرهاب وأثر ذلك على الحرية الشخصية، وعرض من خلاله للمفهوم الفقهي لجرائم الإرهاب، ثم لمفهوم الإرهاب في المواثيق الدولية، والتشريعات الجزائية، ولضرورة التوازن بين مكافحة الإرهاب، والحرية الشخصية. الفصل الثالث: بيّن فيه الباحث السياسة الإجرائية لمواجهة الإرهاب، عن طريق بيان القواعد الإجرائية لمواجهة الإرهاب في مرحلة جمع الاستدلال، وكذلك سياسة مواجهة الإرهاب في مرحلة التحقيق في التشريعات الجزائية، محل هذه الدراسة المقارنة. الفصل الرابع: خصصه الباحث للحديث عن ضمانات الحرية الشخصية في مواجهة إجراءات مكافحة الإرهاب، وقسمه إلى موضوعين رئيسين: الأول: عرض من خلاله مظاهر الاعتداء على الحرية الشخصية، في ظل إجراءات مكافحة الإرهاب سواءً على المستوى الدولي، أم على المستوى الداخلي، بالنسبة للدول محل هذه الدراسة. الثاني: تحدث فيه عن ضمانات الحرية الشخصية في مواجهة إجراءات مكافحة الإرهاب، وخاصة تلك الإجراءات التي تمس الحرية الشخصية بشكل مباشر، وبالتالي يجب التمسك بتلك الضمانات كالحق في السلامة البدنية والذهنية، والحق في الأمن الشخصي وحرية التنقل، والحق في حماية الحياة الخاصة للمتهم بارتكاب جرائم إرهابية. الفصل الخامس: تناول الباحث من خلاله مرحلة المحاكمة عن الجرائم الإرهابية، وفي هذا الإطار أظهر النظام القضائي الخاص بالنظر في جرائم الإرهاب، في: بريطانيا، ومصر، والأردن، وكيفية اختلاف هذا النظام عن نظام المحاكمة عن الجرائم العادية، ومن ثم ركز هذا الفصل على ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة عن جرائم الإرهاب، وبحق المتهم في المثول أمام قاضيه الطبيعي، وحقه في الحصول على محاكمة عادلة بكل ما يشمله معنى المحاكمة العادلة من عناصر. الفصل السادس: تضمن الخاتمة ونتائج الدراسة والتوصيات.
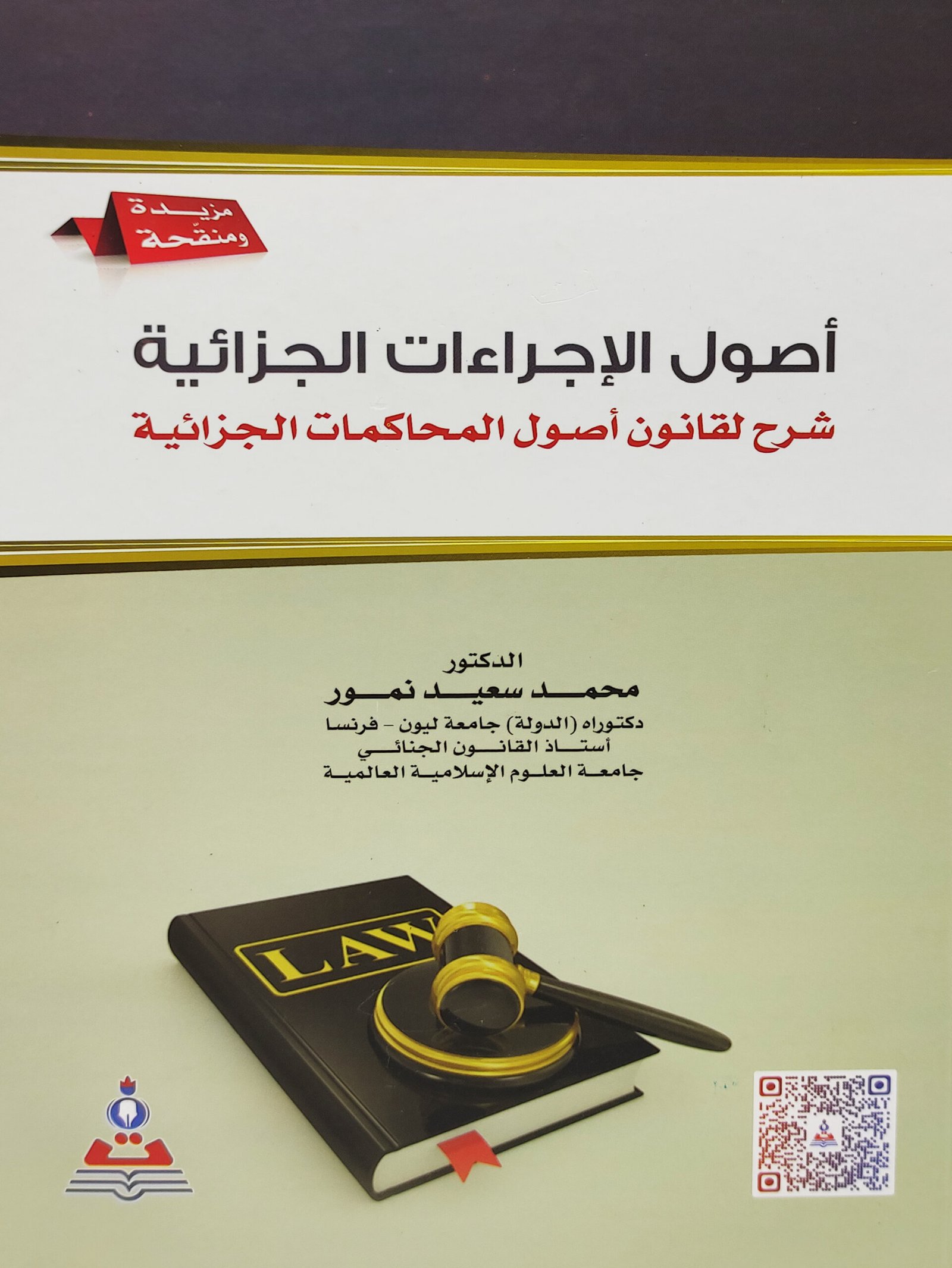
أصول الإجراءات الجزائية شرح لقانون أصول المحاكمات الجزائية
عدد الصفحات : 710 صفحة
يعد قانون اصول المحاكمات الجزائية من اهم القوانين التي تنظم الحرية الشخصية وهو قانون ذو طابع خاص فهو يؤكد على حماية المصالح الحقيقية للفرد والجماعة . لذلك جاء الكتاب شارحا وممحصا لقانون اصول المحاكمات الجزائية في عدة فصول تناولت المبادئ الاساسية في قانون اصول المحاكمات الجزائية والدعاوي الناشئة عن ارتكاب الجريمة والتحقيق في الدعوى الجزائية والاحكام الجزائية وطرق الطعن منها متناولا في ثنايا هذه الموضوعات الكثير من الأمور المتعلقة بها .
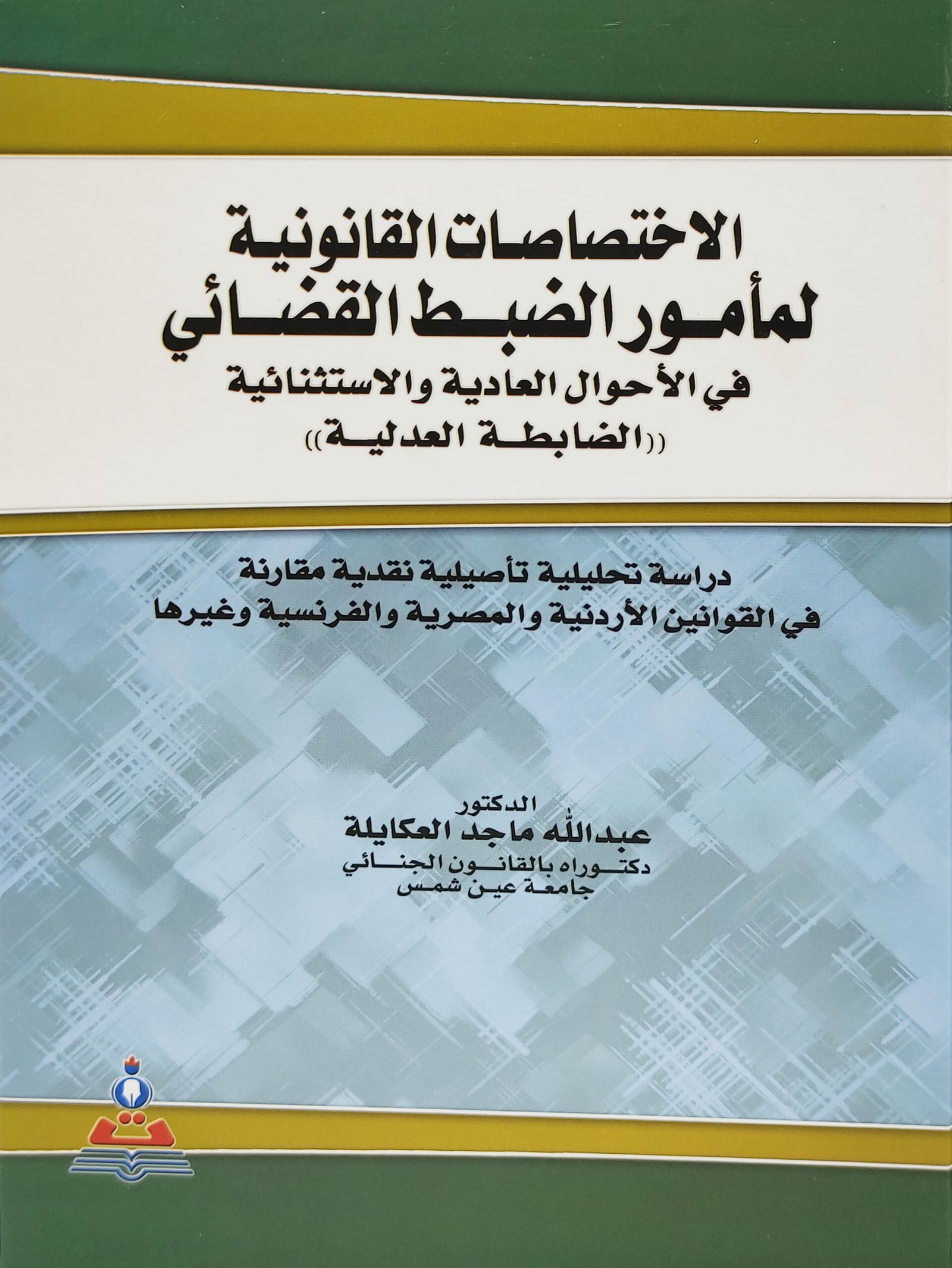
الإختصاصات القانونية لمأمور الضبط القضائي في الأحوال العادية والإستثنائية الضابطة العدلية دراسة تحليلية تأصيلية نقدية مقارنة في القوانين الأردنية والمصرية والفرنسية وغيرها
عدد الصفحات : 576 صفحة
إن التنفيذ القضائي الحديث لم يقتصر أو بالأحرى لم يقف عند حد بيان جهات الحكم، وكيفية إيقاع الجزاء، بل أوجد على عاتقه مجموعة من القواعد القانونية التي تهتم بسير الإجراءات من لحظة وقوع الجريمة حتى صدور حكم بات فيها. آخذاً بعين الإعتبار التحديد الدقيق والسليم للواقعة، ومدى إنطباقها على النص التجريمي وتحديد من صدرت عنه الأفعال المجرمة تحديداً دقيقاً نافياً للجهالة.
إلا أن المحكمة أو بالأخص القاضي بمفرده لا يستطيع القيام بهذه المهام الكثيرة والمعقدة، فمن أجل ذلك وجد إلى جانبه عدد كبير من الرجال الذين يساعدونه في كشف الحقيقة من الواقعة ومرتكبها وذلك للقيام بأدوار مباشرة وغير مباشرة في المراحل التي تمر بها كيفية تنفيذ الجزاء، وظهر من بين هؤلاء المساعدين بل وأهمها (رجال الضبط القضائي، وخاصةً أعضاء هيئة الشرطة).
فنشاط هذه الأخيرة (هيئة الشرطة) قد تغلغل في كافة ميادين الحياة، فضلاً عن أن رجال الشرطة أنفسهم بشر غير معصومين عن الخطأ، وحولهم من أسباب الغرور والإعتداد بالسلطة ما يسهل إنزلاقهم إلى الإعتساف والجور على الحقوق.
وترتيباً على ما سبق فقد حرص المشرع الإجرائي الأردني والمصري وغيره الكثير من مشرعي الدول العربية والأجنبية، على تحديد نطاق إختصاص كل من سلطة الضبط القضائي وسلطة التحقيق، وذلك لإستقرار النظام القانوني وتحقيق التوازن الإجتماعي بين الأفراد والسلطة الحاكمة، وحظر على سلطة الضبط القضائي تجاوز حدود ما أنيط بها من إختصاصات قانونية، مستهدفاً من ذلك حماية الحريات العامة، والتي بسط عليها الدستور والقانون حمايتهما، فكان مناط هذه الدراسة يدور حول إبراز حدود السلطة المخولة لرجال الضبطية القضائية سواءً بصفة أصلية أو بصفة إستثنائية، حتى لا يقوم ثمة خلط أو لبس يمكن أن يثور بين الإختصاص المنوط بهم والإختصاص المخول لأي سلطة عامة أخرى، وذلك حتى تنأى أعمالهم عن مواطن البطلان، ويمكن لسلطة الحكم التعويل على الأدلة التي تولدت عن إجراءاتهم عند قضائها بالإدانة.
وعليه، فقد تناول هذا المؤلف بيان الإختصاصات القانونية لمأموري الضبط القضائي في الأحوال العادية والإستثنائية، على أن يبين لأهمية مرحلة جمع الإستدلالات في بناء الدعوى الجنائية لكونها مرحلة هامةً، إذ إن الشرارة الجنائية الأولى تبدأ من حيث العمل بها.
وعليه، ستكون الدراسة مقسمة إلى الأبواب الآتية: الباب الأول: الضبطية في القانون، الباب الثاني: الإختصاص القضائي لمأمور الضبط في مرحلة جمع الإستدلالات، الباب الثالث: الإختصاص القضائي لمأمور الضبط في مرحلة التحقيق الإبتدائي.

الإستخدام غير المشروع لبطاقة الإئتمان المسؤولية الجزائية والمدنية
عدد الصفحات : 272 صفحة
تلعب البنوك والمؤسسات المالية الأخرى دوراً هاماً في بناء الإقتصاد الوطني والعالمي، حيث تحتل مكانة بارزة في الحياة الإقتصادية، وتساهم في تمويل المشاريع المختلفة، كما أنها تسهل على الأفراد حياتهم اليومية.
وأصبحت هذه البنوك والمؤسسات تقوم بدور هام في حياة الأفراد بحيث أصبح لا يمكن الإستغناء عنها وعما تقدمه من خدمات، خاصة فيما يتعلق بوسائل الدفع الحديثة والمتمثلة في بطاقات الإئتمان، والتي أصبحت أهم وأحدث وسيلة وفاء في المعاملات التجارية نتيجة للتعاون بين البنوك والعملاء والتجار لضمان المعاملات التجارية والوفاء.
وقد أدى هذا إلى جعل بطاقات الإئتمان تأخذ مكانتها بين وسائل الوفاء الحديثة، حيث تعتبر جزءاً من سلسلة التطور الإقتصادي والتكنولوجي في مجال المعاملات التجارية خاصة مجال وسائل الوفاء، وكأي وسيلة حديثة تتعلق بالمال وطرق الوفاء والإقتصاد بشكل عام تثور حولها التساؤلات حول مدى المساءلة القانونية في حال الإستخدام غير المشروع لهذه الوسيلة (بطاقة الإئتمان) من قبل حاملها الشرعي نفسه أو من قبل الغير.
ولأهمية هذا الموضوع قام المؤلف في هذه الرسالة ببيان أهمية وفائدة بطاقة الإئتمان وبيان أنواعها المختلفة وخصائصها التي تميزها عن غيرها من البطاقات، ثم تكلم عن الحقوق والإلتزامات المترتبة على بطاقة الإئتمان بإعتبار ذلك هو المدخل الصحيح لبيان الطبيعة القانونية لهذه البطاقة وعند بيان هذه الطبيعة القانونية، بين الإتجاهات المختلفة في هذا الشأن، والتي لم تسلم من النقد لأنها أرادت أن تضع هذا النظام في قالب من القوالب القانونية التقليدية، ثم تكلم عن المسؤولية القانونية في شقيها الجزائي والمدني التي يثيرها الإستخدام غير المشروع لهذه البطاقة من قبل حاملها ومن قبل الغير.
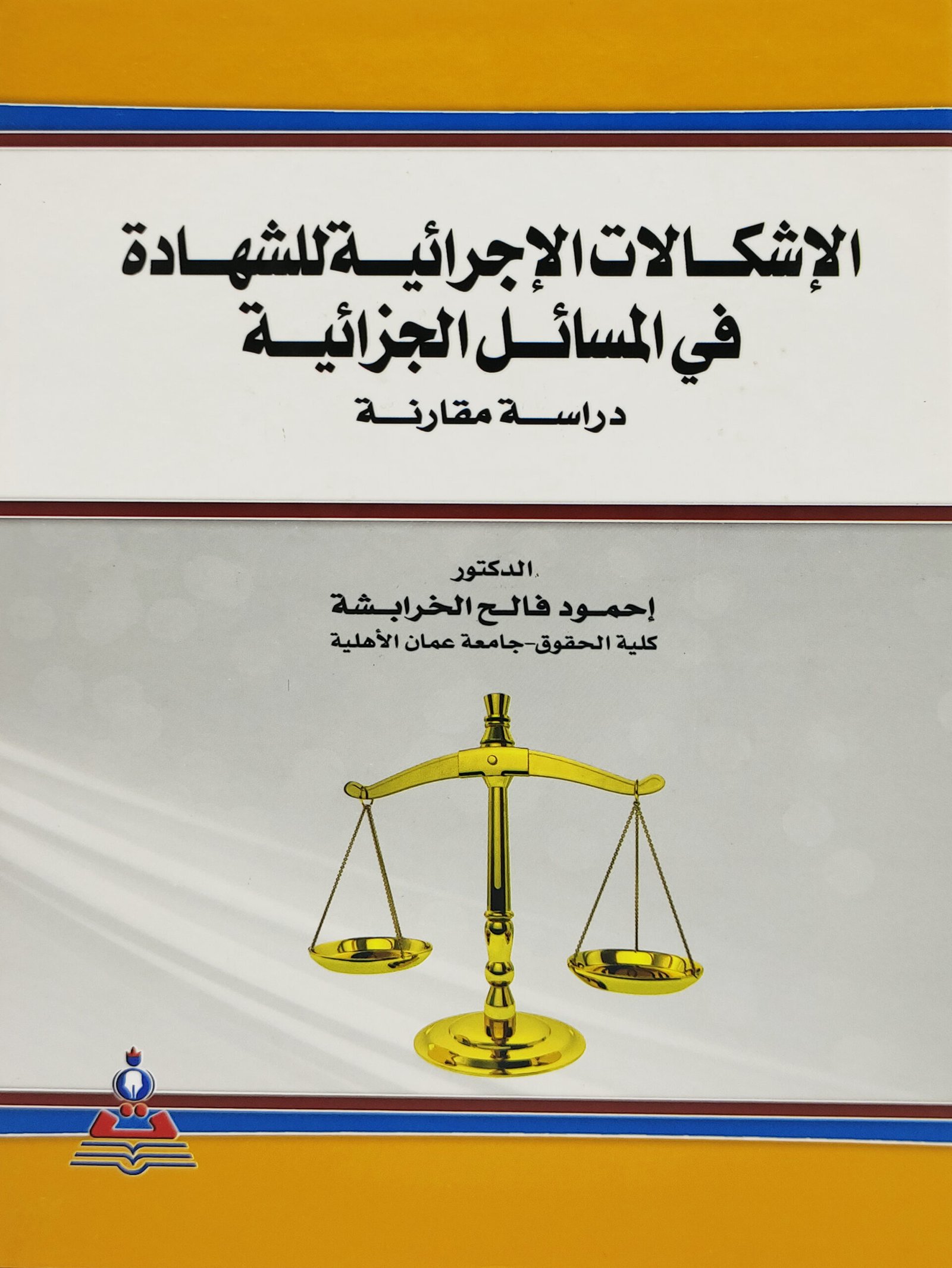
الإشكالات الإجرائية للشهادة في المسائل الجزائية دراسة مقارنة
عدد الصفحات :368 صفحة
تُعَدُّ الشهادة وبحق عماد الإثبات في المواد الجزائية، كونها تنصب في المعتاد على حوادث عابرة تقع فجأة، بحيث لا يسبقها تراضٍ أو اتفاق، فالجرائم ترتكب مخالفة للقانون ولا يتصور إثباتها وإقامة الدليل عليها مقدما، وإنما يعمل مرتكبوها على الهرب وإزالة كل ما يمكن أن تتركه من آثار، وذلك خلافا للمسائل المدنية التي تحصل غالبا بناء على اتفاق بين الخصوم يدرج في مح مكتوب، لذلك تعد الكتابة هي الطريق الأصلي للإثبات في المواد المدنية، بيد أن الشهادة لا غنى عنها كوسيلة إثبات في المواد الجزائية، على اعتبار أن الحوادث التي تصبح يوما ما أساسا للدعاوى لا سبيل لإثباتها دون الرجوع إلى ذاكرة الأشخاص الذين شهدوا وقوعها ليكونوا شهداء على الحادث. لذلك، كان للشهادة تلك الأهمية في الإثبات الجزائي، ولكن مع وجود هذه الأهمية لها كوسيلة إثبات، إلا انه يعتريها الكثير من الاشكالات والمعضلات التي تواجه القائمين على القضاء من الناحية العملية، وخاصة فيما يتعلق بسلطات الضابطة العدلية بسماع الشهود في مرحلة التحقيق الأولي “الاستدلال” وسلطات التحقيق الابتدائي والمحاكمة.

البحث الأولى أو الإستدلال في قانون أصول المحاكمات الجزائية دراسة مقارنة
عدد الصفحات : 336 صفحة
1 ــ المراحل الإجرائية: تقر غالبية التشريعات المقارنة بوجود ثلاث مراحل إجرائية عقب وقوع الجريمة: الأولى، مرحلة البحث الأولي، أو مرحلة جمع الاستدلالات، وهي مرحلة تسبق تحريك الدعوى الجزائية، وغايتها التحضير لتحريكها وتوضيح الوقائع لجهتي التحقيق الابتدائي والمحاكمة، ويقوم بإجراءاتها موظفو الضابطة العدلية، وتنتهي برفع محضر الضابطة العلية إلى النيابة العامة، فتقرر أحد أمرين: إما إصدار قرار بحفظ الأوراق، وإما تحريك الدعوى الجزائية مباشرة أمام المحكمة المختصة في الجرائم البسيطة أو بدء التحقيق الابتدائي في الجرائم الجسيمة. والثانية: مرحلة التحقيق الابتدائي، وتمثل المرحلة القضائية الأولى للدعوى الجزائية، وتقوم بإجراءاتها سلطة التحقيق المختصة، وترمي إلى أمرين: الأول، التنقيب عن الأدلة بالمفهوم القانوني وجمعها. والثاني، تقدير هذه الأدلة لغايات الترجيح بين تقرير لزوم المحاكمة والإحالة على قضاء الحكم، أو تقرير منع المحاكمة وتوقف الدعوى عند هذه المرحلة، فلا يطرح على قضاء الحكم غير التهم المرتكزة على أساس متين من الوقائع والقانون( ). والثالثة: مرحلة التحقيق النهائي أو المحاكمة، وهي المرحلة القضائية الثانية للدعوى الجزائية، يقوم بإجراءاتها قضاء الحكم، وترمي إلى أمرين: الأول، تقدير الأدلة، والثاني، الفصل في موضوع الدعوى الجزائية بتقرير الإدانة أو البراءة أو عدم المسؤولية. 2 ــ خطة الدراسة: تقتضي دراسة هذه المرحلة البحث في الأحكام العامة لمرحلة البحث الأولي (الفصل الأول)، وفي الوظائف التي تقوم بها الجهة التي خولها القانون سلطة القيام بإجراءات البحث الأولي (الفصل الثاني)، وفي النظرية العامة للجرم المشهود (الفصل الثالث)، وفي القبض (الفصل الرابع)، وفي دخول المساكن والأماكن دون مذكرة (الفصل الخامس)، وأخيراً في الإنابة للتحقيق (الفصل السادس).
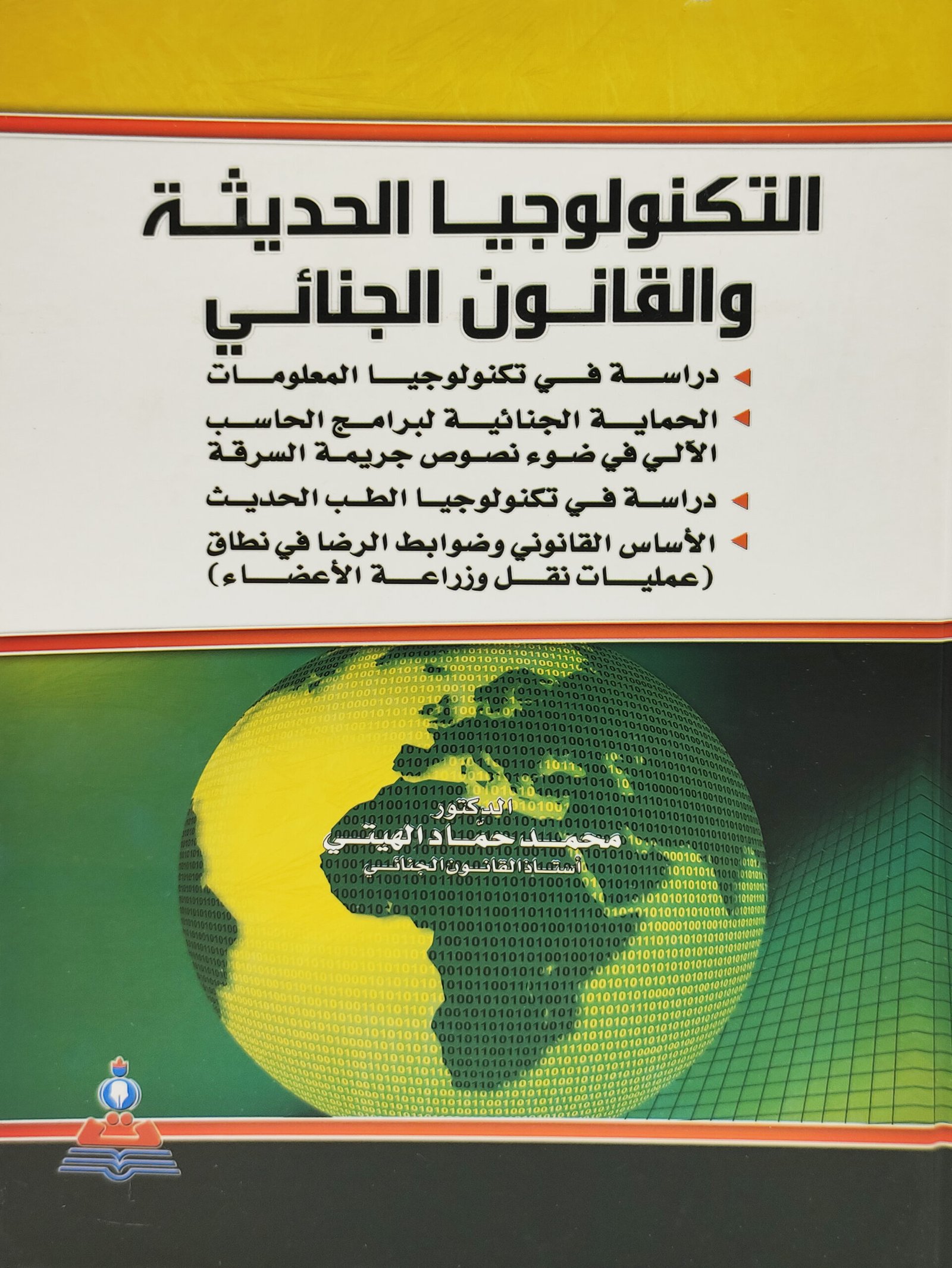
التكنولوجيا الحديثة والقانون الجنائي
عدد الصفحات : 264 صفحة
بعد أن تجاوز الطب دوره التقليدي في العلاج وأصبح أكثر فاعلية في علاج الأمراض المزمنة المستعصية وغدا قادراً على إنقاذ البشر من موت محقق بظهور وسائل طبيعة حديثة من بينها العلاج عن طريق زراعة الأعضاء، وبسبب أن استئصال العضو التالف أو المريض من جسد (المتلقي) أو (المستقبل) يتطلب إيجاد بديل له، وبسبب أن العضو البديل سيكون من جسم شخص آخر سليم معافى هو (المعطي) أو (الواهب) يقوم بالتنازل عن عضو من أعضائه لمصلحة الأول، أصبحت عمليات نقل وزراعة الأعضاء خطراً يهدد المجتمع، ذلك لأنها تخرج عن القواعد العامة في المجتمع التي تحمي حق الإنسان بالحياة وحقه في سلامة جسمه ذلك لأنها (أي تلك العمليات) تسمح بالاعتداء على سلامة جسم شخص سليم لا يعاني من علة مرضية، هو المعطي، لأن الحصول على الأعضاء السليمة التي ستتم زراعتها، الغالب فيها أن تكون من إنسان، وهذا ما يثير الكثير من المشاكل، ومنها ما هو الأساس القانوني الذي يتم الاستناد إليه لتبرير عمل الطبيب في استئصاله العضو السليم من جسد المعطي.
ومن جهة أخرى، فقط أصبحت عمليات نقل وزراعة الأعضاء تهدد أخلاقيات المجتمع بعد نجاح نقل (المني) أي عمليات التلقيح الصناعي، سواء بمني الزوج أو بمني غيره، أو نقل الدم بعد تغيير خصائصه، أو غيرهما… وأمام تزايد عمليات نقل وزراعة الأعضاء بعد نجاحها المذهل، وأمام الحاجة المتزايدة للأعضاء بعد هذا النجاح، ولعدم وجود تنظيم قانوني لمصدر الحصول على هذه الأعضاء برزت الكثير من الظواهر السلبية ومنها ظاهرة بيع الأعضاء، حيث ظهرت عصابات متخصصة يقوم بها سماسرة ومهربون على مستوى واسع وخطير.
ولما تقدم من أسباب، ومن أجل بيان جواز أو عدم جواز تصرف الإنسان ببعض أعضاء جسمه يأتي هذا الكتاب الذي يبين في قسمه الأول السند القانوني لكل ذلك، وكذلك يبين الكتاب الأساس القانوني لإباحة عمل الطبيب الذي يقوم بإجراء مثل تلك العمليات. وقد تمّ تخصيص الفصل الأول لبيان موقف الأساس القانوني لنقل الأعضاء البشرية بما في ذلك الأساس القانوني لإباحة عمل الطبيب في عملي نقل الأعضاء، والأساس القانوني لإباحة تصرف المعطي بعضو من أعضاء جسمه، فكلٌّ في مبحث مستقل. ومن ثم تناول المبحث الثالث موقف التشريعات من إباحة نقل الأعضاء وتحديد ضوابط لذلك. وانطلاقاً من استقلال عملية نقل الأعضاء من عملية زراعتها من حيث الأساس، ومن أجل تبصير المعطي وإحاطته علماً بحدود حقه بالتصرف بأعضاء جسمه ومداه بالنسبة للأعضاء التي يجوز له التصرف بها، ومن أجل تبصير الطبيب بضوابط وشروط إجراء مثل تلك العلميات، وجزاء مخالفته لها، بناء على ذلك كله ولأهميته تمّ البحث في الفصل الثاني من هذا الكتاب بقبول المعطي هبة عضو من أعضائه. ويعد هذا الموضوع خطيراً والبحث فيه هام وذلك بما يتيحه من معارف قانونية لما هو مباح وما هو محظور، وبما يعنيه ذلك الموقف الإنساني من معاني وبما يقدمه من مساعدات للآخرين هم على وشك الموت بسبب تلف عضو من أعضائهم.
وتجدر الإشارة إلى أنه تمّ في القسم الثاني من هذا الكتاب تناول موضوع هام آخر، يعتبر الاطلاع عليه ضرورة حتمية، وذلك لتأثيره المباشر على الحياة اليومية المعاصرة ألا وهو تكنولوجيا المعلومات والقانون الجنائي المتعلق به بما في ذلك الحماية الجنائية لبرامج الحاسب الآلي في ضوء نصوص جريمة السرقة.
يُلقي هذا الكتاب الضوء على الأساس القانوني وضوابط الرضى في نطاق عمليات نقل وزراعة الأعضاء والمشاكل التي تثيرها منها المشاكل الفنية في حالات رفض أو عدم تقبل الجسم المتلقي للعضو المزروع ونقص الأعضاء البديلة للأعضاء التي يتم استئصالها أما على صعيد المشاكل الاجتماعية فتمثّلت بظهور تجارة جديدة وهي تجارة الأعضاء البشرية حيث ظهرت عصابات متخصصة في حين كانت المشاكل الأخلاقية هي أن إباحة مثل هذا النوع يؤدي إلى انهيار قيمة الإنسان في المجتمع وتحوله إلى سلعة تباع وتشترى واستغلال تلك الإباحة من قبل الأغنياء تجاه الفقراء هذا بالإضافة أن إباحة هذه العمليات أصبحت تهدد الكثير من أخلاقيات المجتمعات لاسيما بعد نجاح عمليات نقل الخلايا الجنسية أي ما يسمى بالتلقيح الصناعي ويتناول في الفصل الأول أطراف عمليات نقل الأعضاء الواهب والطبيب وبناء على ذلك فإن المعطي سيكون إنسانا حيّاً وهو الغالب أو جثة لإنسان قد فارق الحياة ويشير إلى الأساس القانوني لإباحة نقل الأعضاء وهي حالة الضرورة ثم تبرير أو إباحة نقل الأعضاء على الأساس المصلحة الاجتماعية وما هو الأساس القانوني لتبرير تصرف المعطي لعضو من أعضائه وما هو الموقف التشريعي من تبرير وإباحة نقل الأعضاء ثم يذكر الضوابط لنقل الأعضاء من الأحياء في القانون المقارن كأن يكون العضو المراد نقله ليس من الأعضاء التي تتوقف عليها الحياة وبدون مقابل وان يكون المعطي كامل الأهلية وبناء على موافقته ورضاه الحر الصحيح ثم ينتقل إلى رضى المريض أو عدم رضاه في نطاق عمليات زراعة الأعضاء أو ما هي الحالات التي يتجاوز فيها رضى المريض ومدى ضرورة تبصير المريض في مجال زرع الأعضاء وما معنى تبصير المريض بالمخاطر المحتملة والمتوقعة.

التنفيذ الجزائي دراسة تحليلية تأصيلية
عدد الصفحات : 280 صفحة
تنفيذ الجزاء الجنائي هو وضع الحكم الجزائي الذي قضى بالجزاء موضع التنفيذ، وبذلك فإن مرحلة التنفيذ مرحلة تالية لمرحلة المحاكمة، وهي مرحلة لها أهميتها لكونها تنقل النصوص القانونية والأحكام القضائية إلى حيز الواقع العملي، ومن هنا تكمن خطورة هذه المرحلة، لكونها الميدان الذي يتحقق فيه غرض الجزاء الجنائي، وهذا بلا شك يتطلب أن تخضع عملية التنفيذ لمبدأ الشرعية، ولذلك واجه المشرع الإشكاليات المتعلقة بالتنفيذ من خلال دعوى الإشكال في التنفيذ. ومما لا شك فيه أن هذه الدراسة تجد أهميتها من الناحيتين النظرية والعملية، فالمكتبة القانونية في فلسطين بحاجة ماسة إلى مثل هذه الدراسة، ويمكن القول بأن هذه الدراسة ستكون أول دراسة متكاملة في تنفيذ الجزاءات الجنائية في التشريع الفلسطيني، كذلك تجد هذه الدراسة أهميتها من الناحية العملية، فهناك بعض الأخطاء التي تقع في ميدان العمل بعضها يرد إلى الخطأ في تفسير النصوص والبعض الآخر يرجع إلى عدم وجود تنظيم مفصل للموضوعات التي يثيرها التنفيذ.
