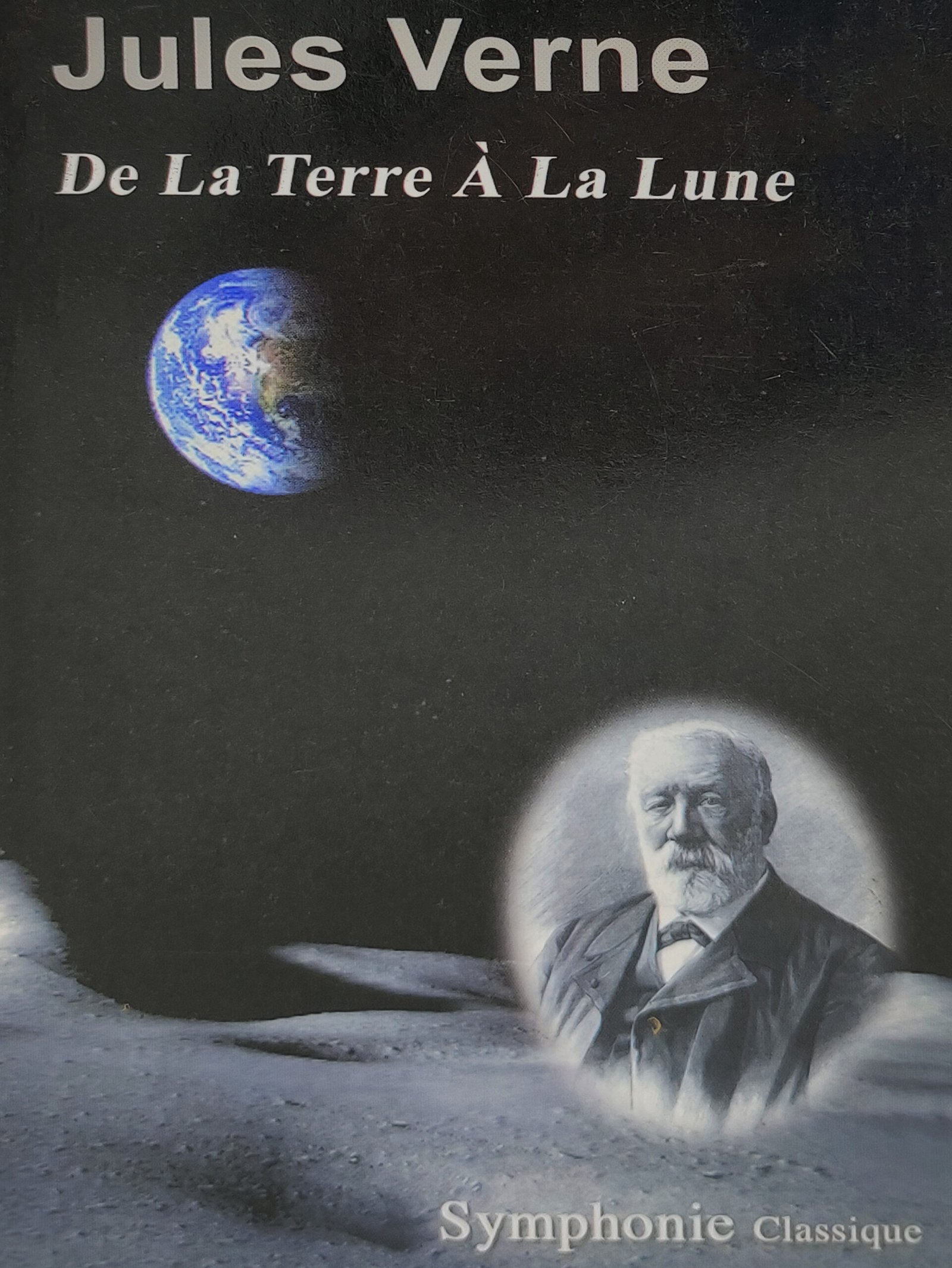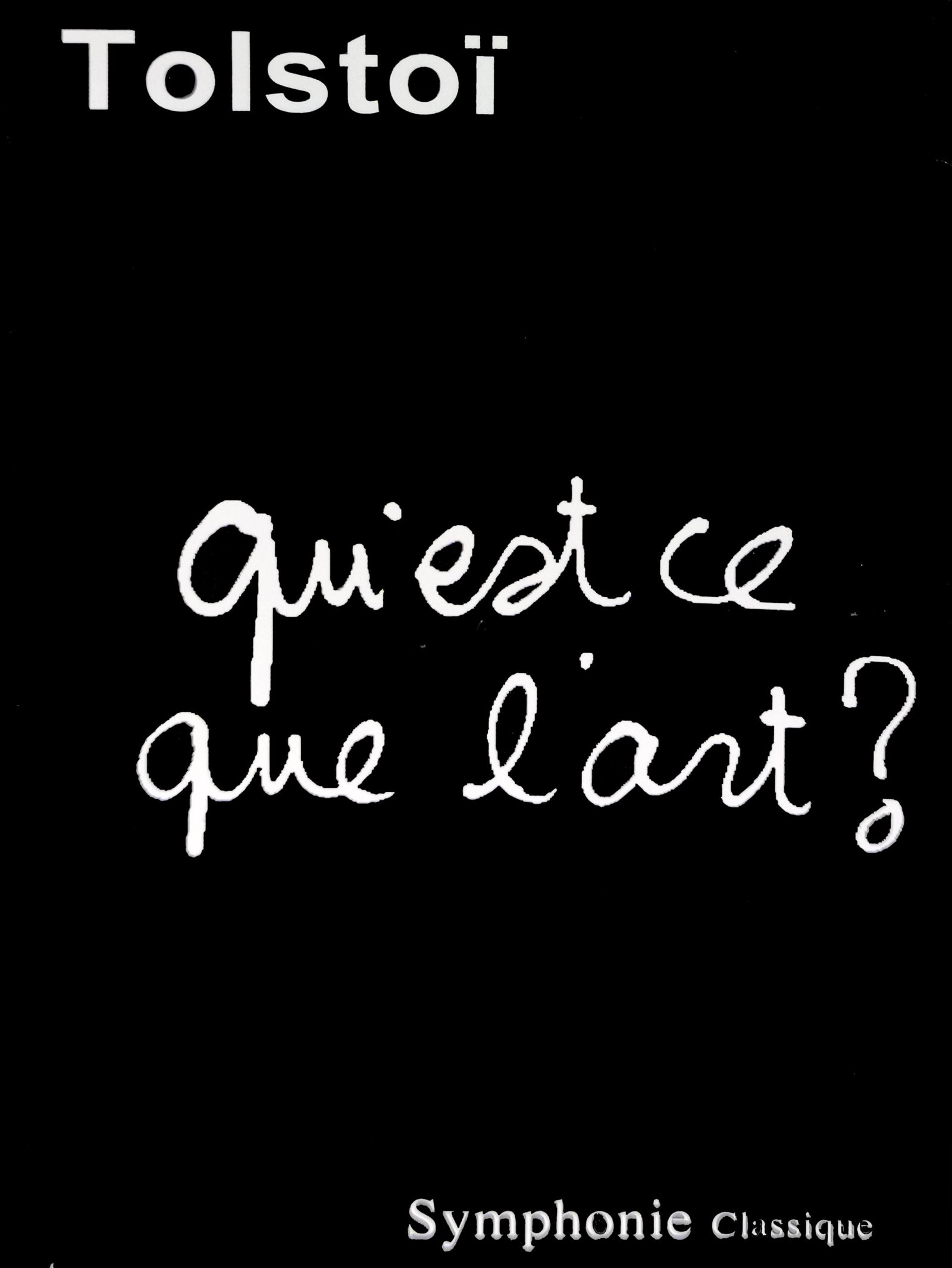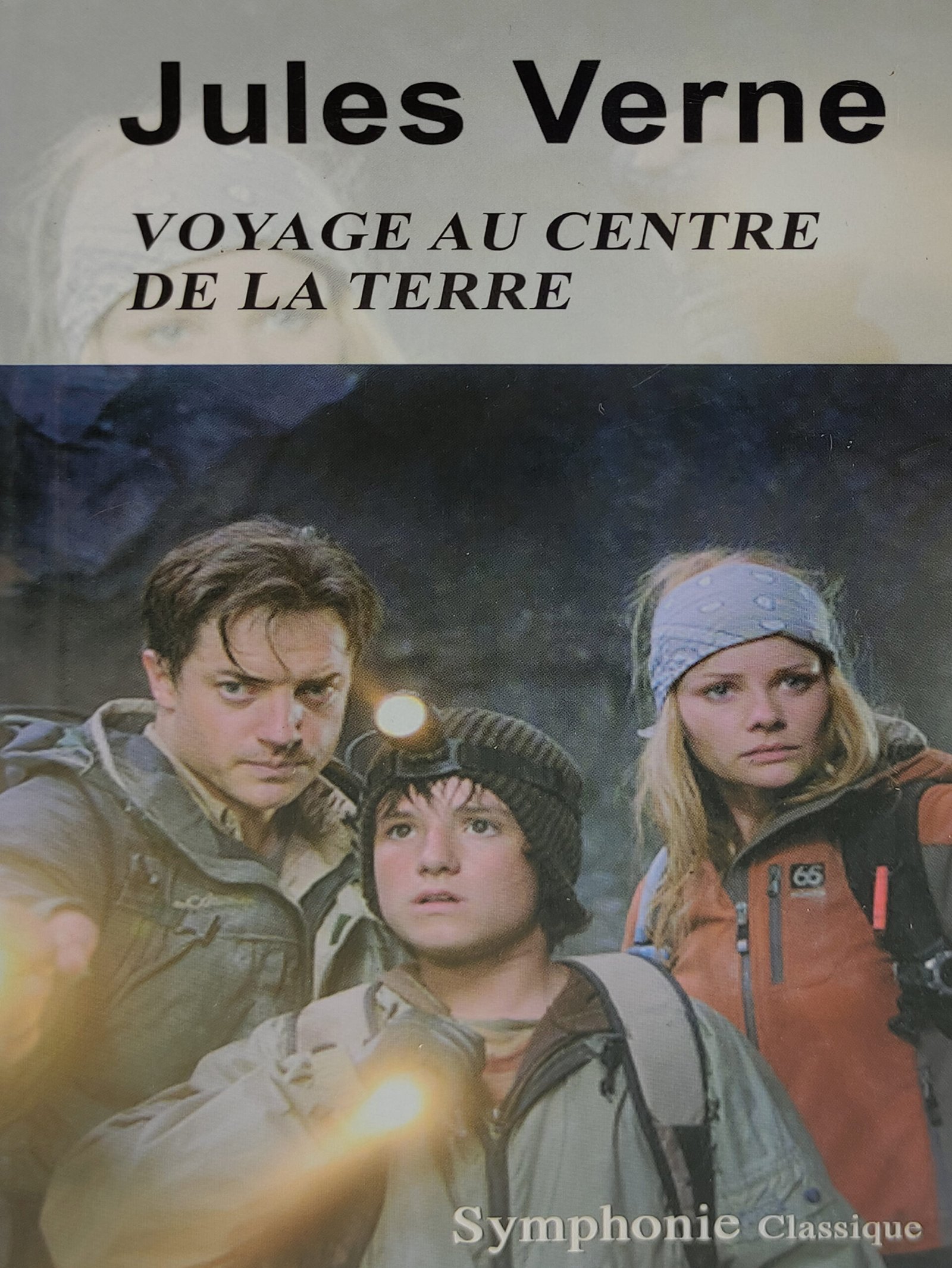أشكال من الخطاب الفلسفي العربي حركية في الفكر وتجارب من كتابة مختلفة
عدد الصفحات : 400 صفحة
تحاول هذه الدراسة إلقاء الضوء على أوضاع بلدية النبطية منذ نشأتها في العام 1883 حتى العام 2010، في ظل حكم السلطنة العثمانية وفي عهد الإنتداب الفرنسي ومن ثم عهد الإستقلال وما رافق تلك العهود من تغيرات في لبنان إدارياً، مقاطعات لبنانية في العهد العثماني، ودولة لبنان الكبير في عهد الإنتداب الفرنسي، والقرارات التنظيمية التي قسمت لبنان إلى محافظات وأقضية… فبعد أن كانت مدينة النبطية مركز ناحية، أصبحت في العام 1954 مركز قضاء، وفي العام 1975 أصبحت مركز محافظة.
ولا شك أن دراسة وضع بلدية في مدينة ما، تتطلب التطرق إلى أوضاع مدينة النبطية في كل مرحلة من المراحل التي مر بها لبنان والتي أثرت على مدينة وبلديتها، سياسياً وإقتصادياً وسكانياً…
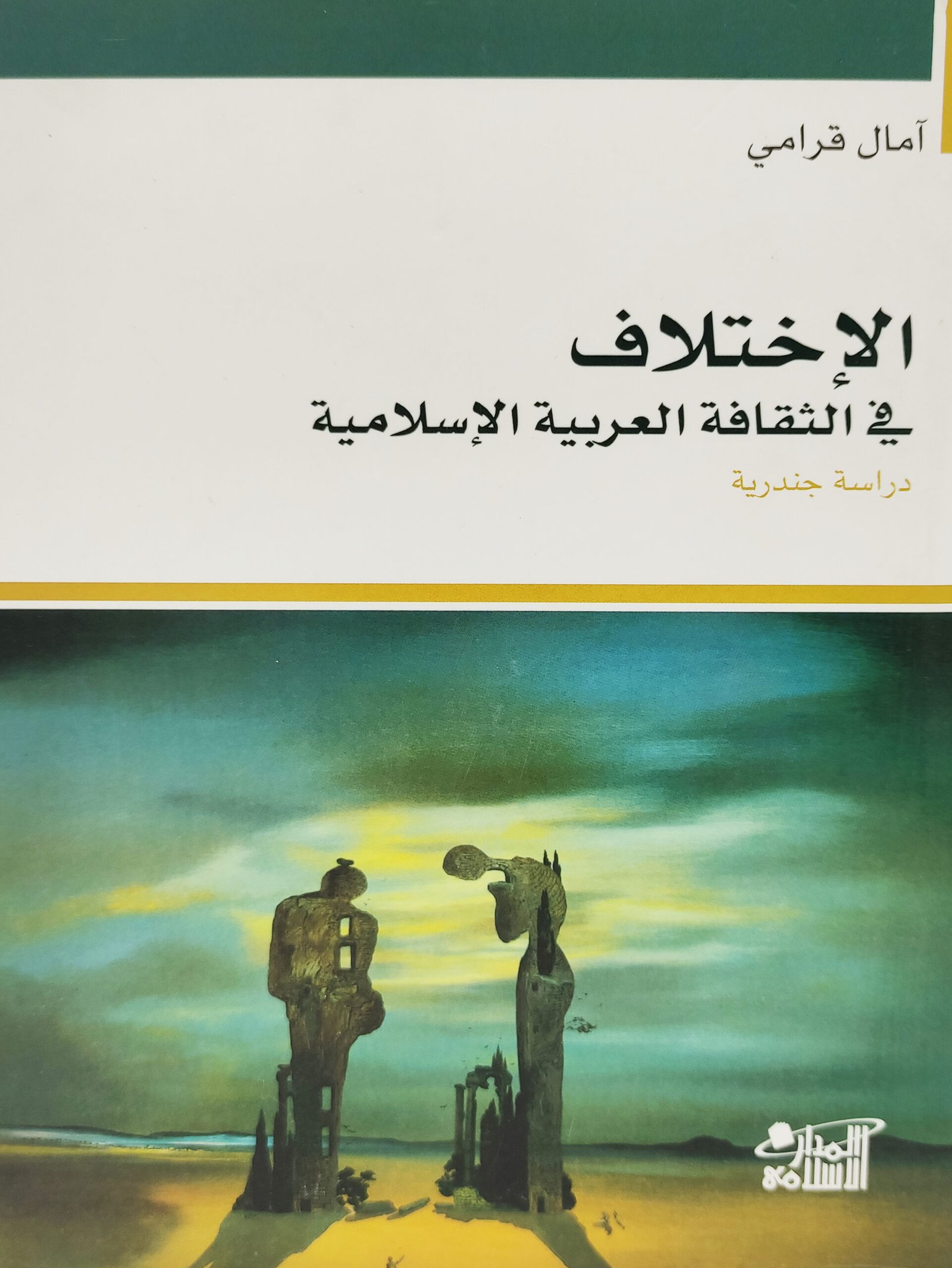
الإختلاف في الثقافة العربية الإسلامية دراسة جندرية
عدد الصفحات : 998 صفحة
يعد هذا المؤلف أول عمل أكاديمي طبقت فيه مناهج الدراسات الجندرية الإنجلوسكسونية وكذلك الأوروبية على نصوص متنوعة من التراث العربي الإسلامي للوقوف عند السمات التي تميز هذه الثقافة في تعاملها مع الاختلاف، وبهذه الدراسة انكشفت ملامح الأنثى وملامح الذكر ائتلافاً واختلافاً، وبه تقرب العناصر المكونة لمنظومة فكرية عربية إسلامية قديمة التشكل، كنجدرة في عصر أهلها اليوم، متواصلة التأثير فيهم.
وعلى الرغم من وعي المؤلفة بصعوبة الإحاطة بكل مظاهر الاختلاف في تطورها التاريخي، فإنها قد قدمت على هذه المغامرة باعتبارها الأولى من نوعها. فلم يكن منهجها تاريخياً يعتمد تسلسل المراحل وتتابعها بدقة. ولم تتقيد بفترة تاريخية محددة حرصاً منها على بيان امتداد مظاهر الاختلاف عبر التاريخ. فالقيم الخاصة بتشكيل الذكورة والأنوثة لا تتغير بيسر وتصعب زحزحتها، كما أن آليات تثبيت الفوارق بين مختلف الفئات الاجتماعية والعرقية والدينية وغيرها نلمحها في مختلف المجتمعات والعصور. ولذلك لفت القارئ في بعض الفصول إلى ما نعانيه اليوم من ممارسات تتماثل مع ما كان موجوداً في العصر الوسيط. ولم تكن هذه الإشارات من قبيل الاستطراد أو إيراد الخواطر، وإنما قصدت إلى ذلك قصداً حتى تبين أن صلتنا بالماضي لم تنقطع.
ولقد ارتأت استقصاء أغلب مظاهر الاختلاف في المراحل العمرية كافة بدءاً بالطفولة ووصولاً إلى الشيخوخة محافظة على التقسيم الذي ضبطه القدامى لدورات الحياة، مبرره في ذلك أن تشكيل الثقافة للفرد ينطلق منذ لحظة خروجه إلى الدنيا ويتواصل حتى الشيخوخة. وهذه الصياغة تأخذ في الاعتبار عامل السن فتجعل تدبير الفرد مختلفاً من دورة حياة إلى أخرى، ومنسجماً مع المطلوب من كل فرد في آن، وعاكساً للتصورات والتمثلات والرموز الخاصة به حسب السن. وينجم عن ذلك اختلاف مفهوم كل من الذكورة والأنوثة من دورة حياة إلى أخرى.
ونظراً إلى أن المؤلفة قد اختارت الاهتمام برصد مظاهر الاختلاف حسب دورات الحياة: الطفولة والشباب والاكتهال والشيخوخة، فقد خضع تقسيم عملها لهذا التصنيف الرباعي. ووزعت الأبواب إلى فصول تنقسم بدورها إلى فقرات. وجعلت لكل منها عنواناً يكون بمثابة دليل يهدي القارئ إلى ما تروم التنبيه إليه، وارتأت أن يكون وصف مظاهر الاختلاف مشفوعاً بعرض الأسباب والدلالات المقترحة.
الباب الأول: “الولد في حضانة أمه ومجتمع النساء”. خصصته لتقصي مظاهر الاختلاف بين الجنسين في مرحلة الطفولة وكان هدفها من وراء ذلك إثبات أن الثقافة هي التي تبني هوية الفرد الجندرية فتمنحه صفات وموقعاً، وعلى أساسها يتعامل الآخرون معه. وكانت غاية الفصل الأول بيان تجليات الاختلاف على مستوى توليد الذكر وتوليد الأنثى. وانصرفت في الفصل الثاني إلى دراسة مظاهر الاختلاف بين الجنسين في مجال تدبير جسد المولود نحو العناية بالوصلة والمشيمة والتمليح وغيرها من الأمور.. ثم عقدت فصلاً ثالثاً لاستقصاء مشاعر الأهل عند ولادة الصبي وولادة البنت وعند موت كل منهما. أما الفصل الرابع: فقد تعرضت فيه إلى صور أخرى تبين عن الاختلاف بين الجنسين نحو الرضاعة واللباس والزينة وبول كل من الصبي والبنت، وحضانة الولد، وألعاب الصبيان، وعلاقة الولد بالسياسة.
الباب الثاني: “من سن النشوء إلى سن البلوغ”. حاولت في هذا الباب أن تبين أن المجتمع يلزم البنت بمجموعة من الصفات التي ينظر إليها على أنها دالة على الأنوثة، ومن ثمة تصبح الأنوثة محددة ثقافياً واجتماعياً وتاريخياً. والأمر بالمثل بالنسبة إلى مسار بناء الذكورة. وقد تناولت في الفصل الأول تجليات الاختلاف في مجال تدبير الجسد الأنثوي والجسد الذكوري، واهتممت في الفصل الثاني بالآداب الاجتماعية ومنظومة القيم التي تتعلق بكل من الفتاة والفتى، وعرضت في الفصل الثالث معارف البنت ومعارف الفتى. وكان الفصل الرابع مخصصاً لتحليل بنية العلاقة بين الجنسين فأشرت إلى مسائل الفصل بين الجنسين، وتقسيم الفضاء وصلة الحدث بالجنسانية، وزواجه ومختلف الأدوار التي يعود عليها منذ التفتي. وخصص الفصل الخامس للبلوغ.
الباب الثالث: “الشباب والاكتهال”. عملت في هذا الباب على بيان أنه على الرغم من حرص الثقافة على ضبط العلامات الدالة على الهوية الجندرية، فإن هناك فئة تحيد عن المعايير الضابطة للأنوثة والذكورة فتكون عاكسة لصنف جندري خاص. كما أنها قد سعت إلى توضيح كيف يتحكم المجتمع بالأدوار والوظائف والعلاقات بين الجنسين. فتطرق في الفصل الأول إلى هيئة كل من الرجل والمرأة، وخصوصاً اللباس والزينة. وعالجت في الفصل الثاني قضايا تتصل بتشكيل الهويات الجندرية المختلفة فاجتمعت بتشبه كل جنس بالآخر وبالمترجلة والغلامية والمخنث واللوطي والمساحقة والخصي والخنثى. وعقدت فصلاً ثالثاً لاستقراء مظاهر الاختلاف بين الجنسين في مجال ممارسة الطقوس الدينية، فاختارت الصلاة نموذجاً. ثم خصصت الفصل الرابع لرصد تجليات الاختلاف في طقوس العبور وآثرنا الاهتمام بطقوس الموت نموذجاً. وكان الفصل الخامس مخصصاً لتحليل العلاقة الزوجية وبيان واجبات كل من الزوج والزوجة وحقوق كل منهما على الآخر. ولم يفتها معالجة العلاقة الجنسية فأشرت إلى متعة الرجل وصور التحكم في جنسانية المرأة نحو الخفاض وتقييد أشكال الجماع وقضية النشوز وعيوب النكاح والإيلاء والزهار وامرأة المفقود. وكللت كل ذلك بقراءة في بنية السلطة.
كان هدفها في هذا الباب إبراز أن عملية تشكيل الفرد تتواصل رغم بلوغه الشيخوخة، كما أنها حاولت أن تتقصى حدود الاختلاف لنكشف عن مرونة المجتمع وتساهله مع هذه الشريحة العمرية، الأمر الذي يؤدي إلى تقريب المسافة بين الجنسين. وقد خصصت الفصل الأول لبيان الفرق بين شيخوخة الرجال وشيخوخة النساء، ووجهت عنايتها في الفصل الثاني إلى وصف تعهد جسد الشيخ وجسد العجوز، وتطرقت في الفصل الثالث إلى جنسانية الشيخ من خلال تحليل علاقته بعجوزه وبالزوجة الشابة وبالغواني, ولم يفتها أن تتطرق إلى علاقة الشيخ اللوطي بغيره، وأثرت قضية العنة، ثم عكفت على وصف جنسانية المسنة، فأشرت إلى فرص الزواج المتاحة أمامها، والأنشطة الجنسية التي يمكن لها ممارستها, وتعرضت في الفصل الرابع إلى أدوار الشيوخ وأدوار العجائز وصور تحررهن. وخصصت الفصل الخامس لعرض مظاهر الائتلاف بين الجنسين مثل الضعف ومكانة الكبير في المجتمع. وتطرقت في الفصل السادس إلى أزمة الذكورة التي تفضي إلى انتقال الشيخ من القوة إلى الضعف، ومن الاستقلالية إلى التبعية، ومن الهيمنة إلى الخضوع.
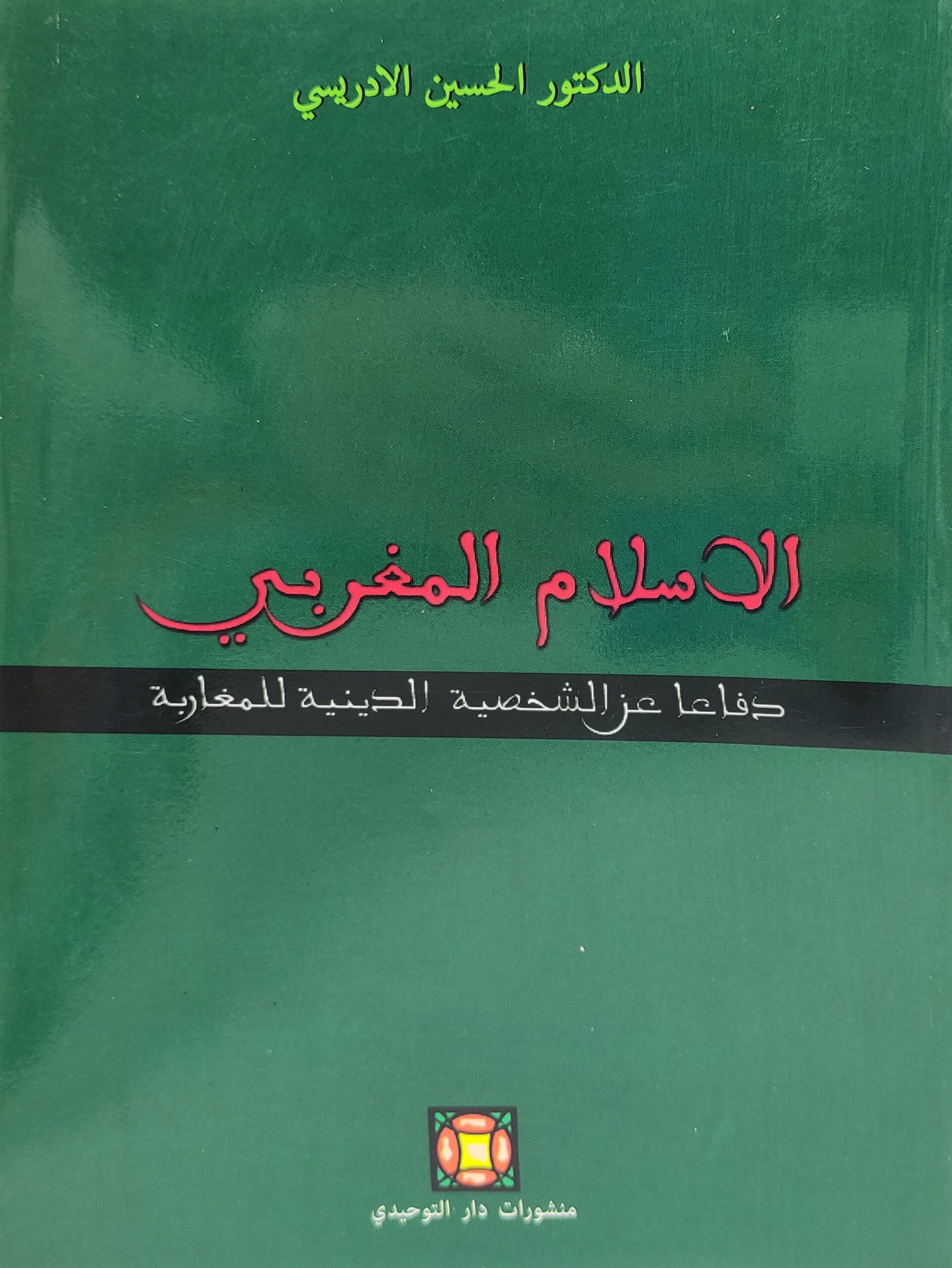
الإسلام المغربي دفاعا عن الشخصية الدينية للمغاربة
عدد الصفحات : 152 صفحة
الدكتور الحسين الادريسي ساهم بأفكاره وأعماله و نضاله في نشر قيم و أسس الإسلام المستنير و حذر رحمه الله في وقت مبكر جدا من خطر الأفكار المتطرفة والممارسات الشاذة لدى بعض المتدينين والتي للأسف تفاقمت حدتها و زاد لهيبها حتى أحرق بلدانا بأكملها و بحمد الله نجا منه بلدنا الحبيب. لا شك أن صديقنا و مفكرنا و فقيدنا الحسين الإدريسي كان من الأوائل الذين دقوا ناقوس الخطر من خلال التحذير من خطر الحركات والجماعات المتطرفة و ضرورة الرجوع إلى مبادئ الإسلام المغربي والتشبث بمرتكزاته التي راكمها عبر التاريخ. فالسلام عليك أيها المناضل الصادق ، أيها الرجل الأمين و أيها الأخ و الحبيب و الصديق الذي افتقدناه مبكرا و فجعنا برحيله و نعاهدك أننا ماضون على طريقنا الذي رسمناه معا و سنواصل مسيرتنا في دعم و تنوير المجتمع . و السلام عليك وعلى جميع المناضلين الشرفاء و الوطنيين الأحرار الذين يعتزون بمغربيتهم . وكما كنت دائما تدعو للمغرب أن يحفظه الله، ندعو لك بالرحمة و الغفران وأن يحفظ أفكارك وأعمالك و أن يجعلها خالدة .

التفكير ما وراء المعرفي (رؤية نظرية ومواقف تطبيقية)
عدد الصفحات : 328 صفحة
ضم الكتاب ستة فصول و رتبها ترتيبا منطقيا , الفصل الاول عبارة عن مقدمة في التفكير بصورة عامة من حيث الاهمية و الجذور التاريخية و تصنيفاته و انماطه , الفصل الثاني فتناول موضوع تنمية التفكير و مهاراته و دور كل من المنهج و المعلم و المتعلم في تعلم التفكير و كذلك الاتجاهات الحديثة في تنمية التفكير و تم اخيرا عرض عددا من البرامج التعليمية في تنمية التفكير , الفصل الثالث تناول التفكير ما وراء المعرفي من النشأة الى الاراء في تفسيره و النظريات التي اشتق منها و تطرق الى مكوناته و مبادئه , الفصل الرابع مهارات التفكير ما وراء المعرفي و كيفية تنميتها و تناول هذا الفصل هذه المهارات و اهم تصنيفاتها و علاقتها بعدد من المتغيرات الاخرى ,الفصل الخامس فكان لدراسات عربية و عراقية تناولت التفكير ما وراء المعرفي , و الفصل السادس ليقدم برنامجا تعليميا كاملا لتدرس مهارات التفكير ما وراء المعرفي في دروس المطالعة .

الحداثة المقلوبة نقد النقد الأوروبي حول مفهوم الدين وماهية الفلسفة وإيديولوجيا العلم
عدد الصفحات : 310 صفحة
الفكرة المقلوبة، مشروعنا الحالي، هي محاولة لقلب المفاهيم الفلسفية، وتغييرها وزحرحتها، من كونها إيديولوجيا غربية، لجعلها تدخل في قوالب الجدل داخل الفلسفة الإسلامية المعاصرة، موضوع تخصصنا الرئيسي ومشوار عمرنا العلمي تاريخياً وإستراتيجياً.
ليس المطلوب فقط إحداث ثغرة علمية وفلسفية ونقدية داخل الفلسفة الإسلامية من أجل التحديد، فهذا مطلب طبيعي، على أساس أن التغيير والتجديد سنة كونية وإنسانية، بل إن المطلوب أيضاً هو الإشتراك في مجمل الجدل الكوني الدائر حول الفلسفة ممثلة برهاناتها الغربية، وبمقولاتها الحداثية.
النماذج الفلسفية الكبيرة المنتخبة موضوعات لمحاورتنا الفلسفية النقدية (تورين، هيدجر، هابرماس، فيورباخ)، كما إن المطلب الرئيسي الآخر هو المساهمة مع الفلسفة الغربية في نقد مقولات ومشاريع الحداثة الغربية، على أساس أن هذه المقولات والمشاريع هي مشاريع إنسانية بالدرجة الأولى، وما تمنحه أنسنتها من حق لأي مثقف للإشتراك في جدلها النظري ونقدها التطبيقي، بما يساهم في تقديم أوجه نقدية ونظرية ومعرفية لهذا المشروع الحداثوي المذكور.