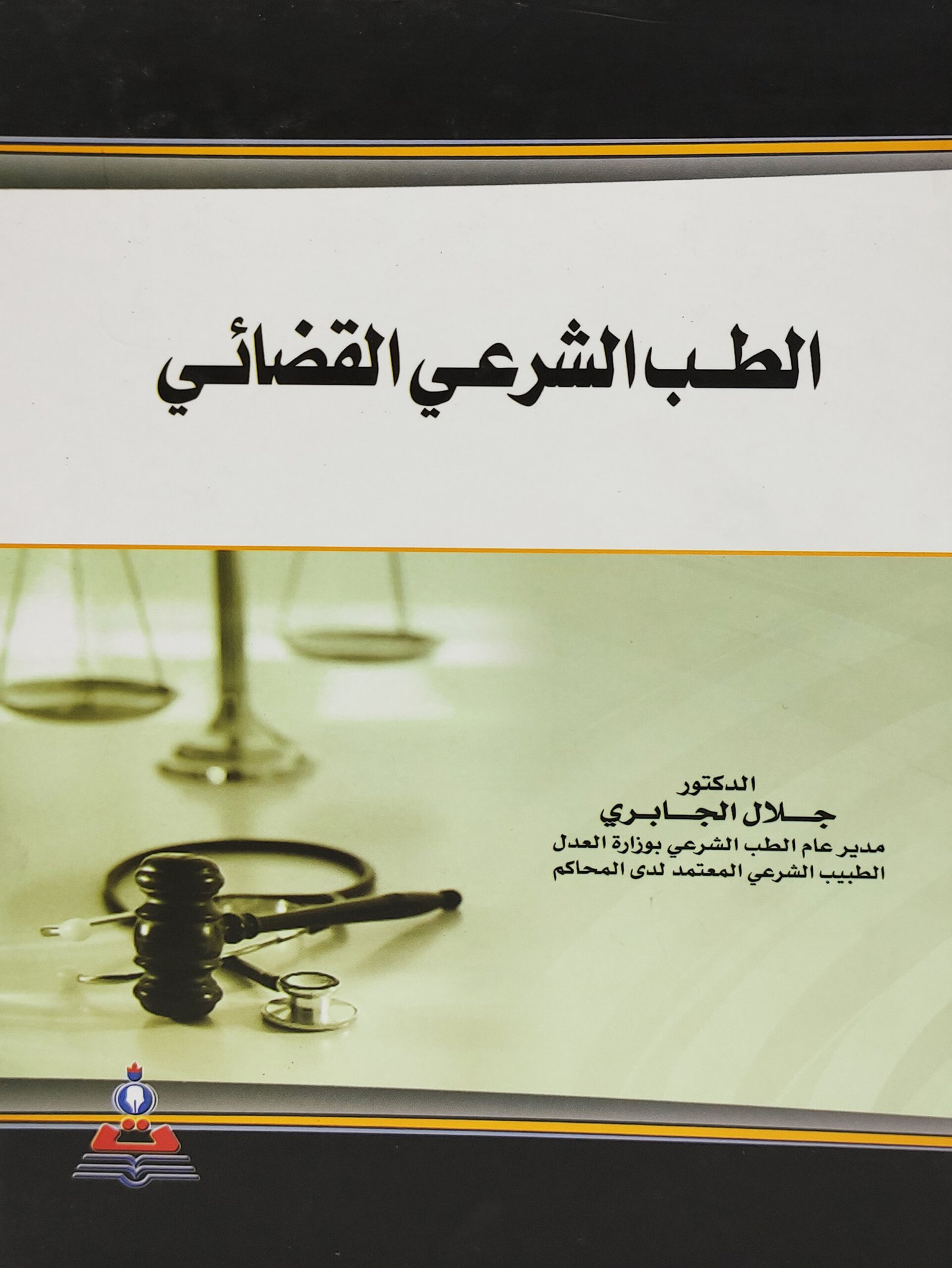
الطب الشرعي القضائي
عدد الصفحات : 334 صفحة
تبرز أهمية هذا الكتاب انطلاقاً من أهمية اضطلاع خريجي الجامعة لأصول عملهم كأطباء شرعيين، حيث أن الطب الشرعي أصبح دليل أكاديمي قاطع وقد يكون الدليل الوحيد في كثير من القضايا، لذا فإن من واجب المحامي والقاضي والمدعي العام ورجال الأمن العام معرفة أصول قراءة تقرير الطبيب ومسائله والاستفسار عن أمور من التقرير لمصلحة القضاء والعدالة.
وانطلاقاً من هذه الأهمية ارتأى الدكتور جلال الجابري مدير عام الطب الشرعي بوزارة العدل-القدس، ارتأى إعداد كتابه الذي بين يدينا والذي يدخل ضمن سلسلة المكتبة القانونية، والذي خصصه لشرح مبادئ الطب الشرعي فتحدث فيه عن أهمية الطب الشرعي، المهام الرئيسية للطب الشرعي، الطب الشرعي في الإسلام، الباحث الجنائي، التحريات ومصادرها والأدلة المادية والآثار، المعمل الجنائي، التعويضات والأروش، مضبطة نموذجية لتشريح الجثة، طرق تشريح الجثة، معاينه وفحص الجثة في الطب الجنائي، الجروح، الموت المفاجئ، الاسفكسيا، تأثير العوامل الطبيعية على الجسم الحي، السموم، الأسلحة النارية، إصابات الرأس، التعرف على الجثة، الحروق، تحيد مناطق الجسم، السموم والجروح بشكل عام وقضايا الاعتداءات الجنسية، ومسببات الاختناق وحوادث الطرق وقضايا العنف وزيارة مسرح الجريمة، الحمل وقتل المواليد وجروح الأسلحة النارية.
يتناول هذا الكتاب أهمية الطب الشرعي والمهام الرئيسية للطب الشرعي وذلك في مجال الخدمة الفنية ومجال التدريب الفني ومهام الطبيب الشرعي الخدمين والخبراء ثم ينتقل الى الطب الشرعي في الإسلام ثم ينتقل الى الباحث الجنائي وصفاته وأعوانه بين الجمهور والمرشدين والشرطة السرية والخبراء والقوات النظامية والصحافة ثم يشير الى التحريات ومصادرها الأدلة المادية والآثار والمعمل الجنائي ثم ينتقل الى التعويضات والدية وينتقل الى أسس المحاكمة والتنظيم في اختيار الطب الشرعي للدلائل المادية ثم يبين كيفية عمل مضبطة نموذجية لتشريح الجثة موضحا ذلك بصور معدداً الطرق لتشريح الجثة للبحث الجنائي والشرعي ثم معاينة وفحص الجثة في الطب الشرعي ويشير الكتاب الى الجروح والموت المفاجئ والإسفكسيا وتأثير العوامل الطبيعية على الجسم الحي وأثر السموم والأسلحة النارية موضحاً إصابات الرأس ثم الانتقال الى التعرف على الجثة ويتناول الحروق وتحديد مناطق الجسم وأخيراً يبين رسوم توضيح السقوط أو الاصطدام.
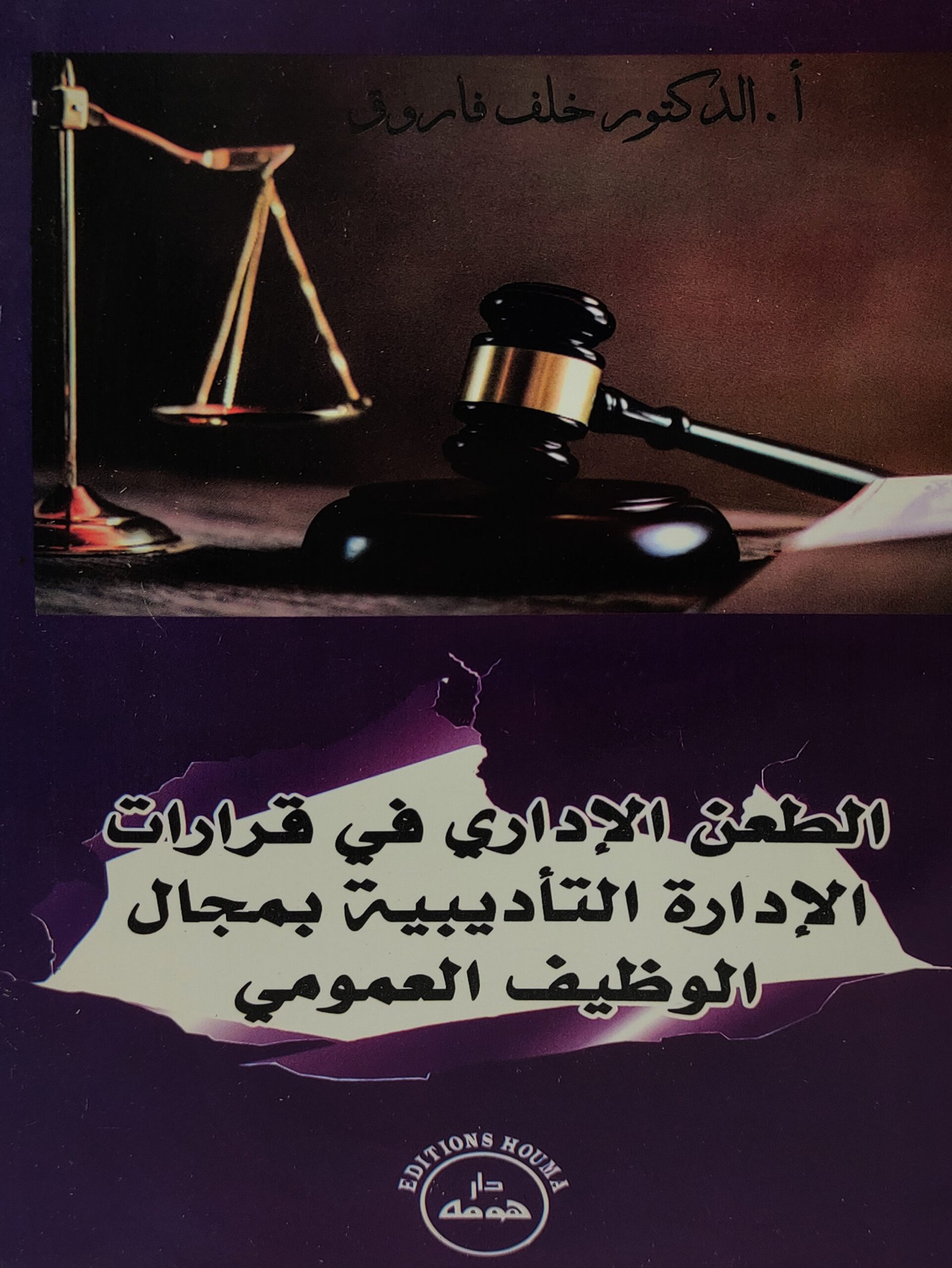
الطعن الإداري في قرارات الإدارة التأديبية بمجال الوظيف العمومي
عدد الصفحات : 168 صفحة
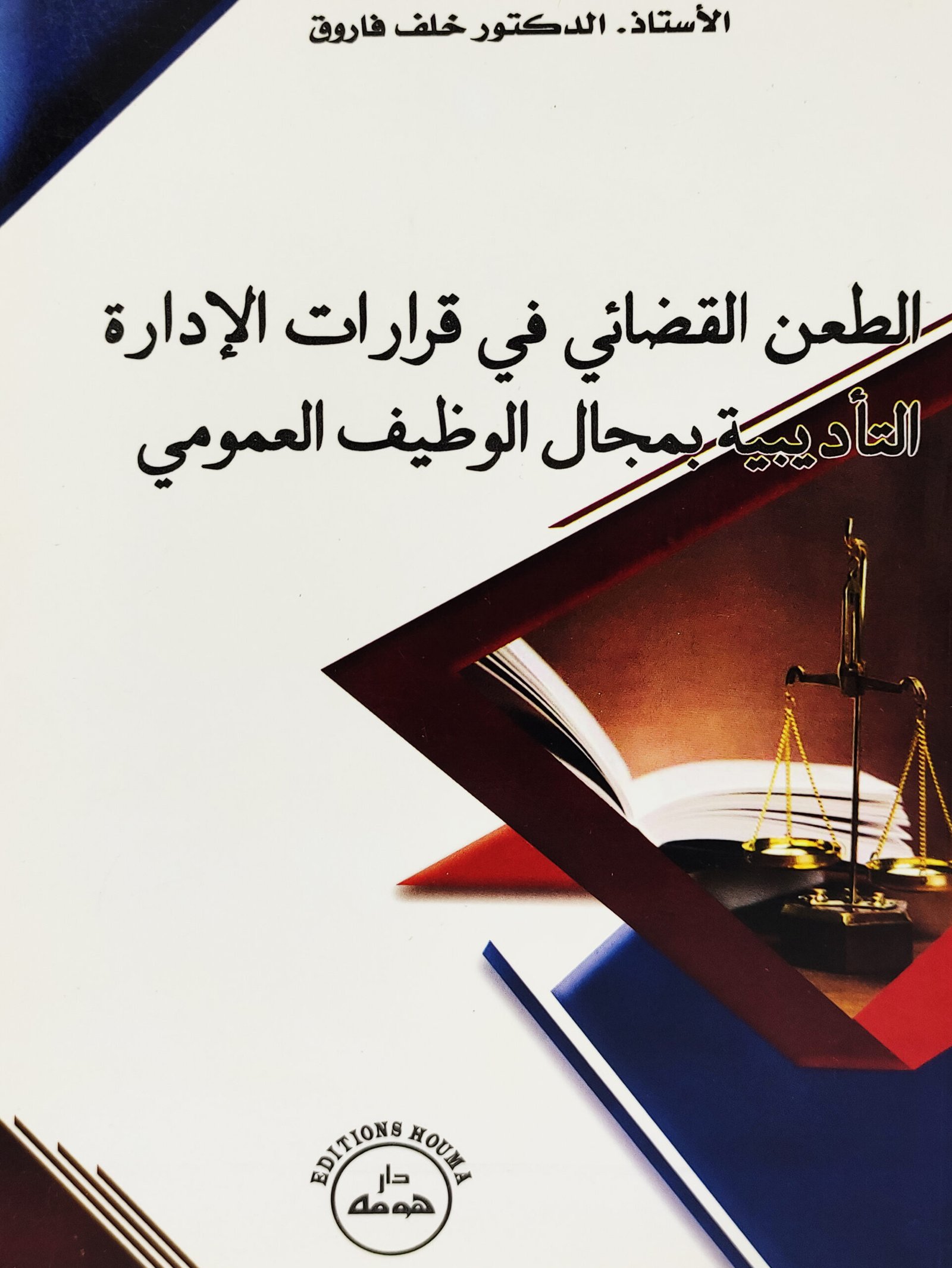
الطعن القضائي في قرارات الإدارة التأديبية بمجال الوظيف العمومي
عدد الصفحات : 312 صفحة
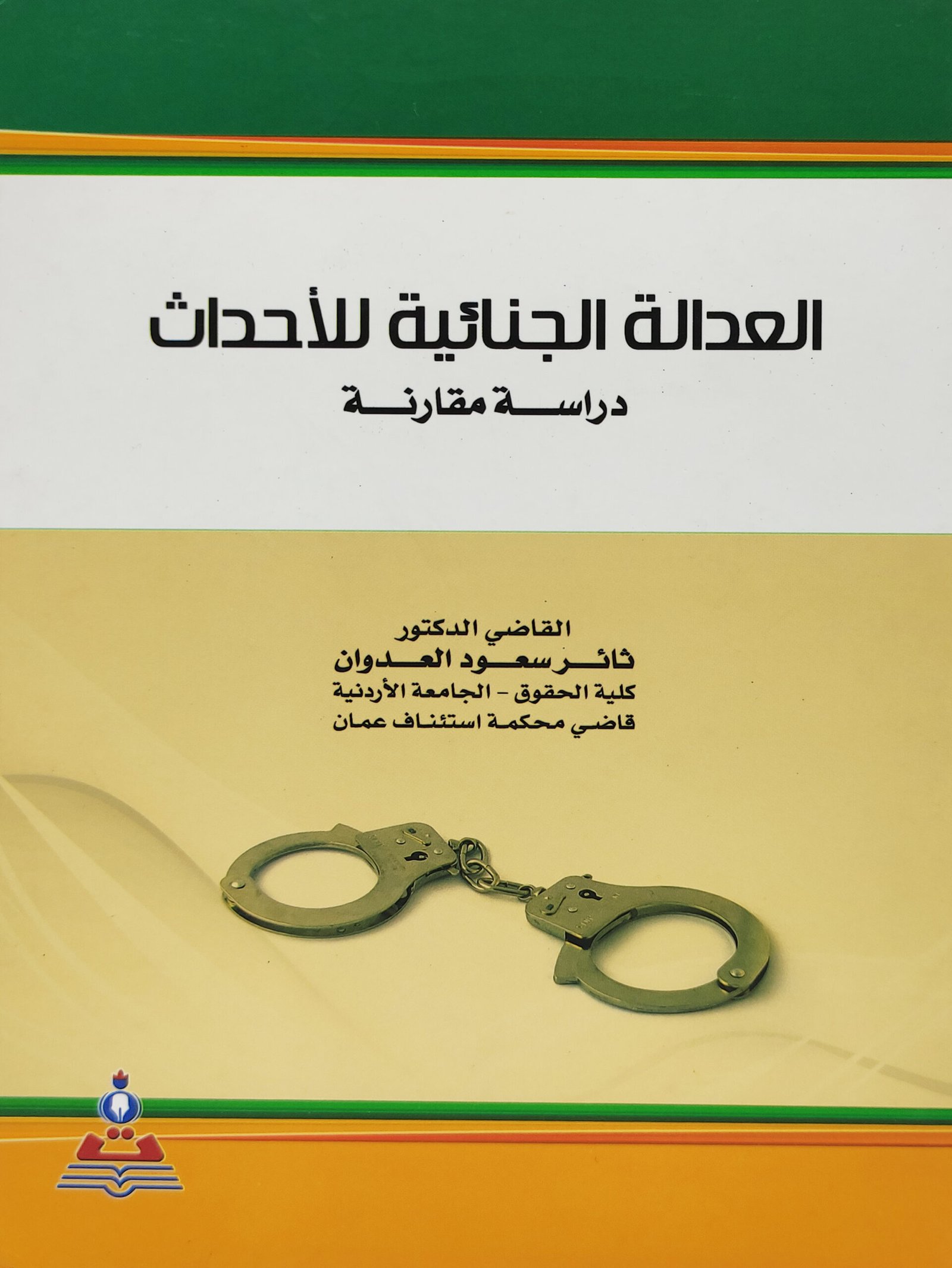
العدالة الجنائية للأحداث
عدد الصفحات : 320 صفحة
الحمد الله على فضائل نعمه، أما بعد: فإن ظاهرة انحراف الأحداث أو تعرضهم للانحراف، ظاهرة قديمة عاشت مع الزمن، وأصابت كل المجتمعات، حتى أصبح مطلب التمييز في معاملة الأحداث في نزاع مع القانون من المطالب الحديثة التي لم تعرفها غالبية المجتمعات القديمة، تلك المجتمعات التي كانت تنظر إلى الحدث الجانح على أنه مجرم يستحق العقاب والردع، حيث كان الحدث يعامل معاملة فيها كثير من صنوف الأذى والقسوة، شأنه في ذلك شأن المجرم البالغ، دون النظر إلى أية اعتبارات تتعلق بشخصه، أو الظروف المحيطة به. والحقيقة الجلية أن مشكلة جنوح الأحداث أو حتى تعرضهم للانحراف، من أهم المشاكل الاجتماعية وأكثرها تعقيداً، لأنها تعرض كيان المجتمع ومستقبل أجياله الصاعدة لخطر كبير، كون تلك المشكلة لها خطورة مزدوجة على المجتمع، فمن جهة تصبح هذه الفئة عبارة عن طاقات معطلة لا تفيد مجتمعها بشيء، وذلك من خلال ما يوقع عليها من إجراءات وتدابير وفقاً للقانون، ومن جهة أخرى، فإنها تجلب الضرر على المجتمع فتصيبه بخسائر مادية ومعنوية جسيمة. وبالتالي فإن أهمية الدراسة تنبع من حقيقة أن جنوح الأحداث وحماية المعرضين للانحراف منهم من أهم مشاكل العصر، ومواجهة هذه المشكلة تحتاج إلى تكاتف الجهود من كافة السلطات المعنية سواء الجهات القضائية أم الأجهزة المساندة، أو حتى الدور المهم الذي يلعبه الباحثون في هذا المضمار. فعدم تقديم عدالة جنائية ناصعة البياض لهذه الفئة، من خلال حماية المعرض للانحراف ورعايته وإصلاح الجانح في سبيل العودة به عضواً فاعلاً في المجتمع من شأنه أن يشكل آفة خطيرة تهدد أمن مجتمعاتنا. ولكون ظاهرة الجنوح لها أبعادها المختلفة، فقد اتجهت الجهود إلى مواجهتها بحلول فعالة ترتكز على فكرة توفير أكبر قدر من العدالة الجنائية للأحداث في نزاعهم مع القانون وحماية ورعاية المحتاجين منهم إلى الرعاية أو الحماية (المعرضين للانحراف). حيث برزت أهمية رعاية الأحداث في المجتمعات الحديثة، وبرز الاهتمام بالمنحرفين أو المعرضين للانحراف منهم، وصار ينظر إلى الحدث الجانح ليس باعتباره مجرماً يستحق العقاب، وإنما باعتباره ضحية لظروف اجتماعية معينة أدت إلى انحرافه، وينظر إلى الحدث المعرض للانحراف على أنه محتاج للحماية والرعاية منعاً لانحرافه، الأمر الذي يستلزم بالضرورة، أن يكون للقاضي سلطة تقديرية واسعة، لاختيار الأسلوب الأكثر ملاءمة في معاملة الحدث الجانح أو المعرض للانحراف وفرض العقوبة أو التدبير المناسب، بهدف الإصلاح والحماية، وبالتالي حماية المجتمع من خطر الجريمة.
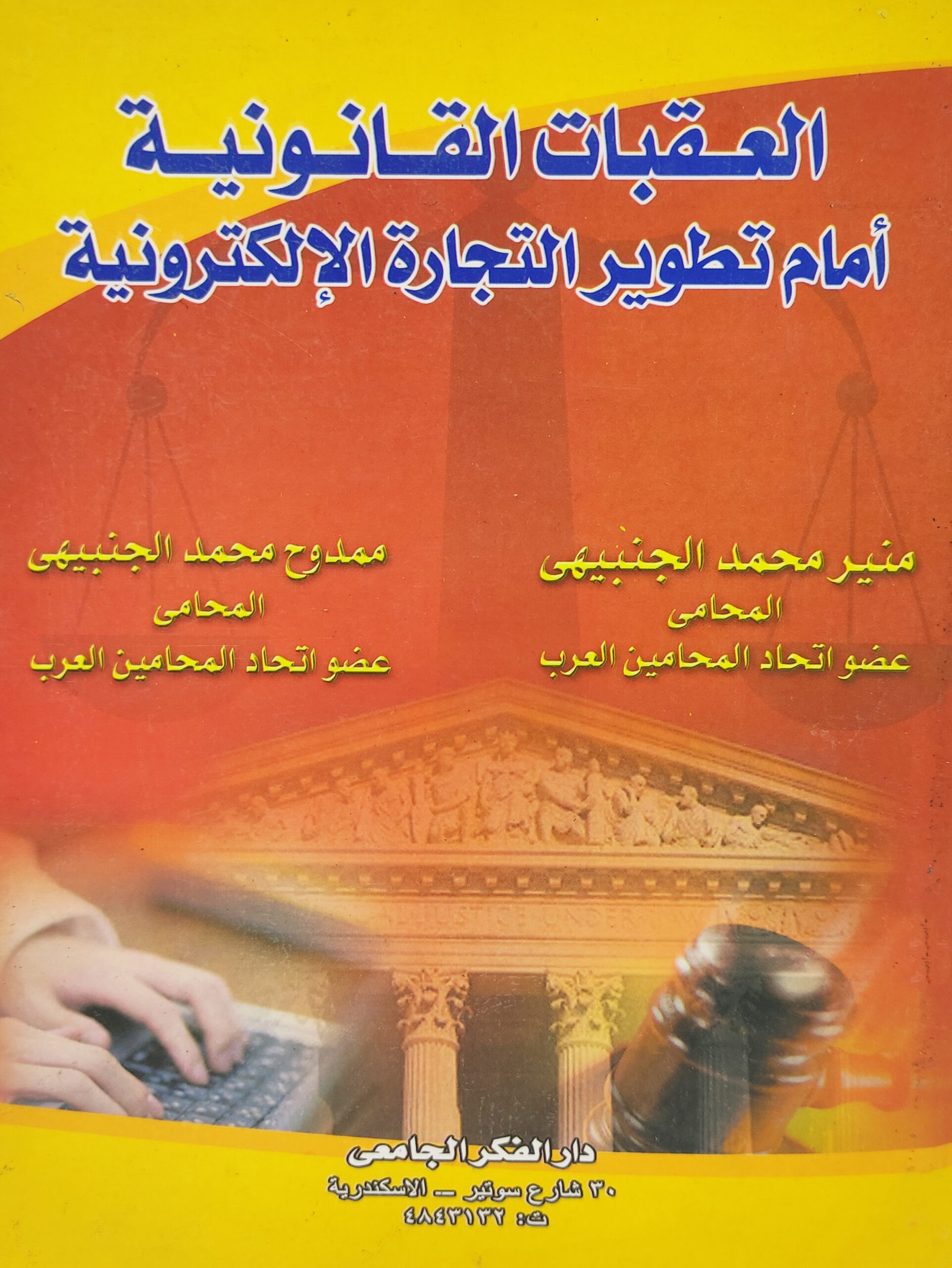
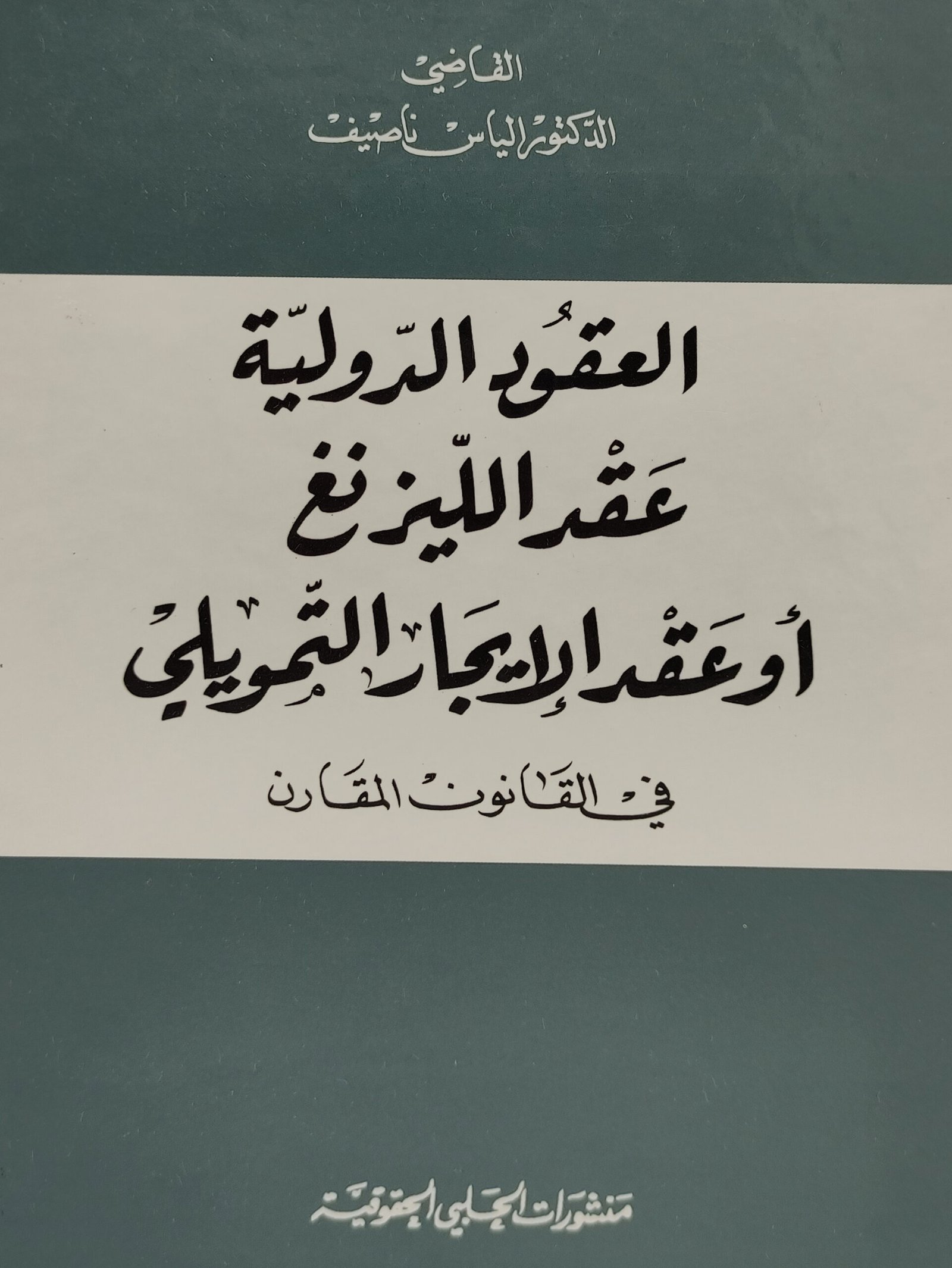
العقود الدولية عقد الليزنغ أو عقد الإيجار التمويلي في القانون المقارن
عدد الصفحات : 576 صفحة
إن عقد الليزنع أو عقد الإيجار التمويلي هو من وجهة النظر الاقتصادية من عقود التمويل، أما من وجهة النظر التشريعية، فهو يقوم على آلية تجمع بين عقود متعددة، أقلها أربعة هي: عقد إيجار وعقد وكالة وعقد وعد بالبيع وعقد بيع -وعن طريق هذه الآلية يستطيع رجال الأعمال أن يجمعوا بين توفير التمويل اللازم، والقدرة الفنية والمتخصصية، توصلاً إلى تحقيق مشاريه ضخمة وقوية النجاح.
تتناول فصول هذا الكتاب تحديد مفهوم عقد الليزنغ، وخصائصه، وطبيعته القانونية، وأهميته، وكيفية إنشائه، وشروطه الشكلية والموضوعية، وآثاره، وانتهاءه، وتجديده. وإلغاءه.
يتسم هذا العقد بالسمة الدولية، وهو يقوم على التضافر والتعاون بين رجال الأعمال والفنيين والممولين، عبر آليات محددة اكتسبت مع الزمن استقرارها وتشابهها في كل عقود الليزنغ.
حاولنا في هذا الكتاب أن نلقي الضوء على مفهوم هذا العقد وأهميته، وشروطه وقواعده القانونية، وكيفية تطوره على الصعيد الدولي، مستعينين بالتشريعات الأدنبية، ولا سيما التشريع الفرنسي واجتهادات المحاكم، وتطرقنا إلى تشريعات الدول العربية، في هذا المجال، على أمل إعطاء فكرة واضحة عن هذا العقد وقواعده الاقتصادية والتشريعية.
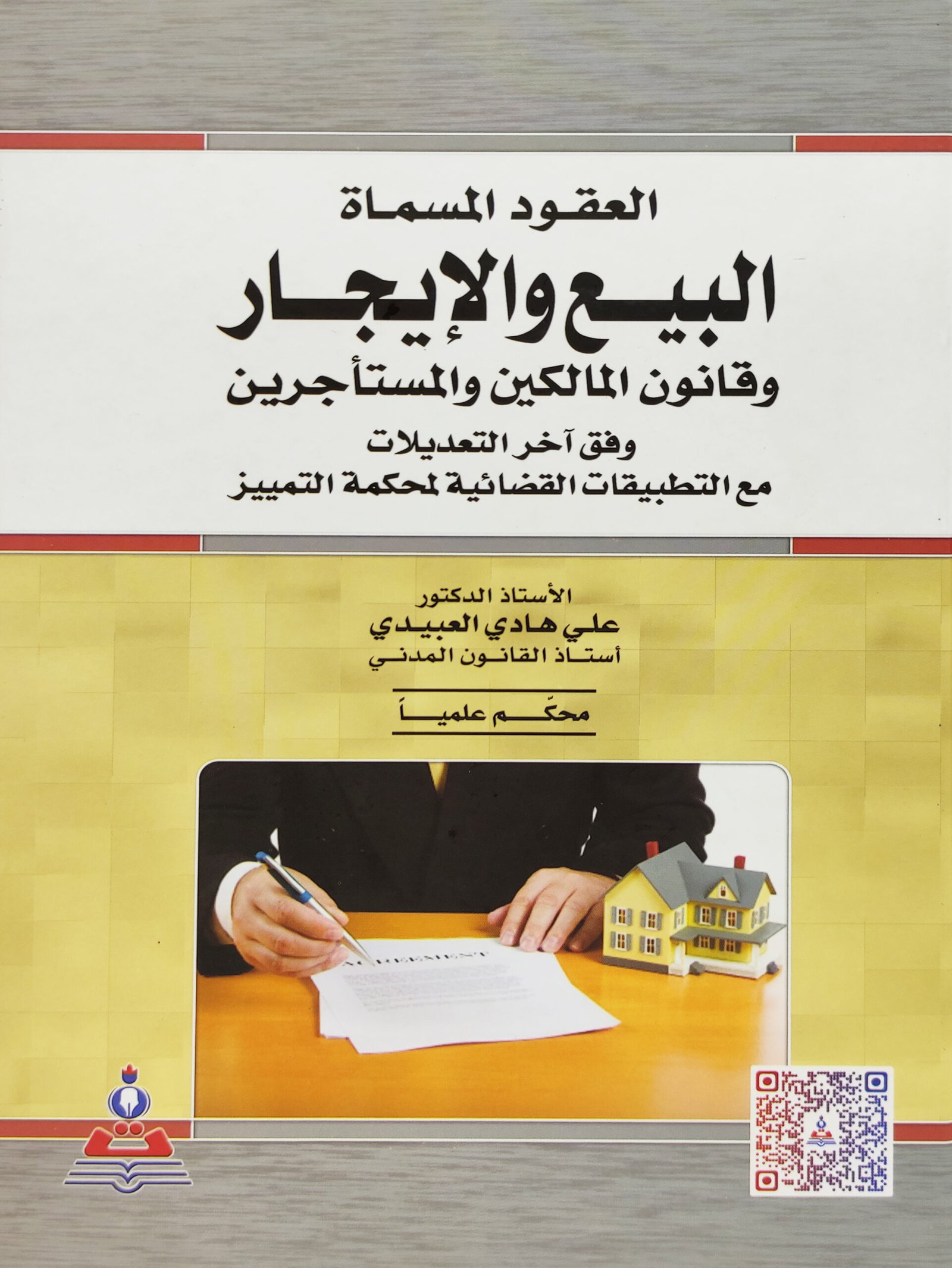
العقود المسماة البيع والإيجار وقانون المالكين والمستأجرين وفقا لآخر التعديلات مع التطبيقات القضائية لمحكمة التمييز
عدد الصفحات : 378 صفحة
يراد بالعقود المسماة العقود التي تولاها القانون بالتنظيم وأعطاها أسماء معينة نظراً لشيوع استعمالها في الحياة العملية ولما تحظى به من أهمية خاصة. ويدل هذا التعريف على أمرين، أحدهما أن المعيار المعول عليه في تمييز العقود المسماة عن سواها من العقود غير المسماة هو التنظيم القانوني للأولى دون الثانية، والآخر أن فكرة العقود المسماة لا تقتصر على القانون المدني دون سواه من القوانين، إذ توجد عقود مسماة في القانون التجاري وقانون العمل وغيرهما من القوانين. وتجدر الإشارة إلى أن انتشار عقد من العقود في التعامل بين الناس قد يدفع المشرع إلى تنظيم أحكامه تنظيماً خاصاً ومن ثم يصبح عقداً مسمى، ولكن هذا الانتشار في حد ذاته لا يعد معياراً مميزاً للعقود المسماة عن العقود غير المسماة، كما أن إطلاق تسمية على عقد من العقود في التعامل لا يجعله عقداً غير مسمى كعقد النشر وعقد التأليف، لذا يذهب البعض ــ وبحق ــ إلى انتقاد تسمية أو مصطلح “العقود غير المسماة” ويرى من الأفضل استخدام مصطلح “عقود لم ينظمها القانون”. والهدف من التنظيم القانوني للعقود المسماة هو التيسير على الأفراد والقضاة. إذ عندما يجد المشرع أن عقداً ما يحظى بأهمية كبيرة في الحياة العملية فإنه غالباً ما يتصدى لتنظيم أحكامه تنظيماً خاصاً وذلك لتحقيق عدة اهداف منها: التيسير على الأفراد الذين غالباً ما يجهلون الأحكام القانوننية الدقيقة للعقد الذي يرغبون في إبرامه. كذلك لتيسير مهمة القاضي في الفصل في النزاعات المعروضة عليه دون الرجوع إلى القواعد العامة التي تتطلب جهداً كبيراً من القاضي عندما يريد تطبيقها على الحالات الخاصة. وقد يهدف المشرع من ذلك أيضاً الخروج عن القواعد العامة عندما يجد أن المصلحة تستدعي ذلك. وكذلك قد يهدف إلى تطوير عقد من العقود لجعله منسجماً مع متطلبات العصر. وفيما يأتي نتحدث عن القواعد التي تحكم العقود المسماة وطبيعتها وأصناف العقود المسماة والتكييف القانوني للعقود. أولاً: القواعد القانونية التي تحكم العقود المسماة والعقود غير المسماة تخضع العقود المسماة للقواعد القانونية الخاصة بها، وعندما لا يجد القاضي في هذه القواعد قاعدة تناسب بالنزاع المعروض عليه يلجأ إلى القواعد العامة في العقد (نظرية العقد)، فإن لم يجد يرجع إلى مصادر القانون الأخرى. أما بخصوص العقود غير المسماة فيجب على القاضي أن يطبق عليها القواعد العامة مباشرة، فإن لم يجد يرجع إلى المصادر الأخرى. ثانياً: الطبيعة القانونية للقواعد التي تحكم العقود المسماة إن الأصل في القواعد القانونية التي تحكم العقود المسماة أنها قواعد مكملة وليست آمرة، وعليه يجوز لطرفي العقد الاتفاق على خلافها ما لم يكن هذا الاتفاق مخالفاً للنظام العام أو الآداب أو مناقضاً لمقتضى العقد. والهدف من هذا التنظيم القانوني، غير الملزم للعقود المسماة هو التسهيل على المتعاقدين وإغناؤهم عن التطرق لجميع تفاصيل العقد . ثالثاً: أصناف العقود المسماة وأنواعها في القانون الأردني خصص المشرع الأردني الكتاب الثاني من القانون المدني رقم (43) لسنة 1976 لمعالجة موضوع العقود المسماة، وقد قسم هذا الكتاب إلى خمسة أبواب عالج فيها على التوالي: 1. العقود التي ترد على ملكية الشيء، وتشمل البيع والهبة والشركة والقرض والصلح. 2. العقود التي ترد على منفعة الشيء، وتشمل الإجارة والإعارة. 3. العقود التي ترد على العمل، وتشمل المقاولة والعمل والوكالة والإيداع والحراسة. 4. العقود التي ترد على موضوع احتمالي غير محقق والتي تسمى بعقود الغرر، وتشمل الرهان والمقامرة والمرتب مدى الحياة والتأمين. 5. عقود التوثيقات الشخصية، وتشمل الكفالة والحوالة. وكل نوع من العقود الواردة أعلاه يتسم بطبيعة قانونية خاصة به تميزه عن سواه من العقود، ولكن هناك بعض أوجه الشبه بين كل مجموعة من العقود التي تنتمي إلى طائفة أو صنف واحد، كما أن جميع هذه العقود تشترك في كثير من الحكام التي تخضع فيها لنظرية العقد. ومن العقود المسماة أيضاً ما تضمنه قانون التجارة كعقد الحساب الجاري وعقد الوديعة النقدية وعقد إجارة الخزائن وعقد الوكالة بالعمولة وعقد النقل وغيرها. كما أن هناك عقوداً مسماة أخرى نظمتها قوانين خاصة كعقد الصيرفة مثلاً. رابعاً: التكييف القانوني للعقود إن التنظيم القانوني الخاص لبعض العقود يثير لنا مسألة قانونية دقيقة ومهمة تستحق البحث، هي مسألة “تكييف العقود”. إذ لولا هذا التنظيم الخاص لما ظهرت الحاجة إلى التكييف، لأنه مهما كان نوع العقد فإن نظرية العقد هي التي تكون واجبة التطبيق. ويراد بتكييف العقد تحديد طبيعته القانونية وإعطائه الوصف القانوني المناسب له. ويكون القاضي ملزماً بتكييف العقد، لأن التكييف من صميم عمله فسيحسم النزاعات، وهو يقوم بذلك من تلقاء نفسه دون أن يتقيد بتكييف الخصوم، كما أنه يقوم بهذه العملية وأن لم يحصل نزاع بين ذوي العلاقة حول الوصف القانوني الصحيح للعقد، فقد يجهل الطرفان الوصف الصحيح للعلاقة القانونية التي تربطهما، وقد يتواطآن على وصف هذه العلاقة وصفاً خاطئاً، وذلك بهدف التحايل على القانون. ولكي يقوم القاضي بعملية التكييف القانوني للعقد فإنه يكون ملزماً بأمرين: الأمر الأول: تحديد مضمون العقد، أي الأثر القانوني المترتب عليه فعلاً والذي يمثل الهدف الحقيقي الذي اتجهت إليه النية المشتركة للطرفين، لذا فإن تحديد مضمون العقد يستلزم بالضرورة الكشف عن النية المشتركة. الأمر الثاني: إضفاء الوصف القانوني على العقد، وتبدأ هذه العملية بالمقارنة بين مضمون العقد والوصف الذي وصفه به الطرفان فإن وجدهما متلائمين أبقى الوصف كما هو، أما إذا وجدهما غير متلائمين ترك الوصف واستأنف عملية المقارنة بين مضمون العقد والأوصاف القانونية الأخرى المعروفة في القانون، فإن وجد فيها وصف يلائم هذا المضمون اختاره ليصف به العقد، وهذا يعني أن هذا العقد من العقود المسماة، وإذا لم يجد وصفاً قانونياً مناسباً لهذا العقد اعتبره من العقود غير المسماة. ويعد التكييف من مسائل القانون التي يخضع فيها القاضي لرقابة محكمة التمييز، بل أكثر من ذلك يعد ضرورة من ضرورات التطبيق السليم لقواعد القانون، لأن الخطأ فيه يؤدي إلى الخطأ في تطبيق القانون، كما أن التكييف الخاطئ هو في ذاته خطأ في تطبيق القانون. خامساً: خطة البحث سيقتصر بحثنا في هذا الكتاب على عقدين فقط من العقود المسماة هما: البيع باعتباره أهم نموذج على العقود الناقلة للملكية، والإيجار باعتبار أهم نموذج على العقود الوارد على منفعة الأشياء. ويعود السبب في الاقتصار على هذين العقدين إلى أن مساق العقود المساة الذي يدرّس في الجامعات الأردنية يقتصر عليهما فقط، وعليه نقسم هذا الكتاب إلى جزأين: الجزء الأول: عقد البيع. الجزء الثاني: عقد الإيجار.

العلامات التجارية وطنيا ودوليا
عدد الصفحات : 456 صفحة
يبين هذا الكتاب في هذا الفصل التطور التاريخي للعلامات التجارية في مرحلة العصور القديمة والعصور الوسطى ومرحلة العصر الحديث والتطور التشريعي لها على الصعيد الوطني والدولي والعربي والأردني معرجا على التعريف العلامة التجارية ووظائفها وأهميتها ثم يميز بين العلامة التجارية والحقوق الفكرية الأخرى وكيفية اختيار العلامة التجارية موضحا عناصرها المسموحة والممنوعة ويعدد الشروط الموضوعية والشكلية للعلامة التجارية والآثار المترتبة على تسجيلها ثم يشير الى تسجيل العلامة الأجنبية في الأردن وحمايتها وبيان أحكام العلامة التجارية المشهورة ويتناول الحق في العلامة التجارية مبينا مميزات الحق في العلامة التجارية وأسباب كسب الحق فيها وحالة التنازع على ملكيتها والتصرف بها وانقضاء الحق فيها وأما الحماية القانونية منفرد لها مساحة كبيرة إذ يركز على الحماية المدينة للعلامة التجارية والحماية الجزائية لها والإجراءات التحفظية والعقوبات التكميلية وفي الفصل الأخير يتناول تنظيم العلامات التجارية إذ يشير الى اتفاقية باريس الخاصة بحماية الملكية الصناعية لعام 1883 والاتفاقية الخاصة بالتسجيل الدولي للعلامات التجارية لعام 1891واتفاق نيس الخاص بالتصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض العلامات لعام 1957 واتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية 1994 حيث يوضح الاعتبارات التي أدت الى نشوئها ثم إقرار هذا الاتفاق وبيان مبادئ هذه الاتفاقية وتقييمها والعلامات التجارية فيها وأهم التعديلات التي جاءت بها .
