
القانون الإداري الكتاب الأول مبادئ القانون الإداري التنظيم الإداري الضبط الإداري المرفق العام
عدد الصفحات : 360 صفحة
تنقسم القواعد القانونية منذ العهد الروماني إلى قسمين رئيسين: قسم القانون الخاص الذي يشمل مجموعة التشريعات التي تحكم نشاط الأفراد وتنظم العلاقة بينهم ويضم: القانون المدني، القانون التجاري، قانون أصول المحاكمات المدنية، القانون الدولي الخاص، قانون العمل والقانون التجاري. وقسم القانون العام ويشمل مجموعة التشريعات التي تنظم السلطات العامة في الدولة وتحكم نشاطها وتنظم العلاقة التي تكون الإدارة طرفاً فيها باعتبارها سلطة عامة، ويضم قسم القانون العام فرعين: الأول هو القانون العام الخارجي وهو القانون الدولي العام الذي ينظم العلاقة فيما بين الدول وأشخاص القانون الدولي الأخرى في وقتي السلم والحرب، والفرع الثاني هو القانون العام الداخلي ويشمل القانون الدستوري، القانون الإداري، القانون المالي، والقانون الجنائي، رغم أنّ بعض الدول مثل فرنسا تعتبر القانون الجنائي فرعاً من فروع القانون الخاص؛ نظراً لأنّ تطبيق هذا القانون يتم عن طريق القضاء وليس عن طريق الإدارة. إنّ مبررات وجود القانون الإداري أي وجود قواعد قانونية خاصة بالإدارة تختلف عن قواعد القانون الخاص يرجع بالدرجة الأولى إلى الدور الذي تضطلع به الإدارة العامة في الدولة والمتمثل في تأدية الخدمات العامة للجمهور وضمان استمرار هذه الخدمات الأمر الذي يتطلب إعطاء هذه السلطات بعض الامتيازات بهدف ضمان ذلك وتحقيق الصالح العام، ومثل هذه الامتيازات لا تتوافر في قواعد القانون الخاص ومنها حق إصدار القرارات الإدارية بإرادة منفردة، وحق الاستيلاء ونزع الملكية للمنفعة العامة، حق التنفيذ المباشر، حق تعديل شروط العقد بإرادة منفردة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك والسلطة التقديرية. وقد ازدادت أهمية القانون الإداري واتسعت مجالاته نتيجة لتطور الحاجات العامة للمجتمع وتنوعها، مما تطلّب تدخل الدولة في مجالات عديدة بعد أن كان دور الدولة يقتصر على إدارة المرافق التقليدية (الأمن والدفاع والقضاء)، حتى امتد هذا النشاط ليشمل العديد من المرافق ذات الطابع الاجتماعي والثقافي والاقتصادي، مثل التعليم والصحة والنقل والمياه والكهرباء وغيرها. وتحتاج قواعد القانون الإداري إلى التعديل والتطوير بصورة دائمة ومستمرة حتى تساير التطورات المتلاحقة للمجتمعات المعاصرة، وهو ما يبرز أهمية القانون الإداري بين فروع القانون، وأصبح يُدرّس في كليات الحقوق من ضمن التخصصات الأخرى التي تُدرّس في هذه الكليات، وتشمل موضوعاته التنظيم الإداري للأجهزة الإدارية في الدولة بصورتيه المركزي واللامركزية، والنشاط الإداري الذي يتضمن دراسة مظاهر النشاط الإداري الذي يتمثل في الضبط الإداري والمرفق العام ووسائل النشاط الإداري المتمثل في القرارات الإدارية والعقود الإدارية وكذلك أساليبه التي تشمل عمال السلطة الإدارية والأموال العامة، كما يتضمن أيضاً دراسة الرقابة القضائية على أعمال السلطة الإدارية. وسوف نقتصر دراستنا في الكتاب الأول على ماهية القانون الإداري والتنظيم الإداري ومظاهر النشاط الإداري، أما وسائل النشاط الإداري وأساليبه فسوف نتناول دراستها في الكتاب الثاني.
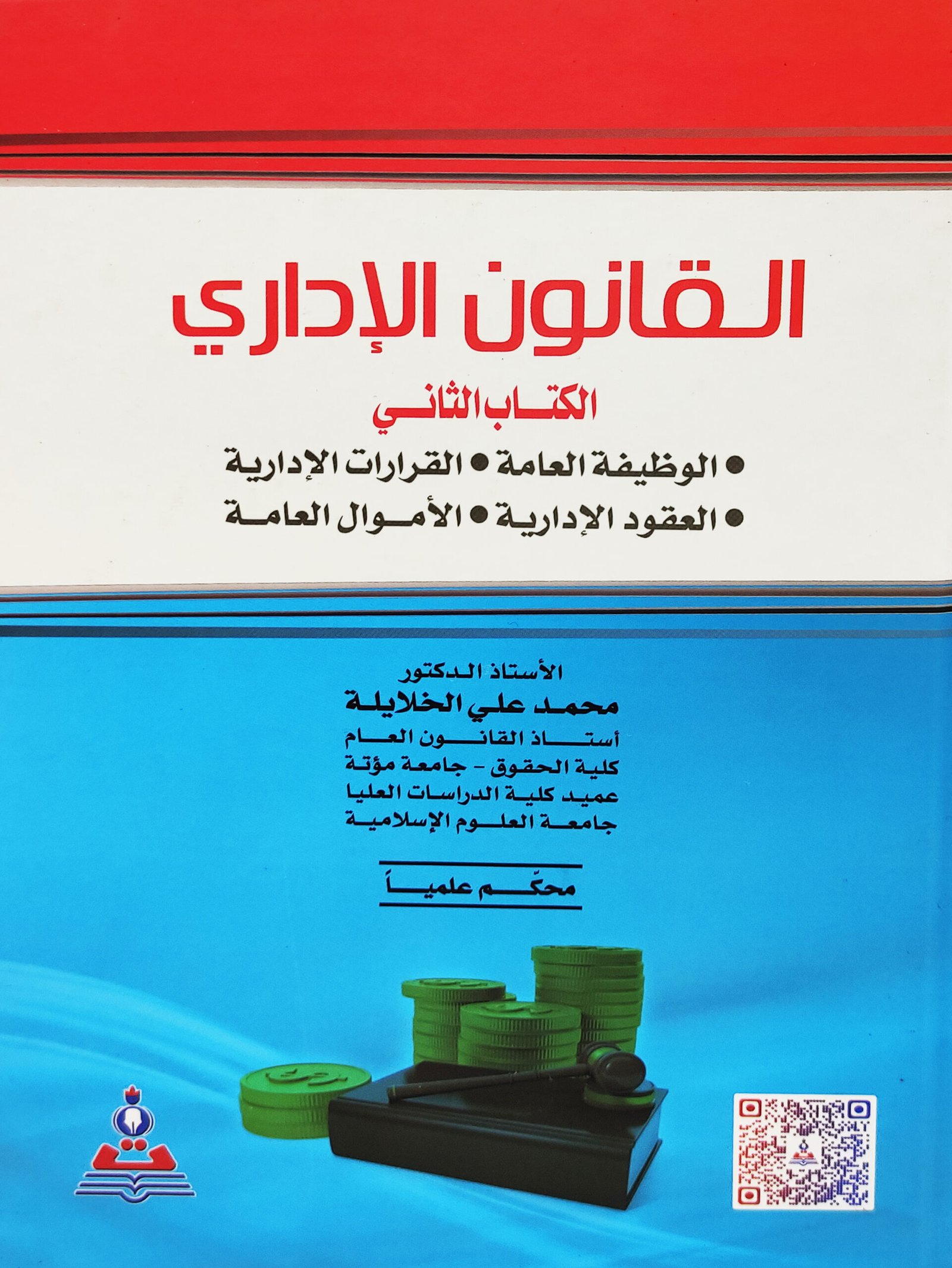
القانون الإداري الكتاب الثاني
عدد الصفحات : 368 صفحة
بعد أن وفقنا الله سبحانه وتعالى وقدمنا للقارئ الكريم الجزء الأول من مؤلف القانون الإداري (الكتاب الأول) والذي تناولنا فيه ثلاثة محاور أساسية وهي: ماهية القانون الإداري، التنظيم الإداري،مظاهر النشاط الإداري وهما الضبط الإداري وإدارة المرافق العامة، فإننا نحمده عز وجل أن يسر لنا تقديم الجزء الثاني (الكتاب الثاني) من مؤلف القانون الإداري والذي سنتناول فيه وسائل النشاط الإداري، وهي تلك الوسائل البشرية والقانونية والمادية التي تملكها الإدارة وهي تمارس نشاطها الضبطي والمرفقي. وعليه فقد قمنا بتقسيم موضوعات هذا المؤلف على أربعة فصول يتضمن كل منها مجموعة من المباحث والمطالب والفروع. فالفصل الأول يعالج موضوع الوظيفة العامة في إطار الحديث عن الوسيلة البشرية كإحدى وسائل النشاط الإداري، وفيه أشرنا أولاً إلى بعض الأساسيات في الوظيفة العامة، ثم تناولنا مواضيع التعيين في الوظيفة العامة، الأوضاع الوظيفية، تقييم أداء الموظف العام، حقوق وواجبات الموظف العام، تأديب الموظف العام وانتهاء خدمة الموظف العام. أما الفصلان الثاني والثالث فيعالجان موضوعي القرارات الإدارية والعقود الإدارية وهما الوسيلتان القانونيتان للنشاط الإداري، حيث تناولنا في الفصل الثاني التعريف بالقرار الإداري وخصائصه، أهمية القرارات الإدارية وتمييزها عن الأعمال القانونية الأخرى، أركان القرار الإداري، أنواع القرارات الإدارية، نفاذ وتنفيذ القرارات الإدارية وانتهاء القرارات الإدارية. وفي الفصل الثالث تناولنا موضوع العقود الإدارية، في حين تناولنا في الفصل الثالث ماهية العقد الإداري، أنواع العقود الإدارية، تكوين العقد الإداري، آثار العقد الإداري ونهاية العقد الإداري. وفي الفصل الرابع من هذا المؤلف تناولنا الوسيلة المادية لممارسة النشاط الإداري وهي الأموال العامة، وتحدثنا في هذا السياق في مفهوم المال العام وطبيعة حق الدولة عليه وفي كيفية استعمال الأموال العامة وفي الحماية القانونية للمال العام بشقيها الحماية المدنية والحماية الجزائية للأموال العامة.

القانون الإداري الكتاب الثاني الوظيفة العامة القرارات الإدارية العقود الإدارية والأموال العامة
عدد الصفحات : 408 صفحة

القانون التجاري الأعمال الشركات الأوراق
عدد الصفحات : 550 صفحة
لقد وقف هذا الكتاب على كثير من الموضوعات تناولت القانون التجاري بالدراسة والبحث فالناظر في هذا الكتاب يجد موضوعاته قد تنوعت مابين الاعمال التجارية والتجار والشركات التجارية والاوارق التجارية وعرضت بأسلوب مبسط ومركز يتسم بالوضوح وقد أثري هذا الكتاب بمقدمته طويلة تناولت تعريف القانون التجاري وموقعه من التقسيم العام للقانون ونطاق القانون التجاري والمعيار الشخصي او الذاتي والمعيار الموضوعي او المادي ثم شرع الكتاب بالحديث عن الاعمال التجارية والتجار والمتجر حيث تناولهم بالتعريف والتميز بين الاعمال التجارية والاعمال المدنية وضوابط التفرقة بينهما ومعيار العمل التجاري والعنوان التجاري كما وتحدث عن الشركات التجارية واهميتها واشكال الشركات التجارية والاركان الشكلية لها وعرج ايضا الى الاوراق التجارية وتناولها بالتعريف وذكر وظائفها والقواعد التي تحكم الاوراق التجارية في الاردن وكثير من الموضوعات التي تندرج في طيات هذه التقسيمات .

القانون التجاري الإفلاس العقود عمليات البنوك
عدد الصفحات : 440 صفحة
الإفلاس كمفرد لغوي هو تعبير عن حقيقة واقعية مفادها انتقال الشخص من حالة اليسر إلى حالة العسر. وقد استخدمه المشرع لينشأ به نظاماً للتنفيذ الجماعي على أموال المدين التاجر الذي يتوقف عن دفع ديونه التجارية في مواعيد استحقاقها. وقوام هذا النظام تصفية أموال المدين تصفية جماعية وتوزيع الثمن الناتج عن بيعها على دائنيه، وفقاً لمجموعة من القواعد والإجراءات تهدف في مجملها إلى تحقيق المساواة فيما بين هؤلاء الدائنين.
والأصل في الإفلاس هو توقف المدين التاجر عن دفه ديونه التجارية المستحقة الوفاء، وذلك لسبب خارج عن إرادته وتوقعاته كإفلاس مدينيه أو حدوث أزمة اقتصادية نتج عنها كساد عام في النشاط التجاري، أو تعرض المحل التجاري لسرقة أو حريق. ويطلق عادة على الإفلاس في هذه الصورة “الإفلاس البسيط”.
على أن التوقف عن الدفع قد يقترن سببه بأخطاء ارتكبها التاجر أو تقصير من جانبه كما لو أسرف في نفقاته الشخصية أو نفقات منزله، أو دفع بأموال باهظة في أعمال المضاربات غير المضمونة. ويطلق على الإفلاس في هذه الحالة “الإفلاس بالتقصير” وهو ما اعتبره المشرع الجنائي جنحة في قانون العقوبات معاقب عليها بالحبس من شهر إلى سنة.
وعلى عكس الإفلاس بالتقصير الذي يعتبر من الجرائم غير العمدية، قد تسوء نية التاجر فيتعمد الإضرار بدائنيه كما لو أخفى دفاتره التجارية أو أتلفها أو غير من بياناتها، أو اختلس جزءاً من أمواله، أو أخفاها أو بالغ فيما عليه من ديون. هنا يطلق على الإفلاس “الإفلاس بالتدليس”. ويعد هذا النوع من الجرائم العمدية التي تشكل في ذاتها جناية تخضع لعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة حتى سبع سنوات.
وجدير بالتأكيد أن التمييز بين الأنواع السابقة للإفلاس تكمن أهميته فقط في العقوبة التي توقع حال اقترانه بجريمة واختلاف هذه العقوبة بحسب ما إذا كان الإفلاس بالتقصير أو بالتدليس. علاوة على ذلك فإن ارتكاب التاجر لإحدى جرائم الإفلاس يحول بينه وبين الحصول على الصلح البسيط أو الصلح الواقي من الإفلاس. في المقابل مهما يكن نوع الإفلاس، أي سواء أكان بسيطاً أم مقترناً بالتقصير أو التدليس، فإنه يخضع لذات الإجراءات والقواعد الموضوعية المنصوص عليها في القانون التجاري.
مما سبق يتضح للقارئ أن نظام الإفلاس يحمل في جنباته قواعد تتسم بالقسوة الشديدة في معاملة المدين المتوقف عن الدفع. فالوقوع في هاوية الإفلاس يمثل الانهيار بعينه بالنسبة لهذا المدين، لذا فهو يسعى قدر ما أوتي من جهة إلى تفاديه. ولما كان المدين، هو أول شخص يشعر باضطراب أعماله ونذر الخطر المقدم عليه، فقد أجاز له القانون أن يتوقى ذلك بالتصالح مع الدائنين، فإذا لم يفلح المدين في اجتياز مرحلة الخطر، فإنه يتعرض لأشد جزاء يمكن أن يصيب الشخص في حياته التجارية وهو شهر إفلاسه.
وعليه فإن دراسة نظام الإفلاس في هذا الكتاب ستتخذ تسلسلاً زمنياً، وذلك على الوجه التالي: الباب الأول: تفادي شهر الإفلاس. الباب الثاني: شهر الإفلاس. الباب الثالث: آثار الإفلاس. الباب الرابع: إجراءات الإفلاس، الباب الخامس: انتهاء الإفلاس.

القانون التجاري السعودي الأعمال التجارية والتاجر الشركات التجارية الأوراق التجارية عمليات البنوك
عدد الصفحات : 440 صفحة
يشتمل القانون التجاري على القواعد الخاصة بنوع معين من الأعمال القانونية هي الأعمال التجارية، وبطائفة معينة من الأشخاص هي طائفة التجار. من هنا كان من الضروري تحديد دائرة هذا القانون أو نطاق تطبيقه، وفي إطار البحث عن القاعدة التي على أساسها يتم رسم حدود القانون التجاري، اختلفت التشريعات في الأخذ بإحدى نظريتين: النظرية الشخصية والنظرية الموضوعية.
فقد يرجح المشرع اعتبار القانون التجاري قانون التجار، وفي هذه الحالة فإنه يتخذ من النظرية أساساً للقانون التجاري، وهذه النظرية تتخذ من التاجر أساساً لتطبيق القانون التجاري، حيث يطبق القانون التجاري على كل من يحترف القيام بالأعمال التجارية ويتخذها مهنة معتادة له، وبالتالي لا يخضع للقانون التجاري الشخص الذي يقوم بمزاولة الأعمال التجارية دون أن يصل في ممارسته لها حد الإحتراف.
ولكن هذه النظرية، تعرضت للنقد على اساس أن الأخذ بها يتطلب ضرورة تحديد المهن التجارية التي اذا مارسها الشخص يعتبر تاجراً على سبيل الحصر، وهذا أمر بالغ الصعوبة نظراً لتطور الحياة التجارية، كذلك يؤدي الأخذ بهذه النظرية إلى حرمان الشخص الذي يمارس الأعمال التجارية دون أن يصل إلى حد الإحتراف من التمتع بالمزايا التي يقدمها القانون التجاري، بالإضافة إلى ذلك يؤدي الأخذ بهذه الظرية إلى تطبيق قواعد القانون التجاري على جميع أعمال التاجر سواء كانت تجارية أو مدنية.
ولكل ما تقدم من نقد للنظرية الشخصية، ظهرت النظرية الموضوعية كأساس لتحديد نطاق تطبيق القانون التجاري، والتي على اساسها يعتبر القانون التجاري هو قانون الأعمال التجارية، فوفقاً لهذه النظرية تخضع جميع الأعمال للقانون التجاري بغض النظر عن صفة الشخص القائم بهذه الأعمال سواء كان تاجراً أم غير تاجر.
ومع ذلك فقد تعرضت هذه النظرية للنقد على اساس أن تطبيقها يتطلب حصر للأعمال التجارية لتحديد نطاق تطبيق القانون التجاري وهذا أمر في غاية السعوبة نظراً للتطور المستمر في يالحياة التجارية. ورغم هذا الإنتقاد إلا أن هذه النظرية لاقت قبولاً كبيراً للإعتماد عليها كأساس لتحديد نطاق تطبيق القانون التجاري.
ولقد أخذ المشرّع السعودي بالنظرية الشخصية حيث نصّ في المادة الأولى من نظام المحكمة التجارية على أن التاجر هو كل من اشتغل بالمعاملات التجارية واتخذها مهنة له، كما أنه أخذ أيضاً بالنظرية الموضوعية حيث نص في المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية على اعتبار شراء المنقول بقصد بيعه والسمسرة وأعمال الصرافة وأعمال التجارة البحرية أعمال تجارية بغض النظر عن صفة القائم بها سواء تاجراً أم غير تاجر.
وبالتالي قام الدكتور أنور منصور بتقسيم الدراسة إلى بابين: تناول في الباب الأول الأعمال التجارية، وفي الباب الثاني تناول التاجر والتزاماته المهنية.
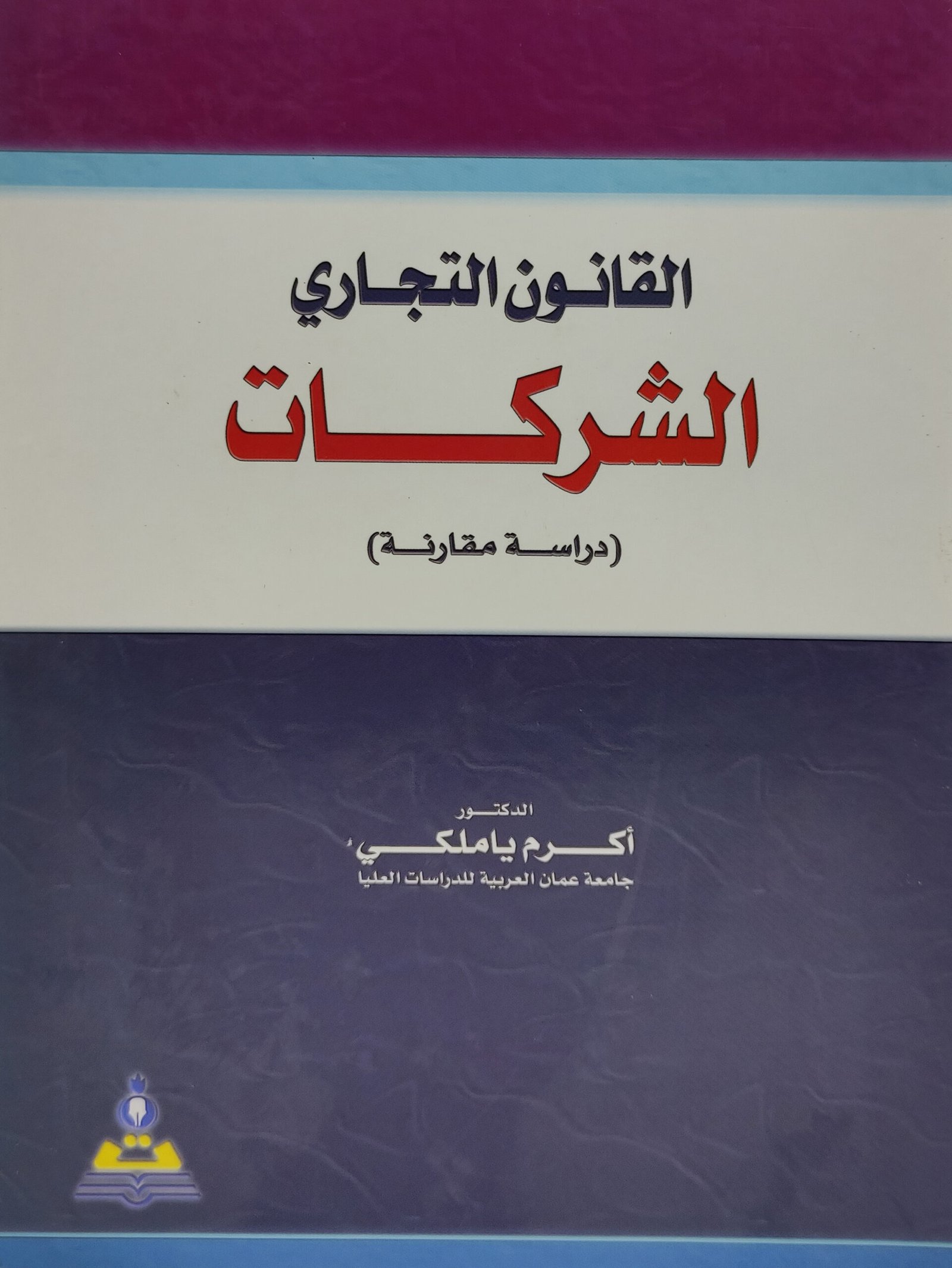
القانون التجاري الشركات دراسة مقارنة
عدد الصفحات : 512 صفحة
اولا- اصول الشركة: 1-الشركة كلمة مشتقة من افعال اشترك وشارك وتشارك،وتتضمن بالضرورة تعدد الأشخاص،وقد عرفتها المادة(1045)من مجلة الأحكام العدلية الصادرة في منتصف القرن التاسع عشر في عهد الدولة العثمانية خلال حكم السلطان عبد المجيد خان، تحت عنوان(الكتاب العاشر/الشركات/الاصطلاحات الفقهية)،بقولها أن(( الشركة في الأصل هي إختصاص ما فوق الواحد من الناس بشيء وامتيازهم بذلك الشيء. ولكن تستعمل أيضا عرفا واصطلاحا في معنى عقد الشركة الذي هو السبب لهذا الاختصاص، فلذلك تقسم الشركة بصورة مطلقة الى قسمين: أحداهما شركة الملك، وتحصل بسبب من أسباب التملك كالاشتراء والاتهاب، والثاني:شركة العقد، المخصوص،ويوجد سوى هذين القسمين شركة الإباحة وهي كون العامة مشتركين في صلاحية التملك بالأخذ والاحراز للأشياء المباحة التي ليست في الأصل ملكا لأحد كالماء)). والذي يعنينا من هذا التعريف الفقهي العام، والذي هو أقرب الى الشرح من التعريف، هو مصطلح الشركة الدال على عقد الشركة، المقصود به اتفاق شخصين او اكثر على توحيد مساعيهم او اموالهم من اجل الحصول على ربح وعلى ((الكيان)) الذيقد يتمخض عنه هذا العقد، كما سيأتي تفصيله فيما بعد. وعقدالشركة هو من أهم ظواهر الحياة الاجتماعية بلا منازع ومن أقدم العقود في التاريخ ، حيث يتداخل ظهوره مع ظهور المجتمعات البشرية الأولى في اقدم العصور. وقد بدت هذه اظاهرة لأول مرة في بلاد الرافدين، مهد أقدم حضارة في العالم ، إذ خبرت الشعوب القاطنة بين نهري دجلة والفرات والسهول المحيطة بهما هذا الوجه من اوجه النشاط الاقتصادي المتطور منذ ان بدأ الناس بالسعي الى كسب المال والارتزاق عن طريق البيع والشراء وتداول البضائع والارتحال بها من اقاصي الأرض الى أقاصيها. ومما يدل على دور الشركة في العراق القديم تخصيص شريعة حمورابي، وهي أهم وثيقة قانونية تاريخية عثر عليها حتى الآن، ثماني مواد (المواد 100-107)لها من مجموع44 مادة المخصصة فيها للعقود من مجموع 282 مادة التي تتكون منها الشريعة. وقد استمرت هذه الظاهرة في النمو والتطور والانتشار خلال الربعة آلاف سنة الخيرة،وبخاصة تحت ظل القانونين الاغريقي والروماني اللذين امكن التعرف فيها على ما يسمى باللاتينية ” Corpus جسم” او بالأحرى (كيان) خاص بالشركة، بحيث انها أضحت تبدو وكأنها تشكل وحدة قانونية،او في القل نواة لهذه الوحدة، مستقلة عن أشخاص الشركاء المكونين لها، التي يمكن ان تعد بمثابة الجنين الذي تمخضت عنه فيما بعد شركات الأموال التي كانت وما زالت الأداة الفعالة في تطوير الاقتصاد العالمي. فمع نشوءحركة التصنيع في أوروبا وازدهار التجارة مع البلاد ما وراء البحار، ظهرت الشركة بالأسهم لتسهل استثمار الثورات الكبيرة في أرجاء العالم المكتشفة حديثا في قارتي أمريكا وافريقيا واوقيانوسيا. ومع ان في البداية لم تكن تستطيع اتخاذ شكل شركة بالأسهم غير الشركات الكبيرة المتمتعة بالرعاية الملكية،أي الدولة، فإن الشركة المساهمة، تحت ضغط الطبقة الرأسمالة المتنامية، سرعان مافتحت أبوابها للجميع، وخصوصا بعد احلال نظام الحرية النسبية او الحرية المنظمة محل نظام الإجازة او الرخصة او الامتياز الذي لم يعد معمولا به إفي بعض الدول، وما هذا التطور إلا الدليل الواضح على أهمية الشركة. ثانيا- أهمية الشركة: 2- يكمن سر نشوء الشركة وتطورها واكتسابها أهميتها الحالية في الحاجة الماسة والملحة أحيانا إليها، لأن من النشاطات والمشاريع ما لا طاقة للشخص الواحد للنهوض بها او تحمل أعبائها، فلا بد إذن من تظافر عدة أشخاص وتعاونهم لانجاحها. وهذا التعاون يتم إما: (أ)بصورة عمودية Vertical،أي بوجود رئيس يعاونه مرؤوسون، أي رب عمل تحت أمرته مستخدمون تابعون له، كما هو الحال بالنسبة لمعظم التجار ورجال الأعمال،وبالأخص الكبار منهم،او (ب)بصورة أفقية Horizontal،أي باجتماع عدة أشخاص وتعاونهم على قدم المساواة لتوزيع مخاطر النشاط او المشروع بينهم. وأبرز مثال على هذا النوع من تعاون هو الشركة. 3- وتتأنى الحاجة الى التعاون عموما من: (أ)أن الأفراد لا يتمتعون جميعا بنفس القابليات الذهنية او الفنية او العملية، فالتعاون هو الوسيلة الوحيدة لضم الكفاءات المختلفة التي لا بد منها لمزاولة نشاط ما ونجاح مشروع معين. (ب)أن الأفراد، ومنهم عدد غير قليل من ذوي الكفاءة والمقدرة،لا يملكون جميعا الوسائل المادية اللازمة لإخراج مشاريعهم الى حيز الوجود، في حين أن من يملك هذه الوسائل فد يفتقر الى بعض الامكانات والقابليات التي يتمتع بها هؤلاء، وهنا تبرز أهمية التعاون بين أصحاب الكفاءات وأصحاب رؤوس الأموال، أي التعاون بين العمل والمال. (ج)أن الفرد الواحد يعجز في الغالب هن مواجهة الحاجات المالية للمشاريع الكبيرة، فلا بد لذلك من ضم رؤوس الأموال بعضها الى بعض لتوفير المال اللازم للنهوض بهذه المشاريع. ثالثا-التشريعات الخاصة بالشركات: 4- عُني معظم المشرعين في العالم، وخصوصا منذ أوائل القرن التاسع عشر، بتنظيم الشركات بصورة عامة والشركات التجارية بصورة خاصة، وفي هذه التشريعات التقنين المدني الفرنسي(تقنين نابليون)لسنة 1804 الذي نظم أحكام الشركة بوجه عام وتأثرت معظم التقنيات الصادرة بعده به مباشرة، ومنها القوانين المدينة العربية، وفي مقدمتها القانونان المدني ((المختلط)) والمدني الأهلي (الوطني) الصادران في مصر في سنة1875 وسنة1883 اللذان حل محلهما بعد ذلك القانون المدني ((الجديد)) لسنة1948، والقانون المدني السوري لسنة1949، والقانون المدني العراقي لسنة1951، والقانون المدني الأردني لسنة1976، وكذلك قانون الموجبات والعقود اللبناني لسنة 1934، الى جانب القوانين الخاصة بالشركات ، وخصوصا الشركات التجارية، ومن أهمها التقنين التجاري الفرنسي لسنة1807 وقانون الشركات بالأسهم الفرنسي لسنة1867 وحاليا قانون سنة1966، وكذلك قانون الشركات الإنجليزي لسنة1908 وحاليا قانون سنة1985 التي تاثرت بها، بدرجات متفاوتة، مختلف القوانين التجارية وقوانين الشركات في العالم، ومنها قانون التجارة العثمانية لسنة1850 وقانونا التجارة المصريان ((المختلط)) والأهلي(الوطني) الصادران في سنة1875 وسنة1883 وقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة المصري لسنة 1981 وقانون التجارة الجديدة لسنة1999، وكذلك قانون التجارة اللبناني لسنة1942، وقانون التجارة السوري لسنة1949، وقانون الشركات التجارية العراقي لسنة1957 ومن بعده قانونا الشركات لسنة1983 وسنة1997 اللذان نظما ما سمياهما شركة ((المشروع الفردي)) والشركة البسيطة، وقانون الشركات الأردني لسنة1964 ومن بعده القانون((المؤقت)) لسنة1989 فالقانون الجديد لسنة 1997 المعدل بعدة قوانين في سنة2002، وخصوصا بالقانون المؤقت رقم (4) الذي أضاف إليه الباب الخامس مكرر في ما اسماه ((الشركات المساهمة الخاصة)). وحيث أن الشركات المنظمة أحكامها في هذه القوانين وان كانت تخضع أساسا لمجموعة من قواعد العامة شاملة لمختلف أنواعها فإنها يمكن تقسيمها تقسيمات عدة لاعتبارات معينة، وخصوصا من حيث غلبة الاعتبار المالي على الاعتبارالشخصي فيها او العكس، والتي لذلك يمكن تقسيمها الى ما يسمى شركات الأشخاص وشركات الأموال، وعلى هذا الأساس نوزع دراستنا الى ثلاثة أبواب:الأول في الشركة بوجه عام، الذي نبسط فيه الأحكام العامة للشركة، لنتبعه في البابين الثاني والثالث ببيان أحكام كل من شركات الأشخاص وشركات الأموال على التوالي.

